أتى دستور 1962، مثلما ذكرنا من قبل، نتيجة لتوافقات وطنية أملتها موازين القوى الداخلية والخارجية في تلك المرحلة، فوضع إطاراً عاماً يؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية لكنه لم يُطوّر كما تنص مواده، إذ أدى تغير موازين القوى الاجتماعية-الاقتصادية، وبالتالي، السياسية إلى التراجع عن مضمونه وقواعده العامة، وهو الأمر الذي لم ينتج عنه عدم وضع سياسات وقوانين عامة تُنظّم العمل السياسي فقط، بل تم أيضاً إقرار آليات وأنظمة وإجراءات وقوانين، مثل النظام الانتخابي الحالي غير العادل، أدت إلى تقليص قاعدة المشاركة السياسية في صنع السياسات واتخاذ القرارات العامة، وفتحت المجال واسعاً أمام من لا يعترف بالقِيم الديمقراطية كي يصل إلى سلطة القرار والتشريع، وهو ما مكّنهم من إقرار تشريعات تُقيد الحريات وتساهم في عملية التراجع الديمقراطي.
لنأخذ مثلاً عملية تنظيم العمل السياسي وإشهاره التي تعتبر خطوة أولية لازمة لأي إصلاح سياسي-ديمقراطي حقيقي، ثم نتساءل: لماذا ترفض السُلطة السياسية ومعها تيارات الإسلام السياسي بشقيها السنّي والشيعي عملية تنظيم العمل السياسي وإشهاره على الرغم من أنه لا ديمقراطية من دون أحزاب سياسية مُنظمة تطرح برامج وطنية عامة؟! الجواب ببساطة هو أن تنظيم العمل السياسي على أسس مدنية ديمقراطية وبرامج عامة ليس في مصلحتهم، لأنه يعني مشاركة شعبية وطنية فاعلة في صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات، علاوة على أنه يعني حظر التنظيمات والجماعات التي تقوم على أساس عرقي أو ديني أو طائفي، ففي الدولة المدنية الديمقراطية لا يُسمح بممارسة العمل السياسي إلا للتنظيمات السياسية المدنية التي تتوافق برامجها مع روح العصر ومصالح الوطن والمواطنين عامة.
على هذا الأساس تأتي أولوية المطالبة الشعبية بتنظيم العمل السياسي وإصلاح النظام الانتخابي وإطلاق الحريات العامة، إذ إنه لا يمكن، مثلما ذكرنا من قبل، الحديث جدياً عن نظام حكم ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً كما ينص الدستور، وعن تماسك اجتماعي-سياسي داخلي باستطاعته مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وذلك في ظل احتكار السلطة والثروة والفوضى السياسية واختلال موازين القوى وتقييد الحريات، فضلاً عن وجود نظام انتخابي غير عادل ومشوّه لا ينتج عنه تمثيل حقيقي للإرداة الشعبية مهما ارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة، كما يساعد في سرعة تفتيت النسيج الاجتماعي الوطني والعودة، مثلما رأينا في الأسابيع القليلة الماضية، إلى هويات فرعية وفزعات قبلية وطائفية وعائلية وعنصرية كانت سائدة في مرحلة تاريخية ماضية سبقت نشوء الدولة الوطنية الحديثة.
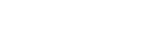




















أضف تعليق