لم يكن دين الله في يوم من الأيام حاجزاً دون الرقي وعائقاً عن التقدّم…ومن ينظر في تاريخ الإسلام يعلم بأن تقدّم المسلمين مرتبطٌ بتمسكهم بدينهم…فعندما تمسّك المسلمون بدينهم سادوا العالم وأنقذوا الأمم الأخرى من الجهل والضياع…ولمّا نبذ المسلمون كتاب ربهم ورائهم ظهريّا ورضوا بأن يكونوا أذناباً للغرب ضرب الله عليهم الذل والهوان حتى يرجعوا إلى دينهم…؟!!
فتأخر المسلمين في الحقيقة سببه ترك دينهم لا تمسّكهم بدينهم كما يصور بعض الجهلة ممّن خُدعوا بشعارات الليبرالية البرّاقة ولم يطلعوا على مضامينها المهلكة…فأخذوا مع الأسف يعاملون الدين الإسلامي كما عامل الغرب النصرانية المحرّفة التي كانت سبباً رئيسيًّا في تأخر الغرب ولم يتقدّم الغرب إلا بعد تنحيتها عن الحياة لأنها كانت تصادم الحقائق العلمية مصادمة جليّة جعلت الغرب يجزم بأن هذا الدين لا يلبّي طموحات الأمم…ولكن أين هذه العلة في دين الإسلام…؟!
فدين الإسلام بدأ بالحث على العلم وانتهى بالحث على العلم وهو فيما بين ذلك يحث على العلم…!!!
ولا يخشى على الإنسان الطموح المتعطش للعلم من دين الإسلام…بل إن الإنسان كما قال أحمد محمد الغمراوي:(يستطيع أن يراعي الدقة العلمية التامة في البحث وهو متذكر دينه كل التذكر ومعتقد صحته كل الاعتقاد. غير مجوز على قرآنه خطأ.
بل إن التدين الصحيح يزيد الباحث المخلص إن أمكن حرصًا على الحق واستمساكا به إذا وصل إليه. إن الباحث المتدين بين محبين في الحق: دينه وعلمه, ومبغضين في الباطل: دينه وعلمه، وكذلك فهو يحب الحق مرتين: مرة لدينه ومرة لعلمه, ويبغض الباطل مرتين كذلك, ولا خوف عليه مطلقا أن يخفي بعض الحق أو يدلس في البحث محاباة لدينه، إذ ليس الحق يخاف على دينه ولكنه الباطل، وهو يعلم أن دينه حق. يعلم ذلك علم مستيقن. ويعلم أن العلم قائم على قاعدة استحالة التنافي بين أجزاء الحق، فهو لا يخشى أبدًا أن يكشف البحث الصحيح عن حقيقة تنافي دينه ولذلك يمضي في أبحاثه آمنًا مطمئنا متبعا أقوام الطرق في البحث والتفكير.
فالتدين الصحيح والعلم الصحيح ممكن اجتماعهم إذن وكثيرًا ما اجتمعنا, كما أن العاطفة العلمية القوية والعاطفة الدينية القوية لا تتعارضان بل تتضافران في خدمة العلم)…
والدين الإسلامي غطّى جميع نواحي الحياة ولم يكتفِ بالحث على العلوم المادية التي جعلت من عايشوها دون تهذيب نفوسهم منزوعي الأحساسيس…بل إن الدين الإسلامي يمتاز عن غيره بتعزيزه لسلطة الرقيب الذاتي.
فإذا كان الغربي يحترم القانون حفاظاً على سلامته ولينظّم شئون حياته…فالمسلم يحترم القانون ديانة وقربة لله جل وعلا…؟!
ورحم الله الرافعي الذي تكلّم عن فائدة التديّن للمجتمعات وأجاد عندما قال:
(والدين هو حقيقة الخلق الاجتماعي في الأمة، وهو الذي يجعل القلوب كلها طبقة واحدة على اختلاف المظاهر الاجتماعية عالية ونازلة وما بينهما، فهو بذلك الضمير القانوني للشعب، وبه لا بغيره ثبات الأمة على فضائلها النفسية، وفيه لا في سواه معنى إنسانية القلب.
ولهذا كان الدين من أقوى الوسائل التي يعول عليها في إيقاظ ضمير الأمة، وتنبيه روحها، واهتياج خيالها؛ إذ فيه أعظم السلطة التي لها وحدها لها قوة الغلبة على الماديات؛ فسلطان الدين هو سلطان كل فرد على ذاته وطبيعته؛ ومتى قوي هذا السلطان في شعب كان حميًّا أبيًّا، لا ترغمه قوة، ولا يعنو للقهر.
ولولا التدين بالشريعة؛ لما استقامت الطاعة للقانون في النفس؛ ولولا الطاعة النفسية للقوانين؛ لما انتظمت أمة؛ فليس عمل الدين إلا تحديد مكان الحي في فضائل الحياة؛ وتعيين تبعته في حقوقها وواجباتها، وجعل ذلك كله نظامًا مستقرًا فيه لا يتغير، ودفع الإنسان بهذا النظام نحو الأكمل، ودائمًا نحو الأكمل.
وكل أمة ضعُف الدين فيها اختلت هندستها الاجتماعية وماج بعضها في بعض؛ فإن من دقيق الحكمة في هذا الدين أنه لم يجعل الغاية الأخيرة من الحياة غاية في هذه الأرض؛ وذلك لتنتظم الغايات الأرضية في الناس فلا يأكل بعضهم بعضا فيغتني الغني وهو آمن، ويفتقر الفقير وهو قانع، ويكون ثواب الأعلى في أن يعود على الأسفل بالمبرة، وثواب الأسفل في أن يصبر على ترك الأعلى في منزلته؛ ثم ينصرف الجميع بفضائلهم إلى تحقيق الغاية الإلهية الواحدة، التي لا يكبر عليها الكبير، ولا يصغر عنها الصغير؛ وهي الحق، والصلاح، والخير، والتعاون على البر والتقوى.
وما دام عمل الدين هو تكوين الخلق الثابت الدائب في عمله، المعتز بقوته، المطمئن إلى صبره، النافر من الضعف، الأبي على الذل، الكافر بالاستعباد، ومفاداته، العامل في مصلحة الجماعة، المقيد في منافعه بواجباته نحو الناس؛ ما دام عمل الدين هو تكوين هذا الخلق فيكون الدين في حقيقته هو جعل الحس بالشريعة أقوى من الحس بالمادة؛ ولعمري ما يجد الاستقلال قوة هي أقوى له وأرد عليه من هذا المعنى إذا تقرر في نفوس الأمة وانطبعت عليه)…؟!!
ويقول عبدالقادر عوده:
(وتمتاز الشريعة الإسلامية عن القانون الوضعي، بأنها مزجب بين الدين والدنيا، وشرعت للدنيا والآخرة وهذا هو السبب الوحيد الذي يحمل المسلمين على طاعتها في السر والعلن، والسراء والضراء لأنهم لا يؤمنون – طبقا لأحكام الشريعة – بأن الطاعة نوع من العبادة يقربهم إلى الله، وأنهم يثابون على هذه الطاعة، ومن استطاع منهم أن يرتكب جريمة، ويتفادى العقاب فإنه لا يرتكبها مخافة العقاب الأخروي، وغضب الله عليه، وكل ذلك مما يدعو إلى قلة الجرائم وحفظ الأمن، وصيانة نظام الجماعة بعكس الحال في القوانين الوضعية فإنها ليس لها في نفوس من تطبق عليهم ما يحملهم على طاعتها، وهم لا يطيعونها إلا بقدر ما يخشون من الوقوع تحت طائلتها، ومن استطاع أن يرتكب جريمة ما – وهو آمن من سطوة القانون – فليس ثمة ما يمنعه من ارتكابها من خلق أودين ولذلك تزداد الجرائم زيادة مطردة في البلاد التي تطبق القوانين، وتضعف الأخلاق، ويكثر المجرمون في الطبقات المستنيرة تبعا لزيادة الفساد الخلقي في هذه الطبقات، ولمقدرة أفرادها على التهرب من سلطان القانون).
وأهمية الدين لتبين علاقة المخلوق بالخالق وتنظيم شئون الحياة وتهذيب السلوك وتقويم الأخلاق أوضح من أن يدلل عليها…فلولا الدين لما عرف الإنسان مهما بلغ من التقدّم الحضاري طرق مرضاة الله ليسلكها وطرق غضبه ليجتنبها…ولولا الدين لما انتظم معاش الناس لصعوبة تطابق العقول واتفاقها…ولولا الدين لما عرفنا مكارم الأخلاق حق المعرفة…لأن العقول بأحكامها على حسن الخلق وعدم حسنه تنطلق من تكوينها الذي يتشكل من الظروف الاجتماعية والبيئية التي نشأت بها… واختلاف الظروف من مجتمع لمجتمع يحيل اتفاق العقول على شيء من ذلك فما كان حسناً في مجتمع كان قبيحاً في آخر وما مكان قبيحاً في بيئة كان حسناً في بيئة أخرى…!
أمّا الدين فيوحد الرؤى والغايات ويضع الحدود الواضحة التي تفصل محاسن الأخلاق عن مساوئها…فلو نظرنا إلى الدين وحثه على الصبر والحلم عن الخلق لوجدناه بلغ الذروة التي لا يرام بعدها شيء…فقد أمر الله بالصبر على المسيء ودفعه بالتي هي أحسن حتى يعود وليًّا حميماً…وأمر جل وعلا بالأخذ بما عفى من أخلاق الناس وعدم تكليف الناس غيرها وحثهم على الخير والإعراض عن جاهلهم…وهذه الأخلاق لا يمكن للعقول البشرية مهما ترقت وتقدّمت بالمعارف والحضارة أن تدركها…لأن هذه الأخلاق مرتبطة بعقيدة دينية تساعد من آمن بها على التحلي بأخلاقها…ولأن المؤمن بها يجد ما يسليه ويصبره على أذى الخلق من موعود الله في الدار الآخرة…ولو تحاكمنا لطبيعة النفوس البشرية بعيداً عن الدين لوجدناها تتشوف للإنتقام السريع وعدم الصبر على أذى الخلق…لأن النفوس بطبعها تحب الملموس الحاضر وتقدمه على غيره…وتفضل الموجود على الموعود حتى لو كان الموعود أفضل…!
ومن هنا يستحيل تنظيم سلوك الفرد وتهذيب أخلاقه بعيداً عن الدين…وحتى لو تأتّى شيئا من ذلك مما تطابقت الفطر السليمة على حسنه كإكرام الضيف والشجاعة سيكون مشوباً بما يكدّره كإدخال التبذير على الكرم والتهور على الشجاعة…لأن العقل لا ينفرد بوضع الحدود الواضحة لهذه الأخلاق الحسنة…!!
فالحاصل أن الدين هو المصدر الوحيد لوزن معالي الأخلاق وتمييزها عن سفاسفها…ومن أراد غير ذلك ودعا لتهذيب السلوك بعيداً عن الدين كما يفعل بعض التربويين الذين أُشبعوا بالثقافة الغربية فقد أطلق صرخة في الفضاء ورام الكتابة على الماء…!!
تويتر:a_do5y
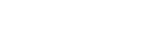


















أضف تعليق