قد كان حليقاً!
خلود عبدالله الخميس
قبل عام، وفي عصر رائق وقبل أن تبدأ الشمس في انغماسها اليومي في البحر، وعلى ضفاف البوسفور الشامخ وكأنه جبل امتد صدره أفقياً حتى احتضن الكرة الأرضية من أقصاها لأخمصها، في منطقة بيبك الاسطنبولية، جلست أسترجع بعض القصص التي أثرت في حياتي لأستعيد انتشاء أستحقه في عناء الحياة الذي لا ينقطع ولا يكل، وأدونها في كتاب ذكرياتي السعيدة.
في آخر العقد الثاني، بينه وبين عمر الحكمة أكثر من عشر أعوام، وبدا أنه أحد الاستثناءات التي أرسلها الله في الأرض ليذكرنا بأن القاعدة الحقيقية أصبحت اليوم استثناءً، وأن كلنا نمتلك سبق الفهم وأصل الفكرة، ولكننا نركن للقعود فلا يتحقق فينا «ذلك الاستثناء».
كان «نور الدين» سابقا لكثيرين عقلاً، قلباً، روحاً وجسداً، ناضجا في أركانه الأربعة، متزنا في جوانب عدة، ويبقى النقص البشري داء ودواء، لا ينجو منه أحد، ولديه بعضه بالتأكيد، فقط بلا تأثير حقيقي، لذا كان يبدو كاملاً.
«نور الدين» أعجمي اللسان ناطق بالعربية، اجتمعنا لبرنامج دراسي في ولاية «ناشفيل» الأميركية، الشهيرة بالموسيقى الريفية أو ما يسمى (كونتري ميوزيك)، وكنت في نفس عمره تقريباً.
موضوع البرنامج في تلك الولاية «وسائل الترويج الدعائي للفنون»، لا تعجبوا، نعم، لقد جبنا الأرض نظن أننا نحسن صنعاً، ولكننا لسنا إلا متسكعين لا أكثر، الفرق بيننا وبين الـ «homeless» سكننا الفنادق الراقية وأكلنا الطعام النظيف، والاستحمام، بينما هم يفترشون الطرقات الجانبية ويأكلون الفضلات من حاويات القمامة وتنشب بهم القاذورات، هؤلاء ونحن، عقولنا تتشابه بخوائها ما دامت بعيدة عن الحكمة!
كنا متشابهين في الأطباع والهوايات إلى حد كبير، أحب العزلة والهدوء والقراءة والاستكشاف والجدول المفتوح أو ما أحب أن أسمية «جدول بلا مواعيد»، وهو كذلك، حتى إننا كنا ننتظر يوم الراحة لممارسة تلك المتشابهات.
في ليلة ذهب بقية الطلبة ليتعلموا «الرقص الريفي» فقررت أن أعتبره يوماً أهدي لي من القدر لأمارس هوايتي (اللاجدول) فخرجت من الفندق بلا وجهة محددة، وانتهى بي الطريق لمقهى صغير وحميم في طرف الشارع المؤدي لمحطة الحافلات.
أعلم أن هذه الأماكن لا تضمم إلا أمثالي، محبي الخلوات، وهم قلة في زمن الاختلاط بكل شيء غريب وجديد!
أرغب بسوائل دافئة ما أمكن لأطفئ برودة يناير وأذيب ثلجه، ولأنني أبغض القهوة الأميركية فلا ود بيننا أبداً، طلبت «هوتشوكليت» من السيدة الخمسينية ناطقة اليدين، يداها تتحرك بفن لافت توجه النوادل، وكأنها مايسترو فرقة لا أحد يشذ عن نوتتها.
واتجهت للزاوية اليمنى، وإذا «نور الدين» يحتلها، فبادر بالوقوف ودعوتي للجلوس معه، وأنا أحب الزاوية اليمنى في أي مكان، كم لدينا من عادات انقلبت مسلمات مع التكرار والإصرار، جلست فبدأني الحوار: ظننك ذهبت معهم. قلت: لدرس الرقص؟! هل أبدو منهم؟
عرفت من الحديث أنه ظن أنني سأشارك في تعلم الرقص لأنه لم يفهم بعد «خلطتي» بحد وصفه.
أعلم أن حجابي محير لكثيرين؛ لأنني رغم خليجيتي والنشأة في الصحراء، أنا منفتحة في الحديث مع الجميع، أتعامل مع البشر بصفة «إنسان» ولا أعبر اهتماماً بالنوع والدين والثقافة والعمر، ما دام الحديث في نطاق المسموح والمتاح في لائحتي الشخصية وقواميسي القيمية راضية.
كان حديثاً لا ينسى، «نور الدين» متزوج من فتاة تركها في بلده، يحمل صورتها عند قلبه في محفظة بين بطاقات الائتمان، يتكلم عنها كأثمن أشيائه، وكأن العالم يختصره وجودها. فقدت «خيرية» إحدى عينيها في الحرب، وتفاصيل تطول عن الضرر الذي ألحق بعائلتها وبكل من لم يخرج من أرض حرب وفضل الجهاد ولو بتكثير سواد مسلميها.
«خيرية» لم تكن زوجته، كانت صديقته التي يلعب معها في زقاق الحارة، ولم تبلغ سنواتها العشر، وهو يكبرها قليلاً، عيناها بلون سماء قبل انبلاج نور الصباح، أخذ المجرم الأميركي إحداها أثناء اغتصابها، وهي تقاومه فلكمها فنزفت العين اليسرى وفقدتها.
يتكلم وأنا أكلم نفسي: ما هذا الرجل في زمن عز فيه الرجال؟! يتزوجها وهي عوراء فاقدة لعذريتها ولماذا؟ لأنه وعدها عندما كانا طفلين بألا يفارقها أبداً، وما تؤكده عيناه أنه فعل ليس إيفاءً بعهده فحسب، بل لأنه يبصر من خلالها، كان صمت تلك العينان وهو يستذكر لحظاتهما، بحلوها ومرها، هي الرباط الغليظ الذي جمعهما.
طفل أو مراهق، قال كلاماً وهو يلعب مع فتاة ليثير إعجابها، هكذا يرى رجال مجتمعاتنا الأمر، بينما رجال الحروب هم بقايا خيرية الأمة الذين تتحقق بهم النبوءة.
كان البرنامج أسبوعين فقط، لم أستفد منه إلا ما تعلمته من «نور الدين»، وقصاصة ورقة تقول: إنني مجازة بالترويج الدعائي!
بقي أن أقول: إن «نور الدين» رجل من قندهار وكان حليقاً، ولكن خير من ألف ملتح.
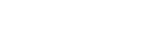



















أضف تعليق