مطر – يا “محمد مساهج” – يبللني اسـى وغبـون
وارتّل ما تيسّر بي مـن الصبـر، ومعـي ينمـا..
قلق يستشري بـدمي وينبـت فالعـروق غصـون
ويورق حزني الأخضر بعينـي وارتمـي اعمـى !
اقلّب من ورى عيونـي مسـاء الجهـرا المركـون
ورى جدار السهر والقا: حنيـن وذكريـات اسمـا:
رحل ذاك! انكسر هذا! وهـذا بالاسـى مسجـون
واناظر ملعب الكورة: حزين.. وصامت المرمـى!
وعلى ذاك الجدار.. المح: “هنا كنّا” وفينا جنـون
.. هنا كنّا!.. وكل ما اذكر: “هنا كنّا” كثير اضما!
تعبت.. من ال”هنا كنّا” ابعرف بس: متى بنكـون؟
تعبت.. وهـالضما هذا.. قطع حتى يديـن المـا!
وش الباقي: مادام ابسط طموح بهالـ”متى؟ “مرهون
مادام ” اخر فرح ” مَـر.. وبِكفّيـن الـوداع اومـى
دخيل الله..عشرينـي مثـل “عشرينـك” المطعـون
تعلّق في أمـل ضـيٍ… معلّـق فـي مـدى ظلمـا
لذا بأشرب ثلاث آلآم، ولا تسأل: شربت شلـون؟!
يا إمّا أحطب اوجاعي.. او اهدي فاسي لـسلمى!!
(القراءة)
ارتبطت الأماكن بوجدان الشعراء، منذ أن عرف الإنسان الكتابة، وتمازجت هذه الأماكن بعلاقته الجدلية مع الزمن، ولا يستطيع أن يعيش المرء بمعزل عن الزمن أو أن يقيم خارج المكان، لهذا يعتبر هاجس الزمن مخيف، خاصة على وجدان الشاعر، والشاعر المبدع الذي لا يرتبط شعره بالأماكن، بما في هذه الأماكن من ذكريات يعد شاعرًا ناقصًا للشاعرية وفاقدًا للإبداع، والشاعر عبد الله في هذا النص تداخل عنده هاجس الحنين والتعايش مع ذاكرة المكان، المختلطة بالإحساس بشبح الزمن؛ لأن الزمن يعادل عمره الذي انقضى، ويشكل له المكان تفاصيل حياته، التي ضاعت بين دهاليز السنين.
إن من يقرأ نص “الجهراء” لا يستطيع أن يمر بسلام على تداعيات ذاكرة المكان في هذا النص المشبع بالحنين والخوف والتوجس؛ إذ يبدو عنصر المكان متجليًا، وهو حضور اجتماعي بالدرجة الأولى مرتبط بحياة الشاعر وظروفه المجتمعية، وذلك أنه لم يحرص على عامل الحدس أو التخيل في رسم علاقته بالمكان بقدر ما تعامل معه كحالة إنسانية ذاتية مرتبطة فيه، لم يتطلع إليها عن طريف الحدس، ولم يعمل على رسم دوائرها من خلال التخيل، وإن اعتمد على الخيال في هذه المعادلة، وذلك عن طريق تحفيز طاقات الشعور والعاطفة والحنين لتلك الأماكن؛ إذ تعامل مع هذه الأماكن من خلال استحضارها، كما عايشها، إلا إنه لم يحضرها من خلال الشاب الصغير أو الطفل الغرير، بل استحضرها من خلال روح الفنان وطاقة الأديب ووجدان الشاعر المدرك لأبعاد ما يقول.
إن ما يعمق الحزن في هذا النص ارتباط المكان بالماضي، ولم يكن للحاضر أو التطلع للمستقبل أي حضور يثير الانتباه، وهذا ما يعمق الإحساس بتصدع الزمن عند الشاعر، وهذا المكان انسحب على الزمن؛ حيث منحه الشاعر في هذه القصيدة ذاكرة أخرى توازي ذاكرة المكان، ليتحول المكان إلى زمن، ويتمدد الزمن ليصبح مكانًا، وكأنه زاوج بين الاثنين في هذا النص.
لقد تحولت الجهراء من كونها أرضًا وسماء وإناسًا يقيمون فوق ترابها إلى وعاء احتوى زمان الشاعر وذاكرة أمكنته، التي لا تعني سواه، أي أنها ليست شخوصًا ثابتة أو أسواقَ وزوايا وتضاريس، بقدر ما هي أجزاء متناثرة في الوجدان والضمير والذاكرة، حرص الشاعر على لملمتها من شتات الأفكار والمشاعر عن طريق تفجير طاقات الخيال والعاطفة معتمدًا على لغة شعرية مرنة، ذات عمق إيحائي، ليس فيه تشويش منفر أو تبسيط يفرّغ الوعي من محتواه، لهذا كان يسير في كم من الصور والمعاني والأحاسيس والأخيلة، التي شكلت لديه هذا العمل الشعري المفعم بالجمال والشاعرية.
في هذا الجو المشبع برائحة الحنين للمكان والتوجس من الزمن، لم يكن الإنسان في معزل عن هذا الصراع الجدلي، فقد كان الإنسان حاضرًا في خيال الشاعر وفي وجدانه، وهو الذي أشعل فيه كل هذه الأحاسيس والذكريات، إذ تحول ذلك الإنسان من شخص يعرفه الشاعر، ليذوب فيما بعد بين أجزاء القصيدة؛ لنراه ونلمسه بعد ذلك من خلال ضمير الغائب الذي غيّب “محمد مساهج” وجعله ينتشر كجزيئيات الهواء، التي تناثرت في المكان، واختلطت بالطبيعة والوجود بعد ذلك، وذلك من خلال اتكائه على عمل الظرفية “هنا” التي أعاد تشكيلها أكثر من مرة، إذ جمع من خلال توظيفها بين الزمن والمكان.
لقد كان عبد الله الفلاح فيلسوفًا وشاعرًا في هذا النص، مع ارتفاع ملحوظ وملموس في نبرة الشاعرية، فكان فيلسوفًا من خلال عكس موقفه من الزمن والعلاقة مع الحياة، وشاعرًا في إيصال هذه الروح الشاعرية الفنية المفعمة بالجمال الإنساني والأسلوبي، التي رسمت لنا الذاكرة لديه بهذا التدقيق والرؤية الشاعرية، فلم تكن هذه الإشارات المكانية بالنص مجرد ألفاظ بثها الشاعر هنا وهناك بقدر ما هي وجود خلاق للحالة الشعورية التي تعتلج في وجدانه تجاه هذه الأماكن، أفرزتها العاطفة وتبناها الخيال وصاغتها ماكينة الشاعر اللغوية، التي هي خلاصة تجاربه وظروفه واطلاعاته وذكرياته وأحلامه، ومن ثم قدمها في هذا القالب الفني الماثل أمامنا كقصيدة ذات أبعاد ومقاسات قام الشاعر برسم ملامحها الجغرافية.
لم يكن الشاعر راصدًا للمكان فحسب، فرغم قيام الشاعر برصده لتشكلات المكان، فإنه قدمها من خلال رؤية جمالية فنية، منح هذه الأماكن عبق الحنين وسكب فيها من روحه حلاوة الذكريات، وهذا ما يؤكد أنه نظر إليها نظرة روحية في المقام الأول، لا نظرة مادية تتحدث عن حدود وتضاريس فقط، وذلك حينما ربطها بعامل الزمن الذي تشابك فيه مع المكان؛ ليمثل بعد ذلك الشاعر وصديقه، الذي كان يلعب معه في الزمن الغابر، لهذا اكتسب المكان ملامح الجمال والطهر والصفاء والطفولة والشباب الغض اليافع أيضًا.
والملفت للانتباه في هذا النص، وخاصة حيال هذه الزوايا المكانية أنها تعبر عن طاقات شعورية تختزن في الذاكرة، ولم تكن حدودًا وتضاريس فقط، بل عكست ما بالنص من قدرة جمالية تعبيرية، ابتعدت عن التوصيف التسطيحي للمكان، ونقلته من خلال روح الشاعر، وكأنها عوالم نابضة وحية تزخر بالنشاط والحيوية، كما أنها عكست لنا صدق عاطفة الشاعر، التي انبثقت من روحه؛ لتنتشر بين السطور والكلمات، ومن ثم تنتقل بنفس هذا الزخم النفسي الحار والصادق لوجدان القراء والمتابعين بعد ذلك.
محمد مهاوش
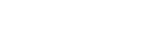














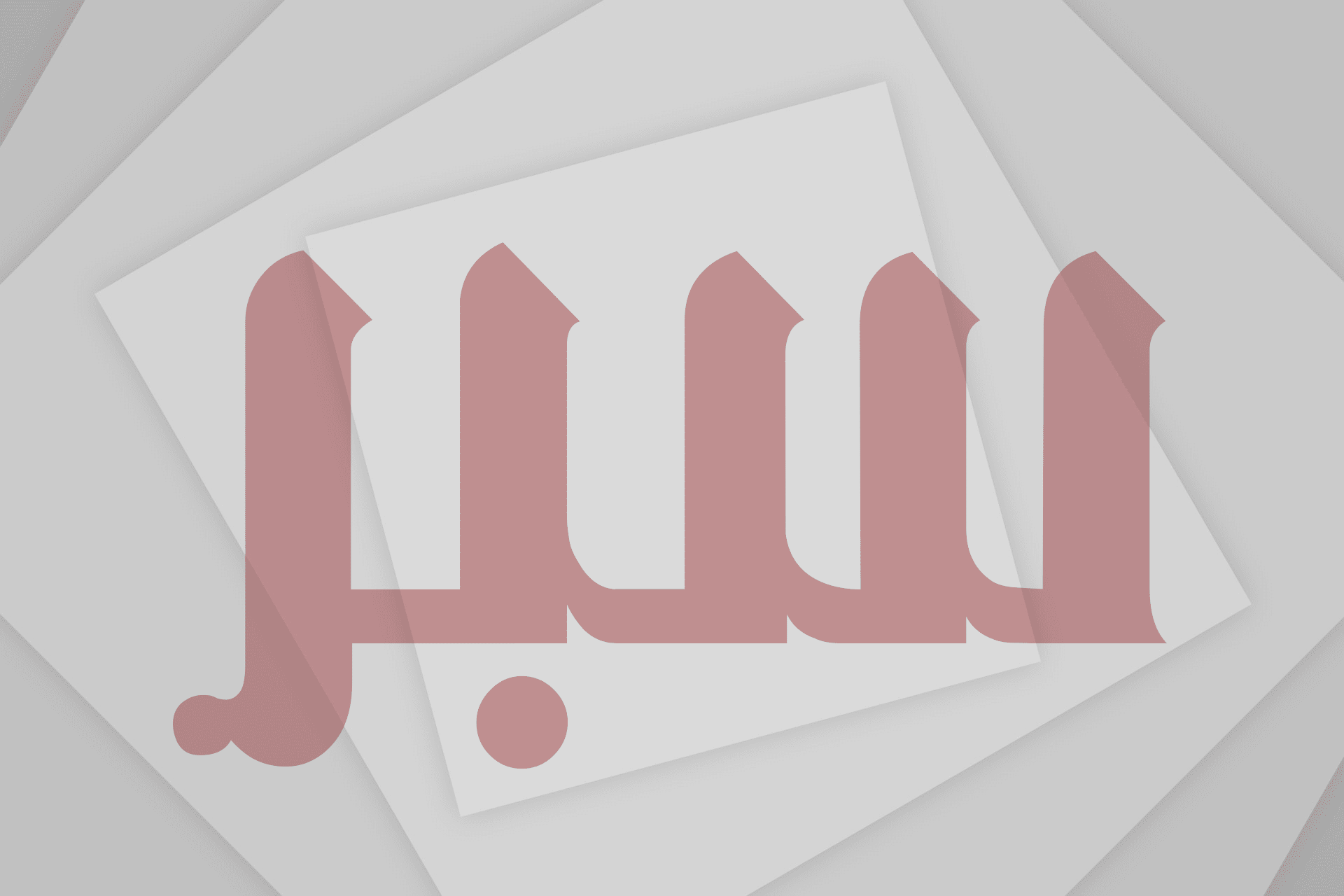



أضف تعليق