الفتاوى التي تغتالنا!
أفراح الهندال:
كثيرا ما تغتال الكلمات المقاصد النبيلة من مدلولاتها المجردة، لتشوهها وتطلقها نسقا تدميريا في المجتمع عبر متلقيها الذين يختلفون في مستويات فهمهم ووعيهم وإدراكهم.
وإساءة استخدام اللغة من أبرز عوائق التفكير التي لا يراعيها الكثير من «المتفذلكين» في الخطب الدينية، أو السياسية، التي تسعى لاتخاذ المواقف المتسيدة للساحة تحليلا واستنتاجا، أوالأطروحات الفكرية، خاصة تلك التي تتخذ شكل الشعارات الشعبية لتدغدغ انتماءات المجتمع الصغيرة، معززة الانغلاق ورفض الآخر، تاركة سعير التناحر يقضي عليه؛ فقط بسبب كلمات تركت على قارعة الطريق وأتت مفعولها!
من أهم تلك الكلمات التي تقتل غيلة، الفتاوى التي يجتهد مطلقوها إعمالا في الرجوع التاريخي وتأويلا بحسب مدارس تقليدية وقواعد فقهية مقننة، بعيدا عن النظرة الإصلاحية التي تراعي وتقيس بحسب الواقع المعيش أو المستحدثات المعاصرة، مما أنتج لنا اصطلاحات لها استثارتها لنوازع العنف والكراهية والتعصب واستفزازها المدمر للآخرين وتحقيرهم، أدواتهم فيها نكش بسيط لصفحات التاريخ المليئة بالدماء، والتي تفوح منها رائحة الكراهية والبغض لإعادة إحيائها ونشرها، كـ «الروافض» و«النواصب»، وإشعال قضايا مستعرة بشرارة الفتنة، لتنهال إثرها كلمات التكفير والزندقة وإقامة الحد بقصد معلن، أو بعشوائية مجتمعية تشيع تأويلاتها البسيطة كمسلمات بديهية.. لتتخذ بكل جرأة هيئة الأحكام النهائية!
ولا يمكن الاستهانة بحالة المنافحة عن الأحكام تلك باسم الفتاوى، وكأن مطلقيها منزهون عن الخطأ، وكأن إقامة الحدود «البينة» موكولة إلى إشارة عقلية «بشرية» وحيدة بيدها مصائر البشر أجمعين، الاحتشاد حولها يهب الطمأنينة ووهم «النخبوية» التي تحتكر الجنة لها دون غيرها، بل وتحتكر أمر فتح وإغلاق باب جهنم، وإلقاء من تخرجه عن دائرتها باحتفالية سادية غريبة.
ومن المؤسف أن من وزعوا تلك الصكوك الموهومة حريصون على تعزيز أثرها، في الطمأنة بملاحظة «سيماء» الوجوه النورانية، أو التبشير بالأحلام وما يصنفونه كرؤى صالحة، ولذلك لا يتوانون في الخروج علنا للحض على الجهاد ضد من يتم تكفيرهم، أو تعنيت من يتوانى في إماطة الأذى عن طريق حياتهم، الذي مهدوه ليتبختروا فيه منفردين.
وتلك حملة لم يسلم منها العلماء الإصلاحيون المهمومون بنشر قيم التسامح والحوار مع الآخر، وإقامة حالة من التعارف الحضاري، فالعولمة ترهبهم، لأنها تكشف هشاشتهم وسطحية أطروحاتهم، التي تقبل السفر والتداوي بأدواء الآخر وامتلاك إنتاجاته التكنولوجية كافة، دون أدنى احترام لعقليته التي خدمت الإنسانية ولم ترهقها بمضبطة التصنيفات الإقصائية التي لا تنتهي.
ومن تلك القاعدة المختتمة بالشمع الأحمر والملتفة بحواجز لا يمكن المساس بها؛ يقتات آخرون لتغذية النمط البطولي الذي تهواه الشعوب البدائية، وإضافتها لتعينه على الاقتراب من الأمثولة الأسطورية قدر المستطاع بتفاصيل حيوانية شكليا وصوتيا وقوى هائلة لا تعجز عن القذف بالكلمات المقيتة والحشرجة وإصدار أصوات الوحوش، وإطلاق كل الممكنات التي تحافظ على مشاعر الكراهية والتقزز من «الآخر» المختلف، والمحكوم عليه بالإعدام والاحتقار الوجودي، ففتوى عابرة يمكنهم من خلالها توظيفها سلبيا والاستناد إليها في ظل فتاوى عديدة أخرى متسامحة، ويمكن للراغب في السلام أن يلوذ إليها مخرجا من أعتى الأزمات الأيديولوجية في المجتمع.
إن لم يتدخل الحكماء في غربلة الأحكام المطلقة جورا، والقذائف الشعبية المسيلة للدموع إنسانيا لفرض قوانين المجتمع المدني، تلك التي اتخذت من الدستور قواعد عقلانية مراعية للأفكار الشمولية وموظفة لحاجة البشرية وتأسيس الدولة الحديثة؛ فإنه دور الأفراد المستنيرين والإصلاحيين الذين يملكون الكلمة التي تؤتي ثمرها ولو آجلا، وإشاعة الثقافة التي تؤسس التفكير الناقد، وتفعل العين الثالثة، التي تقتفي الحقائق العلمية والقيم الأخلاقية التي أطلقنا عليها الضمير الإنساني.
وفي أسوأ حالات عجز إيصال صوت العقل؛ يمكن للتكيف المؤقت أن يوصل إلى نتيجة تقرها قوانين الطبيعة التي لا تعرف سوى التوازن ولو بفوضاها، فارتطام أولئك المتشددين والمتعنتين بالسلطة وبضرورة العمل في المجتمع المدني سينضمون لا محالة إلى ركب التحضر، وسيفعّلون الحراك الانتقالي رغم مقاومتهم، لأنهم رغم دعاوى الانغلاق والرفض ودحر الآخرين تماسوا بالحياة التي تغمرهم بجمالها رغم تشبثهم بالموات، وسيضمحلون سريعا لو آثروا البقاء في القيعان.
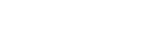



















أضف تعليق