بداية لابد من الاعتذار للكتابة في تفاصيل الشأن المحلّي الكويتي، والذي أصبحت مقتنعاً أن الاستغراق فيه ومناقشة تفاصيله نوع من إضاعة الوقت والجهد وصرف للنظر عن أساس المشكلة المراد إشغالنا عنها بتلك التفاصيل المتكررة.
إلا أن الداعي الذي أظنه يسوّغ لي ملامسة تلك التفاصيل أمران اثنان، الأول أن بعضا ممن أكنّ لهم التقدير والاحترام وأثق بعقولهم خاضوا فيها وحملوا تلك التفاصيل محمل الجد وهم أهل رأي ونظر، أربأ بهم أن تنطلي عليهم ألاعيب السلطة المعروفة أو أن ما يطرحونه يكون مدخلا لارتياب الكثيرين في مواقفهم من عبث السلطة وأن يفتح لهم باب وهمٍ أوشكوا أن يغلقوه للأبد.
أمّا الاعتبار الآخر وهم المهم بالنسبة لي، هو محاولة لإعادة أصل المشكلة لمسارها الصحيح والتركيز عليها والنأي بالرأي العام عن الخوض بتفاصيل مختلقة بغرض إشغال الشعب عن مسار الإصلاح المفترض، كما أن من حقّ المجتمع على كل من تصدى للشأن العام حتى ولو على مستوى منبر الكتابة والرأي أن يبيّن الموقف ويثري الحوار بين مختلف الآراء مساهمة في إنضاج الأفكار وتطويرها.
قصّة قصيرة بثلاث فقرات..
الكويت تشكّلت من خلال ساحل صغير ضمّ بعض القبائل المهاجرة، أصبحت مع مرور الوقت ميناء نشطاً ووفّرت مصدرا للرزق والحياة المناسبة لبضع عشرات الآلاف الذين وفدوا على هذا الساحل وأنعشوه فأصبحت مدينة الكويت وأحاط بها سور طوله 7 كيلو متر ومئتا متر، وخارج السور قبائل تسكن في أراضيها منذ مئات السنين تروح وتغدو حتى سمّيت الآبار والوديان باسمها.
في نهايات القرن التاسع عشر وبموجب تحالف الدولة العثمانية مع الألمان، عزمت الدولة العثمانية على مد سكة حديد يصل للبصرة مما سيجعل النفوذ الألماني يصل لمياه الخليج العربي، سارعت بريطانيا لقطع الطريق على هذا التحالف حتى تحمي مصالحها في بحر العرب ومستعمراتها في الهند فعقدت مجموعة من الاتفاقيات مع بعض مشيخات الخليج ودعمتها في مقابل التمدد “العثماني- الألماني”، وكانت الكويت عبر الاتفاق مع مبارك “الكبير” ضمن هذا الاتفاق سنة 1899م بعد أن قام مبارك الكبير بالتخلص من أخويه محمّد وجرّاح الرافضين لهذه الاتفاقية المذلّة بقتلهما في ليلة واحدة سنة 1896م.
استمرت تلك الاتفاقية ” معاهدة الحماية البريطانية ” حتى سنة 1961م، حين قررت بريطانيا خروجها كمستعمر بصورة مباشرة بعد أن ضمنت أشكالا من الحكم تضمن استمرار مصالحها الاستراتيجية، وكانت الضمانة في الكويت هي دستور “المنحة” من عبد الله السالم سنة 1962م، والذي بموجبه تضمن بريطانيا ما حرصت على استمراره وإن باستخدام القوة كما حصل في سنة المجلس عام 1939م في عهد أحمد الجابر وهي الستة أشهر الوحيدة التي استطاع فيها الكويتيون أن يغيّروا قواعد اللعبة بمجلس منتخب مستقل الإرادة.
من التاريخ للواقع ماذا نستفيد؟!
إن الواقع السياسي في الكويت منسجم تماما مع تاريخها المذكور آنفا، فقواعد اللعبة السياسية المصممة وفق دستور 1962م لا تسمح باستقلال القرار السياسي للشعب الكويتي، بل لا تسمح بالاقتراب فضلا عن اختراق الخطوط الحمراء المقررة في ذلك الدستور، ولذلك لا تستغربوا رد الفعل السريع والعنيف للسلطة بعد مجلس فبراير سنة 2012م وهو المجلس الوحيد في تاريخ الكويت منذ 1962م الذي حقق فيه الشعب أغلبية تشريعية، أي أن باستطاعة الشعب منفردا حتى دون رغبة النظام أو موافقته تشريع قوانين وإقرارها وجعلها نافذة.
إن السلطة في الكويت تستطيع تحمّل كل المناورات السياسية ومختلف الأنظمة الانتخابية “صوتان بعشر دوائر، صوتان بخمس وعشرين دائرة، أربعة أصوات بخمس دوائر، ومؤخّرا صوت بخمس دوائر ” بشرط أن لا يتمكّن الشعب من إيصال أغلبية تشريعية، ولذلك النظام الانتخابي “أربعة أصوات بخمس دوائر” كان مصمما بحيث أنه لو اجتمعت كتلة ناخبة على مستوى الدوائر الخمس في قائمة مشتركة فإن أقصى رقم تحققه إذا نجحت بنسبة 100% هو 20 نائبا فقط من أصل 50 في البرلمان، ولذلك كانت السلطة مصدومة في الاصطفاف الشعبي الكبير الذي أوصل 34 نائبا “معارضا” لسياسات السلطة تلك الفترة، ما يعني الاقتراب من الخطوط الحمر التي أوكل المستعمر المباشر للسلطة عبر دستور 1962م حمايتها ومنع الاقتراب منها.
الاختلاف على المشكلة اختلاف على الحل
إن الجدل الدائر اليوم حول استمرار المقاطعة أو مشاركة السلطة في المسرحيّة المسمّاة “انتخابات مجلس الأمة” ليس جديداً على المجتمع الكويتي أبدا، فبعد تزوير السلطة لانتخابات مجلس 1967م والذي كانت الحركة الوطنية تعتزم فيه تجديد مطالبات مجلس 1938م الضامنة لاستقلال الإرادة الكويتية، خرجت أصوات تطالب بالتكيّف مع الواقع وقبوله إلا أن وقوف بضعة رجال موقفا مبدئيا باستقالتهم من المجلس المزوّر دون الالتفات لشعار “الإصلاح من الداخل”.
كما خرجت نفس أصوات الدعوة للمشاركة المبررة لعبث السلطة بعد انقلاب السلطة على دستورها سنة 1976م، وأيضا تكررت نفس الأصوات الداعية لمشاركة السلطة عبثها وساقت المبررات بعد انقلاب السلطة الثاني سنة 1986م، وخرج أمير الكويت الراحل جابر الأحمد الصباح في تاريخ 20 يناير 1990م بخطاب للشعب الكويتي يدعوه إلى :” تحكيم العقل واللجوء للحوار وتوسيع قاعدة الشورى ودعم الحياة النيابية ” وكانت نتيجة تلك الدعوة للحكمة والعقل ما سمي حينها بـ” المجلس الوطني ” في 10 يوليو 1990م، وقد شارك عدد من الكويتيين في تلك الانتخابات بدعوى الواقعية السياسية وفن الممكن و ” الإصلاح من الداخل”، وكان قدر الله سابقاً للبقية من “الحكماء” الذين ابدوا اعتراضهم ولم تطل بهم السنوات حتى يرجعوا عن رأيهم بداعي أن “المقاطعة لم تنفعنا بشيء” وكان ذلك بسبب الغزو العارقي الغاشم.
لقد قال السفير البريطاني عن تزوير 1967م :” لو كان لدى الأسرة الحاكمة قناعة بولاء المعارضة لآل الصباح، فلربما قبلوا بمعارضة 15 عضوا كضرورة، وكسمة مميزة للتجربة البرلمانية، لكن الشيوخ ليست لديهم الثقة الكافية بقدرتهم على الجدل”
هذا التقييم للموقف من تزوير 1967م من قبل السفير البريطاني يشير فيه لأهمية القبول بمعارضة “محدودة” مثلا 15 عضوا لتضفي ذلك الطابع “المميز” للتجربة الديمقراطية الكويتية، وهي عبارة لطيفة من دبلوماسي ممثل لدولة عريقة في الدبلوماسية والمكر تعني :”مجلسا شكليا صوريا، يتحمّل شكلا من المعارضة غير المؤثّرة”.
إن هذه النصيحة الدبلماسية البريطانية هي بالضبط ما تمارسة السلطة وتلتزم به، وهو بالضبط ما يطالب به البعض من المشاركة في انتخابات مسرحية صورية “محدودة” تبقي السمة “المميزة” للتجربة الكويتية، ولن يعدم أصحاب هذه الدعوة من سوق الحجج والتبريرات والمسوغات ليؤدوا نفس النتيجة المرسومة من قبل السلطة والمحددة سلفا وفقا السرد التاريخي أول المقالة.
وبناء على ما سبق، النظر للمشكلة من زاوية “عاوزين نعيش” يجعل كل ما سبق من أدلة تاريخية ومواقف موثّقة لا عبرة بها ولا قيمة، فالمشكلة عند دعاة المشاركة لعبث السلطة ليست بوضع سياسي مختل لصالح السلطة حتى قبل “منحة ” الدستور، وليست المشكلة تحرير الإرادة السياسية المقيّدة اليوم، وليست المشكلة في نظام سياسي لا يسمح للشعب بانتخاب سلطته التنفيذية، وليس ببرلمان تعيّن فيه السلطة ما يصل لثلثه “15” وزيرا من خارجه، وليست المشكلة بإلغاء الإرادة الشعبية لخطأ إجرائي تحكم له المحكمة الدستورية فتكافئه بإلغاء إرادة شعب.
المشكلة عند من يدعو لمشاركة عبث السلطة هي، أسئلة من قبيل، ماذا حققت المقاطعة؟ كيف نوقف الفساد؟ من يمنع تغوّل السلطة؟ لماذا لا نصلح من الداخل؟ وغيرها من الأسئلة التي بدل البحث عن أجوبتها كان الخيار الأسهل هو العودة للخطأ الرئيسي والمشكلة الأصلية والانخراط فيها والتزامها رغم كل ما سبق، ولا أعلم كيف يبرر العجز عن سلوك الطريق الصحيح بالسير في الطريق الخاطئ الثابت خطؤه!
ماذا عن المقاطعة؟
إن المقاطعة للانتخابات موقف سياسي يعتمد على أسس أخلاقية بالدرجة الأولى، فضلا عن كونه أداة ووسيلة لتحقيق أهداف وغايات سياسية مرجوّة، فالأساس الأخلاقي للمقاطعة هو بإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية ورفض أن تكون بهذا الهوان الذي يجعلها عرضة لعبث السلطة تلغيها بجرة قلم “خطأ إجرائي”، كما أن الموقف الأخلاقي يمنع أن يتحكّم فرد أو مجموعة بقرار شعب كامل ويحدد شكل نظامه الانتخابي وآليته لاتخاذ قراره في تعبير واضح عن الوصاية التي لا يمكن قبولها أبدا، والموقف الأخلاقي يرفض أن نكافئ بطش السلطة بالإذعان، وضربها لنا بالانحناء، وسجنها لشرفاء الشعب ومصلحيه بالتسليم، وهذا الموقف الآخلاقي ليست خطبة تؤجج المشاعر بل هي الأرضية التي يجب أن يقف عليها كل سياسي يحترم نفسه ويحترم من انتدبه للقيام بمهمته، وعلى الشعوب أن تكون في حذر وشك دائم من سياسي لا يمكن التبؤ بموقفه لعدم وضوح أساسه الأخلاقي، وعليها اتهام من لا تتوقع منه أن يقول:” لا ” في المواقف الأخلاقة وعند مفترقات الطرق!
أما كون المقاطعة أداة ووسيلة فنعم، هي أداة وسيلة قابلة للنجاح وقابلة للفشل كغيرها من الأدوات والوسائل، والتمسك بالوسائل على حساب الأهداف عبث لا طائل منه، لكن العدول عن وسيلة “أضعف الإيمان ” للوقوع في “الكفر” لا يمكن تبريره ولا فهمه، فكيف نفسهم موقفا سياسيا مجانيا تتخذه قوى يفترض أنها “سياسية” دون مقابل سياسي؟! بل كيف نفهم “موقفا سياسيا” يعلن أهدافه وأسبابه دون أن يعلن الطريقة التي يحقق بها تلك الأهداف؟!
إن المقاطعة لها عدة أهداف منها الضغط على السلطة لتحقيق الإصلاح السياسي، ومنها منع الفساد ومحاسبة المفسدين، وهذين الهدفين لم يتحققا حتى الآن لأسباب كثيرة، ربما يكون منها فشل القائمين على خيار المقاطعة بأداء الدور كاملا بنجاح، ربما لصعوبة الهدف والذي يتطلب نفسا أطول وزمنا ممتدا لم نبلغه بعد، ربما لتعب الشارع السياسي، ربما لأسباب كثيرة لم أذكرها يمكن معالجتها وجعل المقاطعة مرة أخرى أداة فاعلة، فإن كان القائمون عليها فشلوا في إدارتها أو فشلوا في معالجتها، فهذا لا يمنع آخرين من أن يقوموا بالمهمة ويتغلبوا على فشل من قبلهم، أما أهداف المقاطعة التي تحققت فأهمها وضع الشعب الكويتي أمام حقيقة المشكلة وأساسها وإبعادة عن دائرة الخداع التي يدور فيها منذ 60 سنة ولم يصل لخط نهايتها ولن يصل أبدا طالما أنه يدور فيها، لقد رشّدت المقاطعة الخطاب السياسي وترقّت به وأصبحت المطالبات السياسية مطالبات جذرية ليست شكلية ولا صورية، وهذا الذي حققته المقاطعة مرحلة ضرورية على طريق الإصلاح السياسي المنشود.
أما الحجة الأكثل وهنا وضعفا القول بأن المشاركة في “مسرحية انتخابات مجلس أمة” حددت السلطة قانونه الانتخابي، وهي من تراقب سير الانتخابات، وهي من تعلن النتائج، وهي من توافق على المرشحين، وهي من تضبط من يخل بالعملية الانتخابية وتحيلهم أو لا تحيلهم للقضاء، وهي من تعيّن ثلث البرلمان، وهي من تمنع محاسبة أي لص طوال 60 سنة، وهي التي انقلبت على نظام انتخابي وزوّرت الانتخابات ثلاث مرّات، وهي التي لم تجعل طوال “مسيرة الديمقراطية المحدودة” مجلسا يكمل مدته إلا ثلاثة مجالس، إن حجة رغم كل ذلك تقول:” أشارك لتخفيف الضرر ” حجة بيّن وهنها وهزالها وغير جديرة بالاحترام بكل صراحة.
يسألون عن الحل..
إن حل المشكلات الاجتماعية والسياسية لمجتمع ما يعبر حلا مركبا له عدة أبعاد وعوامل، ولا يمكن أن تعطي لمجتمع وصفة دواء واحدة تحل بها كل مشاكلة، إلا أن معرفة المشكلة وأصل الداء أمر أساس لمعالجته، وما هذه المقالة وغيرها مما يثير الحوار في المجتمع الكويتي إلا إجزاء مهمة وضرورية لتشكيل الحل وطرحه، علينا كمجتمع أن نصرّ على الإصلاح السياسي ومعالجة جذور المشكلة المتمثّلة في انتقاص حق الشعب في إدارة شؤونه وفرض الوصاية عليه من قبل السلطة، كما علينا أن نستمر في مواجهة الأفكار والأطروحات التي تحاول إعادة الشعب للعبة السلطة العابثة مهما كانت مصادر تلك الآراء ومهما كانت نوايا من يصرح بها، فالنوايا الحسنة لا تكفي لتبرر السير في الطريق الخاطئ.
الحل، فيما قام به عمر العريمان بجهد الفردي برسم صور المعتقلين في الآماكن العامة، الحل بالوقوف خلف المعتقلين السياسيين والمطاردين وعلى رأسهم أبو حمود مسلّم البراك، الحل بالتضامن ودعم عوائل من سحبت جنسياتهم وانتهكت مواطنتهم ظلما وعدوانا، الحل باحترام كل تضحيات الشعب التي مازالت مستمرة والجروح التي لا تزال تنزف والوفاء لما قدمه الشعب الكويتي في سبيل استقلال إرادته وحقوقه، الحل في أن لا ننتظر الحل من أحد ونعمل باستطاعتنا وبوسعنا كل ما يساهم في الخلاص من ممارسات السلطة واستفرادها، الحل بتنظيم الجهود وإن خمسة أفراد أو أكثر أو أقل يتبنون قضية أو فعالية أو حتى ندوة في ديوانية يساهموا من خلالها بحثّ الناس على الصبر واستمرار المواجهة، الحل حين يتراكض الكثيرون ليقبّلوا اليد التي تضربهم معلنين تحت سياطها استسلامهم الذي يريدوننا أن نشاركم فيه بتبريراتهم و لا تجد من حولك إلا القليل أن تعزّي نفسك بقول الله تعالى :” قال ربّ إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين “
طارق نافع المطيري
رئيس الحركة الديمقراطية المدنية – حدم
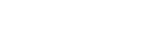


















أضف تعليق