- إن نظرية “أعمال السيادة” ليست ولا ينبغي أن تكون وسيلة السلطة وسبيلها للخروج عن حدود المشروعية.
- القرارات المتعلقة بإسقاط وسحب الجنسية لا تحتوي تلك العناصر والأوصاف التي تحتويها وتوصف بها أعمال السيادة.
- أي نظام وضع القانون قواعده هو نظام يخضع بطبيعته لمبدأ سيادة القانون ورقابة القضاء.
- سلطة الإدارة ليست مطلقة وقراراتها لا تكون مشروعة إلا إذا استندت إلى أسباب صحيحة وقانونية.
- مهما قيل في حق الإدارة في اتخاذ ما تراه من قرارات فإن هذا الحق مقيد بالقوانين وخاضع لرقابة القضاء.
- يقع على عاتق القاضي الإداري على الأخص واجب حماية المشروعية ضد تعسف الإدارة.
- تفسير المحكمة للنصوص السالبة لاختصاصها يفترض أن ينحاز للمشروعية والحقوق والحريات ويقترب من الحق والعدل على حساب القرارات التي تحيد عنها.
- لا يعقل أن يستوجب المشرع شروطا خاصة بالقانون ثم يضفي حمايته وسلطانه على القرارات التي تنحرف عن تلك الشروط!!
- التطبيق الخاطئ للقانون لا يحول دون رقابة المحكمة.. ولا يمكن اسباغ الحماية إلا على القرارات السليمة المطابقة للقانون.
- لا يصح القول أن من يملك سلطة تقديرية واسعة في إصدار قرار منح الجنسية يمتلك ذات السلطة في سحبها.
- كيف يتحقق العدل وتصان الحرية في ظل حرمان الناس من حقهم بالدفاع عن أنفسهم؟!
- كيف تتأتى كفالة أمن واطمئنان المجتمع وأفراده في ظل تعلق مصيرهم بيد السلطة دون رقابة أو ضمانة تكفل لهم صون حقوقهم؟!
- المحكمة الإدارية: الحق في الجنسية حق مقرر قانونا لا يجوز مصادرته دون علة ولا مناهضته دون مسوغ.
- كيف يقرر الدستور عدم جواز اسقاط أو سحب الجنسية إلا في حدود القانون، ثم تنتفي بعد ذلك ضمانة الرقابة القضائية تلك القرارات؟!
- حق الأفراد في التقاضي هو حق أصيل باعتباره عماد الحريات جميعا، إذ بدونه يستحيل أن يأمنوا على حرياتهم أو يردوا الاعتداء عليها.
- لا معنى لتقرير حق ما وحجب الوسيلة القضائية التي يمكنها حمايته.
- كل تقييد لوسيلة المطالبة القضائية هو في حقيقته تقييد لوظيفة القضاء.
- ما يطلقه الدستور لا يملك أن يقيده القانون.
- كلما تعلق النزاع بالحقوق والحريات فليس للقضاء التخلي عن اختصاصه وواجبه الدستوري في التصدي للمسألة والأمر المعروض وفحص مشروعية التصرفات والقرارات الصادرة من السلطة بشأنها.
- لا يمكن أن يكون القضاء ضامنا حقيقيا للحقوق والحريات في ظل منعه – أو امتناعه – عن بسط رقابته على بعض قرارات وتصرفات السلطة التنفيذية التي تمس حقوق وحريات الأفراد بشكل مباشر.
- المتقاضي الذي يوصد دونه باب القضاء ويحال بينه وبين قاض ينصفه لا يكون قد حظي بأية عدالة.
- لا يستقيم أن يكون “القضاء وعدل القضاة ضامنا للحقوق والحريات” في ظل تجريد الأفراد من هذه الضمانة في مواجهة السلطة.
- لا يجوز أن تتناول جهة الإدارة حقوق الناس بما يصدر عنها من قرارات ويحرم أصحاب الحقوق في الوقت ذاته من الطعن عليها.
- الدستور قد حمل القضاء الإداري مسئولية وواجب الرقابة على القرارات الإدارية المخالفة للقانون وجعلها ضمن دائرة اختصاصه ومشمولة بنطاق ولايته إلغاء وتعويضا.
- انعقد اجماع فقهاء القانون الدستوري في الكويت علي عدم دستورية النص المانع من حق التقاضي.
- عثمان عبد الملك: النظام الدستوري الكويتي لا مجال فيه للتشريعات المانعة من التقاضي أو النصوص المحصنة لبعض القرارات الإدارية.
- عادل الطبطبائي: المشرع الكويتي لا يزال يحصن بعض أنواع القرارات الإدارية ويمنع المحاكم من التصدي لها بالإلغاء، وهي القرارات الخاصة في مسائل الجنسية…، ولا شك أن هذا النص تحيطه الشبهات الدستورية من كل جانب.
- المحكمة الدستورية: لا يكفى تقرير الحقوق والحريات للأفراد دون أن يقرن ذلك بحقهم في المطالبة بها والذود عنها وحمايتها وحق الدفاع عنها بالتقاضي بشأنها.
- المحكمة الدستورية: كل مصادرة لحق التقاضي تقع باطلة، ومنافية لمبادئ حقوق الإنسان، ومخالفة للأصول الدستورية وقواعدها العامة.
- المحكمة الدستورية: حرص الدستور الكويتي على كفالة حق التقاضي للناس كافة، وحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو تصرف أو أي قرار إداري تتخذه الجهة الإدارية في إطار مباشرتها لنشاطها العام من رقابة القضاء.
أعد النائب السابق والمحامي فيصل اليحيى دراسة حول مدى تعلق مسائل الجنسية بأعمال السيادة ومدى اختصاص القضاء في قرارات اسقاطها وسحبها على ضوء آراء الفقه وأحكام المحاكم.
دراسة حول مدى تعلق مسائل الجنسية بأعمال السيادة
ومدى اختصاص القضاء في قرارات اسقاطها وسحبها على ضوء آراء الفقه وأحكام المحاكم
اعداد المحامي/ فيصل صالح اليحيى
“إن الرقابة القضائية يجب ألا تخيف أحدا لأنها لا تضر أحدا. ذلك أن المصلحة العامة تقتضي أن تسير الإدارة في الدولة وفقا لمقتضيات مبدأ المشروعية، وتحاول أن تضرب بنفسها المثل على احترام هذا المبدأ حتى تحمل الرعايا على احترامه اقتناعا به وليس لمجرد الخوف من الجزاء. ثم أنها بخضوعها للمشروعية تحمي النظام كله من مظنة أن يكون غير ملزم.”
الأستاذ الدكتور/ عثمان عبد الملك الصالح
مقدمة لازمة:
إن نظرية “أعمال السيادة” ليست ولا ينبغي أن تكون وسيلة السلطة وسبيلها للخروج عن حدود المشروعية، كما أنها لا يفترض أن تكون درعا يحمي قراراتها المخالفة للقانون أو حصنا تعتدي من خلفه على حقوق الأفراد والمجتمع دون رادع أو رقيب، وهي عندما أقرها مجلس الدولة الفرنسي مكرها، في بداية نشأتها التاريخية قبل أن تتقلص وتتراجع وتكاد أن تتلاشى، لم يقصد أن يجعل منها مطية للتغول على حقوق الناس وحرياتهم.
فالحكومة في كل الأحوال يفترض أن تمارس سلطتها في حدود القانون تحقيقا للمصلحة العامة، وليس من المصلحة العامة في شيء بخس الناس حقوقهم أو العبث بمصائرهم، كما أنه ليس من المصلحة العامة في شيء أن تطلق السلطة من عقال القانون لتجعل من هواها القانون الأسمى والأعلى الذي تحتكم إليه دون رقابة قضائية تكبح جماحها إذا ركبت متن الشطط، لأن في ذلك إهدار لأهم وأخطر ضمانات الأفراد والمجتمع وهو ما يؤدي حتما إلى خلق بيئة حاضنة للتسلط تضيع فيها الحقوق ويتحول القانون فيها إلى أداة ابتزاز بيد صاحب القوة والنفوذ، وهي المقدمة الطبيعية لتحطم أي الدولة وضياع المجتمع فيها.
وفيما يتعلق بمسائل الجنسية، فإنه إن كان هناك ما يبرر “نظريا” تمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية واسعة في إصدارها لقرارات منح الجنسية أو رفض منحها، باعتبار أن مثل هذه القرارات تتسم بطابع سياسي يرتبط بكيان الدولة وحقها في اختيار من ينضم إلى جنسيتها في ضوء ما تراه وتقدره، إلا أن ذلك يجب ألا يمتد ليطال قرارات سحب الجنسية وإسقاطها بعد أن تعلق بها حق ومصير ومستقبل من حصل عليها إلا في إطار القانون وضمن شروطه ومحدداته وتحت رقابة القضاء، حتى لا تكون مصائر الناس وحاضرهم ومستقبلهم معلق بيد السلطة دون أي ضمانة تكف للأفراد حقوقهم.
ذلك أن الجنسية من الأمور الهامة للفرد باعتبارها تمثل هويته وانتمائه ومن غيرها يكون بلا وطن ولا هوية، فضلا عن امتداد آثار سحبها أو اسقاطها على من نالوها بالتبعية له، وبالتالي فإن مثل هذه القرارات لا تطال فردا واحد بل تتجاوزه لتطال أسرا بأكملها – ولا أقول أسرة هذا الفرد وحده – بعد أن تعاقبت أجيالها وتعدد أبناؤها وتنوعت أعمالهم وتزاوج أفرادها وتكاثر نسلهم وتشعبت صلاتها وتمددت علاقاتها حتى صاروا خيوطا من نسيج المجتمع، ولبنة في بنائه، وجزء من أفراده.
ولذلك فإن التعاطي مع هذه القضية يتطلب إدراكا عميقا لحجمها الحقيقي الذي يتجاوز الفرد ليصل إلى المجتمع بأسره، واستحضارا للخطر الكبير الكامن خلفها، والذي قد يعصف بالجميع.
لا نقول هنا أننا نضع مصير وحاضر ومستقبل فرد أو أسرة بأكملها على المحك، وهو بلا شك أمر كبير وخطير، بل إننا نزعم ولا أظن بأننا نبالغ في زعمنا إن قلنا أننا نضع مصير بلد بأكمله ومجتمع بأسره على المحك… وهو بلا شك أمر أكبر وأخطر… والله المستعان.
وتأتي هذه الدراسة لبحث هذا الموضوع في قسمين، يتناول القسم الأول مدى تعلق قرارات سحب واسقاط الجنسية بأعمال السيادة، كما يقدم قراءة وتفسير لنص الفقرة (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية وذلك في إطار باقي النصوص التي تتناول مسائل الجنسية، في حين يبحث القسم الثاني مدى دستورية الفقرة المشار إليها على ضوء آراء الفقه وأحكام المحكمة الدستورية.
القسم الأول:
أولا: قرارات اسقاط وسحب الجنسية لا تتعلق بأعمال السيادة:
يذهب البعض إلى القول بأن قرارات اسقاط وسحب الجنسية تتعلق بأعمال السيادة، وبناء عليه فهي محجوبة عن نظر القضاء تطبيقا لنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 23/90 بشأن تنظيم القضاء، والذي جرى على أنه: “ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة”
وهذا الرأي لا يقوم على أساس سليم ذلك أن معيار التفرقة بين أعمال السيادة وأعمال الإدارة هو معيار مادي أساسه كنه العمل وطبيعته. فأعمال السيادة هي تلك التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة عامة، وفي نطاق وظيفتها السياسية. والأعمال الإدارية هي تلك التي تقوم بها عادة في حدود وظيفتها الإدارية.
وقد استقرت أحكام القضاء الإداري في مصر والكويت على أن: “التفرقة بين أعمال الإدارة وأعمال السيادة مرده إلى القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه، وما إذا كان يعد عملا إداريا عاديا أو عملا من أعمال السيادة”
وصفوة القول فيما تقدم أن العبرة في تحديد التكييف القانوني لأي عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان عملا من أعمال السيادة أو عملا إداريا عاديا، هي بطبيعة العمل ذاته، فلا تتقيد المحكمة وهي بصدد اعمال رقابتها على دستورية التشريع أو مشروعية القرار بالوصف الذي يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة وأعمالها، متى كانت بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف، وتنطوي على إهدار حق من الحقوق التي كفلها الدستور كحق التقاضي.
وبالرجوع إلى مجموعات الأحكام الصادرة من القضاء المصري والكويتي، يمكن حصر تلك الأعمال في الأعمال المنظمة لعلاقات السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، والأعمال المتصلة بشئون الدولة وعلاقاتها الخارجية أي الأعمال الدبلوماسية، والأعمال المتعلقة بالحرب، وبعض التدابير الخاصة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي.
لما كان ما تقدم وكان البين من القرارات المتعلقة بإسقاط وسحب الجنسية أنها قرارات إدارية عادية أصدرتها الإدارة في حدود وظيفتها الإدارية كونها تقع خارج نطاق الأعمال المشار إليها سلفا، كما أنها لا تحتوي تلك العناصر والأوصاف التي تحتويها وتوصف بها أعمال السيادة، وبالتالي فلا سبيل لإقحامها في طائفة تلك الأعمال.
ولا وجه للتحدي – في هذا المقام – بالقول أن: “مسائل الجنسية (على إطلاقها) بدولة الكويت وما يتعلق بها من إجراءات هي من أعمال سيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة ولا يجوز مناقشتها”، باعتبار أن فكرة المحافظة على كيان الدولة وسلامتها واستتباب أمنها الداخلي والذود عن سيادتها في الخارج لا تتسع لتشمل كل القرارات المتعلقة بالجنسية، خاصة تلك المتعلقة بإسقاطها وسحبها، وهو ما يكون معه الرأي الذاهب إلى عدم اختصاص المحكمة ولائيا بالرقابة على تلك القرارات لتعلقها بأعمال السيادة، قائم على غير أساس سليم من الواقع والقانون.
يؤكد ذلك ويؤيده ما استقرت عليه أحكام القضاء الإداري في الكويت من خضوع قرارات اسقاط الجنسية (المتعلقة بالجنسية بالتأسيس أو بصفة أصلية) لولايتها وحق المحكمة بإعمال رقابة المشروعية عليها للتأكد من سلامتها وقيامها على سندها الصحيح من الواقع والقانون.
وهو ما يعني إخراج المحاكم لقرارات اسقاط الجنسية من دائرة أعمال السيادة، إلا أنها قصرت ذلك على قرارات الاسقاط دون قرارات سحب الجنسية (المتعلقة بالجنسية المكتسبة أو بالتجنس)، وتفريق المحكمة بين هذين القرارين وإضفاء حقها بالرقابة على الأول دون الثاني لا يقوم على أساس سليم، وهو ما سنتناوله بالتفصيل لاحقا.
وما يعزز فكرة خضوع تلك القرارات لرقابة القضاء ما استقرت عليه محاكم القضاء الإداري منذ بواكير أحكامها من أنه: “لا يعتبر من قبيل أعمال السيادة ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذا للقوانين واللوائح، إذ أن مثل هذه القرارات تندرج في دائرة أعمال الحكومة العادية، وليس لها من الشأن والأهمية الخطيرة ما يرفعها إلى مرتبة الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة، وما دام هناك نص في القوانين واللوائح يتضمن ما يجب اتخاذه من الاجراءات أو ما يلزم توافره من الشروط لإتمام عمل من أعمال الإدارة، فالقرار الإداري الذي يصدر بالتطبيق لهذا النص يكون من القرارات التي تتعلق بتنفيذ القوانين واللوائح ولا صلة لها بأعمال السيادة”
ذلك أن أي نظام وضع القانون قواعده هو نظام يخضع بطبيعته لمبدأ سيادة القانون ومن ثم رقابة القضاء.
ولما كان المرسوم الأميري رقم 15/1959 بقانون الجنسية قد رسم الحدود ووضع الضوابط وحدد الشروط اللازمة لإصدار القرارات المتعلقة بإسقاط أو سحب الجنسية، وبالتالي فإن أي قرار تصدره السلطة في هذا الشأن يفترض أن يكون في حدود ما يقرره هذا القانون، وهو ما ينزع عنه صفة أعمال السيادة لتعلقه بعمل إداري يفترض أن تقوم به الحكومة في إطار وظيفتها الإدارية وفي حدود النص الذي اتخذته سندا في إصداره، ولا وجه في ذلك للتفريق بين قرارات اسقاط الجنسية وقرارات سحبها.
وحيث أن سلطة الإدارة ليست سلطة مطلقة، وأن ممارستها لحقها في إصدار ما تراه من قرارات لا يكون مشروعا إلا إذا استندت هذه القرارات لاعتبارات أساسها المصلحة العامة ولأسباب جدية قائمة بذاتها. باعتبار أن هناك قيدا على سلطة الإدارة في هذا الصدد هو ما ورد في القوانين التي تضع للإدارة ضوابط استعمال هذا الحق وحدوده. وعليه فمهما قيل في حق الإدارة في اتخاذ ما تراه من قرارات، فإن هذا الحق مقيد بالقوانين التي تنظمه، وإذا كان الأمر كذلك فإنها تخضع في استعمال حقها هذا لرقابة القضاء ليكشف عما إذا كانت قد استعملت هذا الحق على الوجه الذي رسمه القانون أم أنها تجاوزت القانون عند استعمالها له.
ويقع على عاتق القاضي الإداري على الأخص واجب حماية المشروعية في الدولة ضد تعسف الإدارة، فإذا تبين للقاضي أن طبيعة العمل الذي يفحصه، أنه عمل إداري وجب عليه أن يقبل الدعوى الموجهة ضده على الفور إذا توافرت الشروط الأخرى لذلك، ويخضعه لرقابته الكاملة دون التفات لدفع الإدارة بأن هذا العمل أو غيره من أعمال السيادة، حيث لا سيادة إلا للشعب والقانون.
ولقد أحسنت الدائرة الإدارية عندما ذهبت – في أحد أحكامها – إلى القول أنه: “ليس صحيحا أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة مطلقة فيما تترخص فيه بلا معقب عليها، إذ لا تتمتع أي جهة إدارية بسلطة مطلقة لكنها يمكن أن تتمتع بسلطة تقديرية واسعة، وأنه مهما اتسعت هذه السلطة فإنها تخضع دوما للرقابة القضائية…”
ولا يمكن تبين مدى التزام جهة الإدارة بحدود المشروعية من عدمه – فيما يتعلق بقرارات اسقاط أو سحب الجنسية – دون بحث موضوع القرار وتمحيص أسبابه وصولا لمعرفة الغاية منه، لتزنه المحكمة بميزان القانون في ضوء صحيح واقعه وحقيقة ما قامت عليه أركانه ومدى استقامته على أسس مستمدة من عناصر ثابتة في الأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
ثانيا: قراءة مختلفة لنص الفقرة (خامسا):
يذهب البعض إلى القول بأن المحكمة ممنوعة من النظر في كافة القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية، وذلك على سند من نص الفقرة (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والذي جرى على أن:
“تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة ادارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو اكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الأتية، وتكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض:
أولاً:………… ثانياً:……….. ثالثاً:……….. رابعاً:……….
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وترخيص اصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.”
وهذا الرأي مردود عليه، حيث سبق القول: بأن الجنسية من الأمور الهامة للفرد باعتبارها تمثل هويته وانتمائه ومن غيرها يكون بلا وطن ولا هوية (وإن صح التعبير فإن سحبها من حاملها يجعله في حكم من أعدم مدنيا)، وبالتالي فإن التعاطي مع هذا الموضوع يتطلب إدراكا عميقا لحجمها الحقيقي الذي يتجاوز الفرد ليصل إلى المجتمع بأسره، واستحضارا للخطر الكبير الكامن خلفها، والذي قد يعصف بالجميع ويضع مصير بلد بأكمله ومجتمع بأسره على المحك.
وعليه فإن تفسير المحاكم للنصوص السالبة لاختصاصها والمانعة من نظر بعض الدعاوى – خاصة تلك المتعلقة بمسائل الجنسية – يجب أن تأخذ بالاعتبار كل المعطيات السابقة والآثار المترتبة عليها، لتتبين الطريق الأسلم والأقوم الذين يفترض أن تنحاز فيه للمشروعية والحقوق والحريات على حساب القرارات التي لا تراعيها، وتقترب فيه من الحق والعدل على حساب ما قد تحتويه تلك القرارات من انحراف عن جادتهما.
فضلا عن ذلك فإن النص (المانع) الذي تتخذه جهة الإدارة حصنا لقراراتها وحاجبا للقضاء عن القيام بواجبه في الرقابة على أعمالها، يعد استثناء على القاعدة وخروجا على الأصل العام في خضوع كل قرارات الإدارة لرقابة القضاء، والمستقر فقها وقضاء أن الاستثناء لا يتوسع فيه ولا يقاس عليه، وتفسيره يجب أن يكون في أضيق الحدود، والمحكمة في إعماله تسعى إلى تقليص نطاقه ومداه ما وسعها ذلك.
ومن هنا ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر إلى القول: “أن الأصل المؤصل في بلد يقدس وعيه العام مبدأ المشروعية هو تسليط رقابة الإلغاء على كافة القرارات الإدارية دعما للضمانة الأصلية التي يحققها قضاء الإلغاء لمن تحيفت بهم تلكم القرارات. فإذا ورد في قانون نص يقضي باستثناء طائفة من القرارات من رقابة الإلغاء والتعويض لحكمة ابتغى الشارع إصابتها وغاية مشروعة قصد حمايتها وجب تأويل هذا النص بصورة مضيقة مع الاحتراس من توسيع مدى شموله حرصا على عدم إهدار هذه الضمانة التي يوفرها قضاء الإلغاء وتوقيا لمحظور أتى به هذا النص من قبل هو أنه أوصد باب الطعن بالإلغاء والمطالبة بالتعويض معا…”
ويستطرد ذات الحكم تعليقا على مادة في القانون حظرت الطعن على طائفة من القرارات بالقول: “أنه إذا صدرت القرارات المنفذة للقانون في إطار الشروط التي أوجبها فإنها تقع حصينة من الإلغاء وبمنأى من أي طعن، إلغاءً أو تعويضا، إذ يضفي عليها الحظر الوارد بالقانون حمايته، أما إذا انحرفت عن تلك الشروط، فإن الحظر لا يحميها ويكون من حق من صدرت في شأنه أو من يضار بها أن يطعن عليها بالإلغاء أو يطلب التعويض عنها. ولا حجية فيما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الحظر الوارد بالقانون عام يشمل جميع القرارات سواء ما توافرت فيها الشروط التي أوجبها القانون أم ما لم تتوافر فيه تلك الشروط… فهذا القول مدحوض بأنه لا يعقل أن يستوجب المشرع شروطا خاصة بالقانون ثم يضفي حمايته وسلطانه على تلك القرارات التي تنحرف عن تلك الشروط التي وضعها والتي تنطوي على الانتقاص من الحقوق المكتسبة والأوضاع المستقرة للأفراد، وقد كان في مقدوره لو أراد ذلك أن يتحلل من تلك الشروط بجعل سلطان الإرادة في تنفيذ أحكام هذا القانون مطلقا من كل قيد”
ويتبين مما تقدم أن المحكمة – في سبيل تقليص دائرة المحظور عليها النظر فيه وتوسيع دائرة اختصاصها الأصيل – قد قررت بشأن أحد النصوص المانعة من نظر الدعوى، أنه يتعين لذلك أن يكون القانون قد طبق تطبيقا صحيحا، أما إذا طبق القانون تطبيقا خاطئا، فإن هذا التطبيق الأخير لا يحول بين صاحب الشأن وبين الطعن على القرار الخاطئ الذي يصدر بشأنه… لأن القول بغير ذلك معناه اعفاء الإدارة من أية مسئولية ترتبت على تصرفاتها حتى تلك المخالفة للقانون الذي يحكم تصرفاتها والذي تستند إليه.
ذلك أنه إذا كان الشارع قد عصم قرارات بعينها من الطعن فيها بالإلغاء مراعاة لوجه من وجوه المصلحة العامة، فإنه لا يمكن أن يسبغ هذه العصمة إلا على القرارات السليمة التي تصدر بالتطبيق لأحكام القانون… لا على القرارات التي تقوم على اخلال متعمد بأحكام القانون، إذ لا يعقل أن يقصد الشارع حماية البطلان الذي قد يجعل القرار في حكم العدم، وإذا كان الشارع لا يعتد بالأحكام النهائية التي تبنى على الغش والتزوير إذ يجيز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر، فإن هذا ما يجب أن يكون عليه الحال بالنسبة للقرارات الإدارية التي لا ترقى إلى مرتبة الأحكام.
ولذلك كان حق الإدارة بسحب واسقاط الجنسية هو حق مقيد – أو هكذا يفترض – بشرط التزامها بالضوابط التي حددها ونص عليها المرسوم رقم 15/1959 بقانون الجنسية، ولا يمكن التحقق من التزام الإدارة بهذه الشروط والضوابط إلا بإعمال الرقابة القضائية عليها.
وقد أقرت الدائرة الإدارية لنفسها – على نحو ما سبق البيان وبالرغم من وجود النص (المانع) المشار إليها –الحق في الرقابة على قرارات اسقاط الجنسية (المتعلقة بالجنسية بالتأسيس أو بصفة أصلية)، إلا أنها قصرت ذلك على تلك القرارات دون قرارات سحب الجنسية (المتعلقة بالجنسية المكتسبة أو بالتجنيس)، وهذا التفريق بين قرارات (الإسقاط) وقرارات (السحب) لا يقوم على سند صحيح من القانون، خاصة أن نص المادة (27) من الدستور قد ساوت بين هذين النوعين من القرارات في مجال الحماية الدستورية، حيث نصت على أن: “الجنسية الكويتية يحددها القانون. ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون.”، ويتضح من هذا النص أن الدستور في معرض تقريره لحقوق الأفراد لم يفرق بين قرارات (الإسقاط) وقرارات (السحب) مساويا بينهما في المرتبة ومضفيا عليهما ذات الحماية وموجبا على السلطة عدم جواز اتخاذ أي منهما إلا في حدود القانون.
ولا يصح القول – بهذا الشأن وفي معرض التفريق بين قرارات الاسقاط وقرارات السحب – أن من يملك سلطة تقديرية واسعة – وربما مطلقة – في إصدار القرارات المتعلق بالجنسية منحا أو منعا (الخاصة بالجنسية المكتسبة) يمتلك ذات السلطة في سحب الجنسية بعد منحها، لأن ذلك يجعل قرارات منح الجنسية في حالة قلق وعدم استقرار دائم طوال فترة بقائها، وهذا الأمر يتنافى حتما مع المنطق القانوني والنصوص الدستورية من عدة وجوه:
إذ هو أولا يخالف مبدأ استقرار الأوضاع الذي تتغياه التشريعات واستقر عليه الفقه والقضاء الإداري والذي تقرر بناء عليه تحديد مدد محددة أوجب القانون مراعاتها في سحب القرارات والطعن عليها بالإلغاء ليصبح القرار بعد فواتها مستقرا غير قابل للطعن أو السحب حتى لو كان يشوبه البطلان، وذلك تحقيقا لمبدأ استقرار الأوضاع.
وهو ثانيا يخالف الغاية التي تقرر بمقتضاها اعتبار القرارات المتعلقة بمنح الجنسية ذات طابع سيادي، إذ أن الهدف من ذلك – كما سبق البيان – هو تقرير حق الدولة في اختيار من ينضم إلى جنسيتها من العناصر والأفراد الذين يمكن دمجهم بمجتمعها بما لا يخل أو يؤثر باستقرار ذلك المجتمع، ليصبحوا بعد ذلك جزءا من مواطنيها وخيوطا مغزولة في نسيجها الوطني والاجتماعي يُنتظر منهم – ما ينتظر من غيرهم من المواطنين – المساهمة في بناء الدولة ونموها وازدهارها واستقرارها، ولا يمكن تحقيق هذه الغاية طالما أن قرار منحهم الجنسية ظل معلقا، دائم القلق، وغير مستقر لأنه معرض للإلغاء في أي وقت دون رقابة قضائية تكفل لحاملها الدفاع عن حقه في مسألة تعتبر من أخطر المسائل التي تمس هويته وكيانه وانتماءه ومصيره وحاضره ومستقبله، إذ ستظل هذه الشريحة وأبناؤها وأبناء أبنائها – التي تمثل نسبة غير قليلة بالمجتمع وتعتبر جزء منه ومكونا أساسيا من مكوناته – بل وكل من يتصل بها بصلة النسب أو القرابة، في حالة قلق وعدم استقرار دائمين ولأمد غير محدود، وهو ما يعوق اندماجها اندماجا حقيقيا كاملا في المجتمع وكيان الدولة طالما أن بقي مصيرها معلقا على الدوام بيد السلطة، وهو بالتأكيد ما يتعارض مع المصلحة العامة التي تقتضي استقرار الأوضاع النفسية والعائلية والاجتماعية للمواطنين بصفة عامة – ولهذه الشريحة التي هي جزء من المواطنين بصفة خاصة – والتي لا تتأتى إلا باستقرار أوضاعها القانونية، وهو ما لا يتم إلا بإعمال الرقابة القضائية الفاعلة على قرارات سحب واسقاط الجنسية التي من شأنها منع التعدي على حقها بما يكفل لها الطمأنينة والاستقرار في المكان الذي يفترض أنه بات وطنا لها، وهو الاستقرار الطبيعي الذي يهدف كل نظام قضائي وقانوني لتحقيقه ويسعى لكفالته وحمايته. ولذلك فإن الأهداف والغايات التي جعلت من القرارات المتعلقة بمنح الجنسية من طائفة القرارات السيادية – المحجوبة عن الرقابة القضائية – لتعلقها بكيان الدولة وحقها في اختيار من ينضم إلى جنسيتها بما يكفل استقرار المجتمعات فيها، هي ذاتها التي تستوجب اقرار حق الرقابة القضائية على القرارات المتعلقة بسحب الجنسية، وذلك حفاظا على استقرار المجتمع وحماية لكل مواطن فيه.
وهو ثالثا يتنافى مع ما قرره الدستور في المادتين (7)، (8) الواردتين في الباب الثاني منه والمتعلق بالمقومات الأساسية للمجتمع، حيث نصت المادة (7) على أن: “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع…” في حين نصت المادة (8) على أن: “تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة…”، إذ كيف يتحقق العدل وتصان الحرية في ظل حرمان الناس من حقهم في الدفاع عن أنفسهم في مواجهة قرارات السلطة، وفي ظل امتناع القضاء عن الرقابة على تلك القرارات التي تمس حريتهم وحياتهم؟! وكيف تتأتى كفالة أمن واطمئنان المجتمع وأفراده – أو شريحة منهم – في ظل تعلق مصيرهم بيد السلطة دون رقابة عليها أو ضمانة تكفل لهم صون حقوقهم والدفاع عنها في مواجهتها؟! وقد جاء بأحد أحكام الدائرة الإدارية أن: “الحرية الشخصية هي ملاك الحياة الانسانية كلها… والحق في الجنسية – باعتباره فرعا من فروع الحرية الشخصية – حق مقرر قانونا لا يجوز مصادرته دون علة ولا مناهضته دون مسوغ، ولا يجوز الحد منه أو انتقاصه إلا لمصلحة عامة في حدود القوانين واللوائح ودون ما تعسف أو انحراف في استعمال السلطة وقد كفلها الدستور والقانون، وقرر لها من الضمانات ما تسمو به عن المآرب الشخصية وتنأى به عن الهوى وتكفل لأبناء البلاد جميعا تمتعهم بذلك الحق، وهي لا تقبل من القيود إلا ما كان يهدف منها للخير المشترك للكافة ورعاية الصالح العام.”، وما قرره الحكم على نحو ما تقدم يفترض أنه ينطبق على قرارات سحب الجنسية كما ينطبق على قرارات اسقاطها لاتحد العلة في الأمرين إذ لا فرق بينهما في هذا المجال، ولأن الدستور قد كفل لهما ذات الدرجة من الحماية، وعليه فلا وجه ولا سند يدعم التفريق بينهما في مجال الرقابة القضائية.
ولا نحسب أن المشرع بوضعه للنص المشار إليه (نص الفقرة (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 التي يحتج بها أنصار الرأي المشار إليه) قد أراد تحصين قرارات اسقاط وسحب الجنسية وحجب القضاء عن حقه – بل وواجبه – في الرقابة عليها، خاصة وأن المادة (27) من الدستور (والتي جاء ترتيبها الأول في الباب الثالث منه وهو الباب المتعلق بالحقوق والواجبات العامة، بما يكشف عن أهميتها وخطورة الموضوع الذي تتناوله، بما أهلها ليس لأن توضع في الدستور باعتباره الوثيقة القانونية الأسمى فحسب، بل لأن تكون أول ما يرد في بابه الخاص بالحقوق العامة) قد نصت – وبشكل واضح – على أن: “الجنسية الكويتية يحددها القانون. ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون.”
وهو ما يعني أن قرارات السحب والإسقاط يجب أن تكون متسقة مع القانون ومتوافقة مع نصوصه دون انحراف عنه أو خروج عن مقتضياته، ولا ضمانة لصدور هذه القرارات على النحو المشار إليه ما لم تتحقق للأفراد ضمانة الرقابة القضائية عليها وانعقاد اختصاص القضاء بفحصها والنظر في موضوعها ليتبين حقيقتها ومدى إلتزامها بحدود المشروعية المفروضة على جهة الإدارة بنص الدستور.
يؤكد ذلك ويدلل عليه أن المرسوم رقم 15/1959 بقانون الجنسية قد جعل قرارات منح الجنسية (المكتسبة أو بالتجنيس) أمر جوازي لجهة الإدارة تجريه في نطاق السلطة التقديرية لها بحسب ما تراه محققا للمصلحة العامة (باستثناء نص المادة 3 التي قررت حق اكتساب الجنسية لمن ولد لأبوين مجهولين)، أما فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بسحب واسقاط الجنسية فقد قرر القانون بشأنها شروط وأوضاع وضوابط محددة تحديدا دقيقا لا يجوز الخروج عليها أو تجاوزها في اتخاذ مثل هذه القرارات. ولا يمكن التحقق من التزام الإدارة بهذه الشروط وتلك الضوابط إلا بإعمال رقابة المشروعية عليها، وإلا تحول النص الدستوري المشار إليه، وكذلك نصوص المرسوم رقم 15/1959 بقانون الجنسية التي قررت أوضاع وشروطا محددة لسحب واسقاط الجنسية – والتي كانت الغاية منها جميعا إضفاء الحماية القانونية لحقوق الأفراد المخاطبين بها وإلزام الإدارة وتقييد سلطتها بموجباتها ومتطلباتها – لغوا لا أثر له على أرض الواقع طالما سلمنا بأن تلك القرارات تتمتع بالحصانة المانعة من رقابة القضاء عليها.
إذ كيف يقرر الدستور عدم جواز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون، ويأتي القانون – استجابة للخطاب الدستوري – ليضع الشروط والضوابط اللازم توافرها لاتخاذ مثل هذه القرار، ثم تنتفي بعد ذلك ضمانة الرقابة القضائية عليها، ويترك الأمر بشأنها رهين بإرادة الإدارة دون معقب عليها، أليس في ذلك إهدار لنص الدستور ونصوص قانون الجنسية، أو في الحد الأدنى انحرافا عن التفسير الذي ينسجم مع المنطق القانوني السليم لمجموع تلك النصوص؟!
ذلك أن التفسير الذي ينسجم مع المنطق القانوني السليم يفترض أن يأخذ بالاعتبار كل النصوص التي تتناول المسألة الواحدة ويعمل على صيرورة التوفيق بينها في التطبيق بما يؤدي إلى إعمالها مجتمعة دون إهدار أي منها.
وحيث أنه إذا تفرقت أوجه الرأي في إعمال النصوص المتعددة التي تتناول المسألة الواحدة وفي تفسيرها بما يحقق غاية المشرع منها، فإن المحكمة تجنح في ذلك للأخذ بما ينتصر للحق والعدل والمساواة والحرية ويرسخ مقتضياتها، وبما ينحاز لدور وواجب القضاء في النظر بأعمال الإدارة وبسط رقابة المشروعية على قراراتها.
وحيث أن التفسير القانوني الأقرب إلى ترسيخ العدالة وارساء قاعدة المشروعية وإلى المحافظة على حقوق وحريات الناس والذي ينسجم مع المنطق القانوني السليم في إعمال النصين – الدستوري والقانوني – على النحو الذي يحقق الغاية منهما، يقودنا للقول – دون شك أو وجل أو تردد – إلى أن المنع الوارد في نص الفقرة (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، يفترض أن ينصرف لقرارات المنح والمنع دون قرارات السحب والإسقاط، بعد أن تعلقت بهذه القرارات الأخيرة حقوق ومصائر من يحملون الجنسية واستقرت على أساسها أوضاعهم وترتبت عليها كل تفاصيل حياتهم في الحاضر والمستقبل.
ذلك أن عدم تفسير وإعمال تلك النصوص على الوجه المتقدم يعني تعطيل وإهدار بعضها من ناحية، وعدم تحقق أبسط الضمانات اللازمة للمواطنين في عيشهم وأهم ما يمس حياتهم حاضرا ومستقبلا من ناحية أخرى، وهو ما يهدد كيان كل فرد من أفراد المجتمع ويجعل حياتهم أبعد ما تكون عن الاستقرار بعد أن يترسخ في ذهن وعقل كل منهم أنه قد يكون عرضة – في أي وقت في أي وقت من الأوقات ولأي سبب من الأسباب – لمثل هذه القرارات التي تسقط معها كل حقوقه كمواطن، ولن يجد له بعد ذلك في القضاء ذلك الركن الشديد الذي يأوي إليه، والملاذ الآمن الذي يحميه، والملجأ الحصين الذي يعصمه.
وعليه فإن اقران نص المادة (27) من الدستور ونصوص المرسوم رقم 15/1959 بقانون الجنسية بنص الفقرة (خامسا) من المادة (1) من قانون إنشاء الدائرة الإدارية ومحاولة تفسيرها كلها معا – في إطار من الفهم القانوني السليم الذي يحقق المصلحة العامة – سعيا لإعمالها جميعا دون تعطيل أو إهدار لأي منهما – وبما يلبي غاية كل من المشرع الدستوري والمشرع العادي – يؤدي إلى القول بأن المنع الوارد بالقانون إنما قصد به قرارات المنح أو المنع دون قرارات السحب والإسقاط، وذلك انسجاما مع القواعد المستقرة في التضييق من نطاق الإستثناءات التي ترد في القانون، وانحيازا لمبادئ الحرية والعدالة وحق الفرد في اللجوء للقضاء دفاعا عن حقه، وواجب القضاء في التصدي لأعمال وقرارات الإدارة وإعمال رقابته عليها.
القسم الثاني: البحث في مدى دستورية نص الفقرة (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية:
إن ما سبق بيانه في القسم الأول كان محاولة لقراءة وتفسير نص الفقرة (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية، وذلك في إطار باقي النصوص التي تتناول مسائل الجنسية للتوفيق فيما بينها في التطبيق بما يؤدي إلى إعمالها مجتمعة دون تعطيل أو إهدار أي منها، طالما بقي هذا النص قائما، وذلك لتخفيف القيد الذي يرى البعض أن هذا النص يفرضه على المحكمة مانعا إياها من ممارسة اختصاصاتها في الرقابة على القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية.
ونبحث في الفقرات التالية مدى دستورية هذا النص وذلك على ضوء آراء الفقه وأحكام المحكمة الدستورية، ونقدم لذلك بالتمهيد التالي:
تمهيد:
إن القانون لا يكون غير دستوري إلا إذا خالف نصا دستوريا قائما أو خرج على روحه ومقتضاه. ومرد ذلك إلى أن الدستور – وهو القانون الأعلى فيما يقرره – لا يجوز أن تهدره أية أداة أدنى منه.
ولما كان حق الأفراد في التقاضي هو حق أصيل باعتباره عماد الحريات جميعا، إذ بدونه يستحيل أن يأمنوا على حرياتهم أو يردوا الاعتداء عليها، وحاجة الأفراد إلى هذا الحق هي حاجة مستمرة ومتزايدة سيما بعد أن قوى تدخل الدولة والتشريع في تنظيم شئون الأفراد.
وبناء عليه صار من المسلم به كأصل غير قابل للجدل أن لكل انسان الحق في المطالبة بحقه والذود عنه وحمايته وحق الدفاع عنه بالتقاضي بشأنه. وهذا الحق مستمد من المبادئ الأولية للجماعة منذ وجدت ولم يخل دستور من دساتير العالم من النص عليه وتوكيده. وكل مصادرة لهذا الحق تقع باطلة وغير مشروعة ومنافية للمبادئ العليا لحقوق الانسان ومخالفة للأصول الدستورية وقواعدها العامة. واعفاء أية سلطة عامة اعفاء مطلقا من كل مسئولية تتحقق فعلا في جانبها من شأنه أن يخل اخلالا تاما بحقوق الأفراد في الحرية والمساواة في التكاليف والواجبات، وهي من المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور… ومن ثم فإن القانون إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة في التدابير والقرارات التي تصدرها السلطة يكون قد خالف أحكام الدستور.
ذلك أن حرمان الناس من اللجوء للقضاء من شأنه الاخلال بحقوقهم. واحترام المشروعية هو حق للمواطن، وبالتالي يجب على الإدارة أن تعاملهم على مقتضى مبادئ المشروعية، ومن ثم فإن اغلاق سبيل الطعن هو بمثابة منح الإدارة حق التحرر من قيود القانون، وهو ما لا ينسجم مع نصوص الدستور.
وقد استقر الرأي الراجح في الفقه على أن حرمان الأفراد من حق التقاضي – سواء بحظر حق الطعن مع بقاء حق التعويض قائما، أم الاثنين معا – هو مسلك غير دستوري، مما يتعين إدانته، نظرا لما يمثله من اعتداء على حق التقاضي الذي كفله الدستور.
وحيث أن الأصل المسلم به – على نحو ما تقدم – أن لكل انسان المطالبة بحقه والدفاع عنه والتقاضي بشأنه، ولما كان القرار الإداري الذي يصدر على خلاف القانون قد يكون من شأنه أن يعطل حقا للمواطن يضمنه الدستور، وعليه فكيف يمكن إعمال هذا الأصل إذا حرمنا المواطن المعتدى عليه من طلب إلغاء القرار المعيب.
ويبقى القول أن المساس بحق التقاضي بانتقاصه أو بإهداره بالنسبة لمنازعات معينة، لا يعد عدوانا على حقوق المواطنين فحسب، وإنما يعد كذلك اعتداء على سلطة القضاء بالانتقاص منها واقتطاع جزء من ولايته وحرمانه من مباشرة اختصاصاته الدستورية، حال أن المشرع لا يملك وضع أي قيد على ولاية القضاء المقررة بالنصوص الدستورية.
وحيث أن السلطة القضائية تستمد سلطانها من الدستور، وتملك بموجب الولاية المقررة لها أن ترد أي اعتداء على أحكام الدستور من أية هيئة في الدولة.
وبناء على ما تقدم نفصل في هذا القسم أوجه عدم دستورية نص الفقرة (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية، وذلك فيما تضمنته من عدم اختصاصها في القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية، كما نستعرض في هذا الشأن موقف بعض فقهاء القانون الدستوري في الكويت من هذا النص، وموقف المحكمة الدستورية الكويتية من النصوص المانعة لحق التقاضي.
أولا: أوجه مخالفة نص الفقرة (خامسا) لبعض مواد الدستور:
إن نص الفقرة المشار إليها يأتي مخالفا لحشد كبير من مواد الدستور – وقد ذكرنا بعضها في القسم الأول من هذه الدراسة – ونقصر بحثنا على تناول بعضها بشيء من التفصيل، وهي نصوص المواد: (27)، (29)، (50)، (53)، (162)، (166)، (169) من الدستور الكويتي، وذلك على التفصيل التالي:
نص المادة (27) من الدستور:
“الجنسية الكويتية يحددها القانون. ولا يجوز اسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون.”
وحيث أن الدستور عندما ينص على الحقوق ويكفلها فإن مؤدى ذلك أن تتمتع هذه الحقوق بالحماية القانونية التي تتمثل في تمكين الأفراد من التقاضي بشأنها، وتقرير الدستور لهذه الحقوق يعد خطابا موجها للمشرع العادي بضرورة احترامها وكفالة أصلها، فإذا نص الدستور بعد ذلك على منح المشرع تنظيم تلك الحقوق، فهو تنظيم مقيد حتما بضرورة كفالة الحق وصيانته دون الاعتداء عليه وإهدار أصله.
فكفالة الدستور لحق معناه تمتعه بالحماية القانونية التي تعني حق الفرد في الالتجاء إلى القضاء للمطالبة بحقه، فالأمور جرت على أن يكفل الدستور الحق ويترك تنظيم هذا الحق للقانون بحيث يتعين على القانون في تنظيمه لهذا الحق ألا يهدره وإلا صار قانونا غير دستوري.
وإذا كان نص المادة (27) الواردة كأول مادة في باب الحقوق والواجبات العامة في الدستور قد قررت أن الجنسية حق للمواطن وأنه لا يجوز اسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون.
ولما كانت الضمانة الأساسية لكفالة هذا الحق ومنع تجاوز السلطة لحدود القانون في شأن سحب واسقاط الجنسية لا تتأتى إلا بكفالة حق التقاضي حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على قرارات الاسقاط أو السحب والنظر في مشروعيتها ومدى التزام جهة الإدارة في إصدارها بحدود القانون.
ولما كان النص المانع من التقاضي يترتب عليه تجريد الحق الموضوعي من وسيلة حمايته حماية فعالة… حال أن تجريد الحق من وسيلة اقتضائه هو إهدار للقانون ذاته بتجريد الحق من الحماية القضائية المقررة له، وهذا التجريد يخل بدوره بقواعد الدستور وبالحقوق التي كفلها.
وإذ أن ضمان هذا الحق منوط بالفصل في النزاع من جانب سلطة محايدة ومستقلة هي السلطة القضائية… حيث لا معنى لتقرير حق ما وحجب الوسيلة القضائية التي يمكنها حمايته، باعتبار أن ذلك قد يكون من شأنه أن يجعل تقرير هذا الحق من قبيل العبث.
وحيث أن نص الفقرة (خامسا) المشار إليه قد جرد حق الأفراد ممن اسقطت أو سحبت جنسيتهم من وسيلة حمايته باللجوء للقضاء، حاجبا في الوقت ذاته المحكمة عن النظر في هذه القرارات ومانعا إياها من بسط رقابتها عليها بإخراجه لها من دائرة اختصاصها، وبالتالي فإنه يكون مخالف لنص المادة (27) من الدستور على النحو السابق بيانه.
نص المادة (29) من الدستور:
“الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.”
حيث أن حرمان بعض الأشخاص من الالتجاء إلى القضاء لحماية حقوقهم يعتبر اخلالا بمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من الأشخاص الذين كفل لهم القانون هذا الحق دون عقبات أو موانع… لأن القانون هو قاعدة عامة مجردة، وإن خاصية التعميم في القاعدة القانونية معناها انطباق القاعدة القانونية على كل من يتحقق فيه المناط الذي جعلته القاعدة أساسا لترتيب الآثار القانونية… و عمومية القاعدة القانونية قد تتسع فتشمل كل من يوجد على إقليم الدولة، وقد تضيق فتشمل طائفة معينة، وقد تزداد ضيقا حتى تنحصر في شخص واحد، والمدى الذي تنبسط إليه خاصية العمومية أو تنكمش إليه مرده إلى نوع المناط الذي تحدده القاعدة القانونية من حيث شموله كل الأشخاص أو بعضهم، ولذلك كان تحديد المناط في كل قاعدة قانونية هو الذي يحدد لنا ما إذا كانت المساواة متحققه أم لا في حالة معينة يقوم عليها النزاع… ولما كان المناط هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب عليه تشريع الحكم. والحكم هو الأثر الذي تقتضيه النصوص الشرعية… وعليه يكون المناط في نشوء حق التقاضي هو قيام المنازعة في أحد الحقوق. فحيثما قام نزاع على حق ما تحقق المناط الذي حدده الشارع لنشوء الحق في التقاضي. وواضح أن هذا المناط ليس مقصورا على أفراد طائفة معينة بل يشمل الأشخاص جميعا على اقليم الدولة (وطنيين وأجانب). ولما كان هذا الحق خاضعا لقاعدة المساواة التي قررها الدستور لذلك يتمتع به (أي بحق التقاضي) كل من تحقق فيه مناطه وهو قيام منازعة على حق ما من حقوقه.. ومرد هذا من ناحية التأصيل المنطقي أن حق الإنسان في الانتصاف لنفسه من الظلم هو حق لصيق بذاته باعتباره إنسانا ولا يمكن أن نفرق بين فرد وآخر من هذه الناحية وإلا أهدرنا آدميته إهدارا جزئيا… وعلى ذلك تجب المساواة في حق التقاضي بين جميع الأفراد بغض النظر عن انتمائهم إلى طوائف متعددة لأن هذا الانتماء مقطوع الصلة بمناط نشوء الحق في التقاضي.
إذ ليس المقصود بالمساواة هو عدم التفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة، بل المقصود هو عدم التفرقة بين الأفراد جميعا إذا تماثلت حقوقهم المعتدى عليها وتلك التي يختص بها القضاء.
وعلى ذلك استقرت أحكام المحكمة الدستورية الكويتية على القول حيث: “تضمن الدستور النص في المادة (29) منه على أن الناس لدى القانون سواء، وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولما كان حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفل الدستور المساواة فيها بين الناس أجمعين، فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه وهو قيام المنازعة على حق من حقوق أفرادها ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من الأفراد الذين لم يحرموا من هذا الحق…”
ولما كانت التطبيقات القضائية في إعمال نص الفقرة (خامسا) المشار إليه – من خلال استبعادها لقرارات سحب الجنسية من دائرة الرقابة القضائية عليها – قد أخل بمبدأ المساواة باستبعاده وحرمانه طائفة من الناس من حق التقاضي حال قيام المنازعة في أحد الحقوق المتعلقة بها، وعليه فإنه يكون مخالف لنص المادة (29) من الدستور، وذلك على نحو ما تم تفصيله سلفا.
نصوص المواد (50)، (53) من الدستور:
تنص المادة (50) من الدستور على أن: “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور. ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في هذا الدستور.”
حيث أن السلطة القضائية هي سلطة أصلية تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتستمد وجودها وكيانها واختصاصها من الدستور ذاته لا من التشريع، وقد أناط بها الدستور وحدها أمر العدالة مستقلة عن باقي السلطات، ومؤدى ذلك أن المشرع لا يملك بتشريع منه إهدار ولاية تلك السلطة جزئيا أو كليا.
وعليه فإن من أهم النتائج المترتبة على الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات، واعتبار السلطة القضائية سلطة مستقلة، تقف على قدم المساواة مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، أن تمتد ولاية هذه السلطة للفصل في كافة المنازعات، خاصة تلك التي أدخلها الدستور في عموم ولايتها واختصاصه، فإذا صدر قانون بعد ذلك تضمن استثناء بعض تصرفات وقرارات السلطة التنفيذية ومنع القضاء من بسط رقابته عليها، فإنه يكون غير دستور، إذ أن ما يقرره الدستور لا يجوز أن ينقضه أو ينتقص منه القانون.
ولا شك بأن انتقاص المشرع لاختصاص القضاء عن طريق منعه من ولايته نظر بعض المنازعات يعني تقيده لحق التقاضي، والاعتداء على هذا الحق هو اعتداء في الوقت نفسه على القضاء، عندما يحرمه من مباشرة وظيفته في حل المنازعات، ويمنع الأفراد من الالتجاء إلى قاضيهم الطبيعي.
وحيث أنه لا يتأتى للقضاء أن يباشر وظيفته التي أسندها إليه الدستور إلا إذا تمكن الأفراد من ممارسة وسيلة المطالبة القضائية، ما دام أن القضاء لا يختص بإنزال كلمة القانون إلا في المنازعات التي ترفع إليه من أصحاب الشأن. وينبني على ذلك أن كل تقييد لوسيلة المطالبة القضائية هو في حقيقته تقييد لوظيفة القضاء في مزاولة اختصاصه، بما ينطوي عليه ذلك من تعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، وإهدار للحقوق ذاتها التي كفلها الدستور.
وحيث تنص المادة (53) من الدستور على أن: “السلطة القضائية تتولاها المحاكم في حدود الدستور”
وهو ما يعني أن ولاية المحاكم تشمل كل ما جعله الدستور في نطاق اختصاصها، وحيث أن الدستور قد أطلق اختصاص المحاكم ليكون شاملا لولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة للقرارات الإدارية المخالفة للقانون – على نحو ما جاء بنص المادة (169) منه التي سيرد الحديث عنها لاحقا – وما يطلقه الدستور لا يملك أن يقيده القانون، وبالتالي فلا يجوز أن ينتقص من هذه الولاية أو يحد من نطاقها أو يستثنى منها بعض القرارات بأداة أدنى من الدستور ما دام لم يرد في هذا الأخير نص خاص يفوضها بهذا التقييد أو التحديد أو الاستثناء.
ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة (164) من الدستور والتي جرى نصها على أن: “يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها…”
ذلك أن عبارة “يرتب القانون المحاكم” تنصرف إلى تخويل الشارع اختصاصا في انشاء هذه الجهات وتنظيمها وفقا لما يقضي به الصالح العام… أما عبارة “يبين وظائفها واختصاصاتها” فتنسحب إلى توزيع العمل بين مختلف هذه الجهات القضائية التي رتبها القانون على أساس تقسيم العمل، فيسند إلى كل من أنواع الجهات القضائية المنازعات التي تتفق وطبيعة عمله، أو تلك التي ينص على اختصاصه به، ولكن لا يجوز للسلطة التشريعية بأي حال من الأحوال أن تخرج عن نطاق الدستور، فتتناول اختصاص السلطة القضائية بالتعديل، وإلا كان ذلك بمثابة تعطيل لوظيفة السلطة القضائية، وهي سلطة أنشأها الدستور وأسند إليها وحدها أمر العدالة مستقلة عن السلطات الأخرى، فمثل هذا الخروج يعتبر اعتداء من جانب السلطة التشريعية على السلطة القضائية لا يتفق ومبدأ الفصل بين السلطات.
وعليه فلا يجوز أن يتخذ توزيع الاختصاص بين جهات القضاء المختلفة وسيلة لعزل (السلطة القضائية) عن نظر نزاع معين، إذ يجب أن يكون مجموع الاختصاصات الموزعة على جهات التقاضي المختلفة مساويا لاختصاص (السلطة القضائية) بالفصل في (كافة القضايا) لا أقل منها، فإن هو قل عنها دل ذلك على أن الفرق بينهما هو ما عزل فيه القضاء عن مزاولة اختصاصه الدستوري الأصيل.
ولما كان ما تقدم وكان المشرع في نص الفقرة (خامسا) المشار إليها قد قيد وظيفة القضاء وانتقص من اختصاصاته وحجب المحكمة عن النظر في القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية مخرجا إياها من نطاق ولايتها دون سند من الدستور، فإنه يكون بذلك قد خالف نصوص المواد (50)، (53) منه على نحو ما سبق شرحه.
نص المادة (162) من الدستور:
“شرف القضاء، ونزاهة القضاة، وعدلهم، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات.”
والنص المتقدم إذ جعل القضاء وعدل القضاة “ضمان للحقوق والحريات” لم يرد في الدستور عبثا، والمؤدى اللازم لهذا الأمر أنه كلما تعلق النزاع بالحقوق والحريات فليس للقضاء التخلي عن اختصاصه وواجبه الدستوري في التصدي للمسألة والأمر المعروض وفحص مشروعية التصرفات والقرارات الصادرة من السلطة بشأنها والتي تمس أي من هذه الحقوق والحريات، مهما كانت طبيعتها ووصفها.
باعتبار أنه لا يمكن أن يكون القضاء ضامنا حقيقيا للحقوق والحريات في ظل منعه – أو امتناعه – عن بسط رقابته على بعض قرارات وتصرفات السلطة التنفيذية التي تمس حقوق وحريات الأفراد بشكل مباشر.
كما أن المتقاضي الذي يوصد دونه باب القضاء ويحال بينه وبين قاض ينصفه لا يكون قد حظي بأية عدالة، إذ أن إيصاد باب التقاضي في وجه نوع معين من الأقضية والمنازعات هو في ذاته إنكار للعدالة… وبعبارة مختصرة يعتبر اختصاص القضاء بنظر المنازعات والأقضية من النظام العام الدستوري، ومن ثم لا يجوز لتشريع عادي أن ينتقص من هذا الاختصاص بالنص على منع سماع الدعوى أو على اعتبار القرار الإداري غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية كانت.
وحيث أن حرمان الأفراد من الطعن على القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية ومنع المحاكم من بسط رقابتها عليها – وهي من المسائل التي لا تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم فحسب بل إنها تتجاوز ذلك بارتباطها ارتباطا لا يقبل الانفصام بمصائرهم وهوياتهم وحاضرهم ومستقبلهم – يؤدي إلى نزع كل ضمانة حقيقة لهم في مواجهة السلطة واجراءاتها وقراراتها من جراء تجريدهم من كل حماية قضائية يفترض أنها مكفولة لهم وأنها ضمانتهم بنص الدستور.
وعليه يتبين مخالفة نص الفقرة (خامسا) المشار إليها لنص المادة (162) من الدستور، إذ لا يستقيم أن يكون “القضاء وعدل القضاة ضامنا للحقوق والحريات” في ظل تجريد الأفراد من هذه الضمانة في مواجهة السلطة، وفي ظل حجب – أو احتجاب – القضاء عن النظر في القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية والتي قرر الدستور عدم جواز اسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون، على النحو الثابت بالمادة (27) منه والمشار إليها سلفا.
نص المادة (166) من الدستور:
“حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق”
حيث أقام الدستور من حصانة القضاء واستقلاله، ضمانين أساسين لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، فقد أضحى لازما – وحق التقاضي هو المدخل إلى الحماية – أن يكون هذا الحق مكفولا بنص صريح بالدستور، كي لا تنعزل حقوق الأفراد وحرياتهم عن وسائل حمايتها، بل تكون معززة بها، وتقارنها، لضمان فاعليتها.
ذلك أن حق التقاضي حق أصيل، مستمد من الأصول الدستورية، ومن ثم لا يجوز لأي سلطة أن تقيده، ويستوي في ذلك أن يكون القيد الوارد كليا أو جزئيا.
وعليه فلا يجوز أن يهدر أو يقيد أو يحرم أو ينتقص أو يستثني القانون ما كفله الدستور وقرره مطلقا دون قيد وكاملا دون نقصان وعاما دون استثناء.
كما أن الإحالة للقانون لبيان الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق لا تعني السماح للمشرع تحت ستار التنظيم أن يصادر الحق أو ينقصه أو يستثني منه (كمنع القضاء من التصدي للقرارات الإدارية إلغاء وتعويضا دون سند في الدستور).
وكفالة الدستور لحق التقاضي يأتي تأكيدا منه على حق الأفراد في اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي ويمنع إقامة الحواجز التي تحول بينهم، بحيث يكون الحق متمتعا بالحماية القانونية التي تقف عند حد تنظيمه دون حجبه – جزئيا أو كليا – أو الانتقاص منه وإلا صار القانون غير دستوري، باعتبار أن المشرع في تنظيمه لهذا الحق مقيد حتماً بضرورة كفالته وصيانته كاملا دون الاعتداء عليه وإهدار أصله أو الاستثناء منه.
وحيث أن كل مصادرة لحق التقاضي تقع باطلة وغير مشروعة ومنافية للأصول الدستورية، إذ لا يجوز أن تتناول جهة الإدارة حقوق الناس بما يصدر عنها من قرارات وتصرفات ويحرم أصحاب الحقوق في الوقت ذاته من الطعن عليها.
ولما كان حرمان الفرد من الطعن بالإلغاء ومن طلب التعويض في ذات الوقت يعد في حقيقته مصادرة مطلقة لحق التقاضي.
وحيث أن نص الفقرة (خامسا) المشار إليها قد حرم الأفراد من حق الطعن على القرارات الإدارية المتعلقة بمسائل الجنسية وذلك باستثنائها من نطاق اختصاص الدائرة لإدارية، وهو ما يكون معه مخالف لنص المادة (166) من الدستور على النحو السابق بيانه.
نص المادة (169) من الدستور:
“ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري شاملا ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة إلى القرارات الإدارية المخالفة للقانون.”
ويبين النص المشار إليه أن الدستور قد حمل القضاء الإداري مسئولية وواجب الرقابة على القرارات الإدارية المخالفة للقانون وجعلها ضمن دائرة إختصاصه ومشمولة بنطاق ولايته إلغاء وتعويضا.
وقد جاء النص عاما مطلقا دون أي قيد أو استثناء يسمح بتحصين أي قرار إداري أو يمنع القضاء من التصدي له.
وعليه فلا يملك المشرع نفسه دون أن يكون معتديا على سلطة القضاء – إذ يعتدي على حق التقاضي – اخراج منازعات بعينها من ولاية القضاء أو تحصين تصرف من التصرفات من رقابته. فإذا هو اخرج منازعة بعينها إنتقص من سلطة القضاء، وإذا هو حصن تصرفا من التصرفات التي تضر بحق من حقوق الأفراد اعتدى على حق التقاضي، وهو لا يملك أيا من الأمرين.
وعليه فإن تحصين القرارات المتعلقة بمسائل الجنسية واستثنائها من الرقابة القضائية، يقع بالمخالفة للنص الدستوري المشار إليه، لما فيه من انتقاص لاختصاص القضاء ومصادرة – أو في الحد الأدنى تقييد – لحق التقاضي.
ولما كان الدستور قد نص على الحقوق وكفلها ووضع الضمانات المقررة لها، ومؤدى ذلك أن تتمتع هذه الحقوق بالحماية القانونية التي تتمثل في تمكين الأفراد من التقاضي بشأنها، وتقرير الدستور لهذه الحقوق يعد خطاباً موجهاً إلى المشرع العادي بضرورة احترامها وكفالة أصلها… فإذا نص الدستور بعد ذلك على منح المشرع سلطة تنظيم تلك الحقوق فهو تنظيم مقيد حتماً بضرورة كفالة الحق وصيانته دون الاعتداء عليه وإهدار أصله.
لما كان ما تقدم وكان نص الفقرة (خامسا) المشار إليها قد استثنى القرارات الإدارية المتعلقة بمسائل الجنسية من الاختصاص المقرر للدائرة الإدارية – على نحو ما سبق شرحه – فإنه يكون مخالفا لنص المادة (169) من الدستور التي جعلت اختصاص الدائرة الإدارية شاملا ولاية الإلغاء وولاية التعويض بالنسبة لجميع القرارات الإدارية المخالفة للقانون دون استثناء.
ثانيا: موقف فقهاء القانون الدستوري من نص الفقرة (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية:
وأمام وضوح النصوص الدستورية المشار إليها سلفا، لم يجد شراح القانون الدستوري في الكويت غضاضة من الحكم علي النص التشريعي المشار إليه بأنه مخالفة للدستور، وقد انعقد اجماعهم على ذلك، ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر:
الأستاذ الدكتور عثمان عبد الملك الصالح – رحمه الله – الذي يرى: “أن ولاية القضاء الإداري وفقا لما يقضي به نص المادة (169) من الدستور هي ولاية كاملة تشمل قضاء الإلغاء والتعويض، كما أنها ولاية عامة تشمل كافة المنازعات ذات الطبيعة الإدارية… هذا فضلا عن أن عبارات هذا النص قد جاءت بصورة عامة مطلقة وبدون قيد أو تحديد. مما يعني أنه لا يجوز للقانون الذي يصدر بانشاء تلك الغرفة أو المحكمة أن يتضمن أحكاما تنتقص من ولايتها العامة الكاملة… والحقيقة أن وضع نص المادة (169) من الدستور إلى جانب باقي نصوص الدستور وعلى الأخص المواد 6، 52، 166 منه وتفسيرها تفسيرا شموليا سوف يبين لنا بوضوح أن النظام الدستوري الكويتي لا مجال فيه للتشريعات المانعة من التقاضي أو النصوص المحصنة لبعض القرارات الإدارية من الطعن فيها أمام القضاء، والتي تمنعه من أن يمارس عليها ولاية الإلغاء أو التعويض.”
ويضيف الأستاذ الدكتور عثمان عبد الملك بالقول: “أن صياغة نص المادة (169) من الدستور يفيد بيقين أن ولاية الغرفة أو الدائرة الإدارية هي ولاية عامة تشمل كافة المنازعات الإدارية على اطلاقها وإذا كان الأمر كذلك فإن نصوص قانون إنشاء الدائرة الإدارية التي حددت اختصاصاتها تحديدا شديدا تنطوي على مخالفة لصريح نص المادة (169) من الدستور الذي أطلق اختصاص الدائرة الإدارية وجعله شاملا لكافة المنازعات الإدارية دون قيد أو شرط، مما لا يتأتى معه تخصيصه بغير مخصص؛ نزولاً على القاعدة الأصولية العامة في التفسير، والتي تقضي بأن يؤخذ العام علي إطلاقه ما لم يوجد ما يخصصه. والمشرع الدستوري لم يفوض المشرع العادي في وضع نصوص تحد أو تنتقص من الولاية الكاملة للدائرة الإدارية بالنظر في المنازعات الإدارية على اطلاقها دون قيد أو استثناء. وعلى أساس من ذلك نرى عدم دستورية هذا النهج الذي اتبعه المشرع العادي في بيان اختصاص الدائرة الإدارية.”
ويعلق الأستاذ الدكتور عادل الطبطبائي على ذلك النص بالقول: “ويتضح من ذلك النص أن المشرع الكويتي لا يزال يحصن بعض أنواع القرارات الإدارية ويمنع المحاكم من التصدي لها بالإلغاء، وهي القرارات الخاصة في مسائل الجنسية…، ولا شك أن هذا النص تحيطه الشبهات الدستورية من كل جانب لأن المشرع الدستوري عندما نص في المادة (169) من الدستور على إنشاء محكمة خاصة أو غرفة بنظر المنازعات الإدارية منحها ولاية إلغاء القرارات الإدارية ويترتب على ذلك أن المشرع العادي لا يجوز له أن يخالف النص الصريح ويستثني منه طائفة من القرارات الإدارية ويحصنها من رقابة القضاء.”
ويضيف: “نخلص من ذلك أن حظر حق التقاضي بشق منه – دعوى الإلغاء، أو بشقيه معا – دعوى الإلغاء والتعويض – هو حظر غير مشروع ومخالف للدستور.”
في حين يذهب الأستاذ الدكتور محمد المقاطع عند تعليقه علي تحصين قرارات سحب الجنسية من رقابة القضاء إلي أنه: “من السبل التي يملك الفرد أن يلجأ إليها للمنازعة في قرارات سحب الجنسية هو أن يطعن بها قضائياً – إلا أنه من البين أن قانون المحكمة الإدارية قد حرم الأفراد من مثل هذا الحق وفقاً لنص مادته الأولي – مما يعني تعذر الطعن القضائي لأن القرارات الخاصة بمسائل الجنسية محصنة من الطعن القضائي بحكم النص القانوني – ولا شك أن هذا مسلك خاطئ فيه مخالفة للدستور.”
وما تقدم من آراء يكشف بشكل واضح عن موقف الفقه تجاه نص الفقرة (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية، وما انعقد من اجماع الفقهاء على عدم دستوريتها.
ثالثا: موقف المحكمة الدستورية في الكويت من النصوص المانعة لحق التقاضي:
حيث سبق للمحكمة الدستورية الكويتية في حكمها الصادر في الطعن رقم 14 لسنة 2006 بجلسة 1/4/2007 أن تعرضت لأحد النصوص المانعة من نظر الدعوى منزلة المبادئ السابق بيانها عليه لتنتهي بقضائها إلى عدم دستوريته، وهو نص المادة (17) من المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1987 بشأن التعليم العام والتي تضمنت قيدا على حق التقاضي بالنص على أنه: “لا تخضع قرارات الوزارة المتعلقة بإجراءات ونتائج الامتحانات للطعن أمام القضاء”
حيث جاء بقضاء المحكمة المشار إليه: “إن مبنى النعي على نص هذه المادة أنه قد انطوى على اخلال بحق التقاضي الذي كفله الدستور في المادة (166) منه… وحيث إن هذه المحكمة لدى إعمال ولايتها وممارسة اختصاصها في تقرير قيام المخالفة الدستورية التي علقت بالنص التشريعي أو نفى هذه المخالفة، عليها في إطار ما وسده إليها الدستور وقانون إنشائها أن تقيم المخالفة الدستورية – إذا ما ثبتت صحتها – على ما يتصل بها من نصوص الدستور. لما كان ذلك، وكان من المسلم به – كأصل عام لا يدع مجالاً للجدل فيه – أنه لا يكفى تقرير الحقوق والحريات للأفراد دون أن يقرن ذلك بحقهم في المطالبة بها والذود عنها وحمايتها وحق الدفاع عنها بالتقاضي بشأنها، وأن هذا الحق إنما هو مستمد من المبادئ الأولية للجماعة منذ أن انتظمتها نظم وأوضاع قانونية وقد تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما لم يخل دستور من دساتير العالم من النص عليه وتوكيده، وبالتالي فإن كل مصادرة لحق التقاضي تقع باطلة، ومنافية لمبادئ حقوق الإنسان، ومخالفة للأصول الدستورية وقواعدها العامة. هذا وقد حرص الدستور الكويتي بالنص في المادة (166) منـه على كفالة حق التقاضي للناس كافة، كمبدأ دستوري أصيل، والمستفاد من هذا المبدأ هو حظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو تصرف أو أي قرار إداري تتخذه الجهة الإدارية في إطار مباشرتها لنشاطها العام من رقابة القضاء، وأنه وإن كان لا تناقض بين هذا الحق وبين جواز تنظيمه تشريعياً إلا أن ذلك مشروط بألا يتخذ المشرع من هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره هذا من ناحية، كما أنه من ناحية أخرى فقد تضمن الدستور النص في المادة (29) منه على أن الناس لدى القانون سواء، وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولما كان حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفل الدستور المساواة فيها بين الناس أجمعين، فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقق مناطه وهو قيام المنازعة على حق من حقوق أفرادها ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من الأفراد الذين لم يحرموا من هذا الحق، ولا ريب في أنه إذا حدد الدستور وسيلة معينة هي المطالبة القضائية للوصول إلى الحق تعين التزام هذه الوسيلة، ولا يجوز للسلطة التشريعية أن تهدرها، فالدستور وإذ أنشأ السلطة القضائية وأسند إليها الفصل في الخصومات القضائية وإقامة العدل بين الناس في حيادة وتجرد مستقلة عن باقي السلطات الأخرى، فإنه لا يتأتى للسلطة القضائية أن تباشر هذه الوظيفة التي أسندها إليها الدستور إلا إذا تمكن الأفراد من ممارسة وسيلة المطالبة القضائية، لاسيما وإنها لا تختص بإنزال حكم القانون إلا في منازعات ترفع إليها من أصحاب الشأن، وينبني على ذلك أن كل تقييد لوسيلة المطالبة القضائية هو في حقيقته تقييد لوظيفة السلطة القضائية في مزاولة اختصاصها، بما ينطوي عليه ذلك من تعارض مع مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في المادة (50) من الدستور، وإهدار للحقوق ذاتها التي كفلها الدستور، فضلاً عن أنه ليس من شأن النص في المادة (164) من الدستور على أن يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، والذي ينصرف إلى تخويل المشرع اختصاصاً في توزيع العمل بين المحاکم وتقاسيمه بحسب نوعه و طبيعته وما يرتبط بذلك من بيان لاختصاصاتها وفقاً لما يقتضيه صالح العمل ودواعي المصلحة العامة، ليس من شأن ذلك أن ينسحب إلى تخويل السلطة التشريعية في عزل القضاء عن ممارسة اختصاصه الأصيل بنظر الخصومات القضائية أو تعطيل وظيفة السلطة القضائية، أو حجب الوسيلة القضائية عن الأفراد التي يمكن من خلالها حماية حقوقهم وحرياتهم. وحيث إن قيام قضاء إداري يختص بنظر الخصومات الإدارية، مزود بولاية إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، وولاية التعويض عنها، هو ركن أساسي في النظام الدستوري، وقد تضمنه نص صريح في المادة (169) من الدستور، محدداً بذلك الوسيلة القضائية للمطالبة القضائية، دعما للضمانة الأصيلة التي يحققها للأفراد إذا تحيفت بهم تلك القرارات…”
ويضيف الحكم في أسبابه: “لما کان نص المادة (??) من القانون المشار إليه قد عصم هذه القرارات من الطعن فيها بالإلغاء، ومنع الأفراد بذلك من طلب الإنصاف، وأسبغ الحماية على تلك القرارات بقطع النظر عن مدى مشروعيتها، وأغلق باب المنازعة القضائية في شأنها بما يتيح لجهة الإدارة التحرر من قيود القانون والتزام أحكامه وضوابطه، وحصن هذه القرارات من رقابة القضاء الإداري عليها، في حين أنها رقابة تنبسط على القرارات الإدارية المطعون فيها – التنظيمية منها والفردية – استظهارا لمدى انضباطها داخل أطر الشرعية، وذلك بوزنها بميزان القانون ومقتضيات المشروعية التي تتمثل فيها المصلحة العامة ويتحقق بها استقرار النظام العام، فإذا تبين للقضاء الإداري استواء القرار صحيحاً أجازه وثبته على أصل صحته، أما إذا تبين له اختلال أحد أركانه أو مجاوزته مقتضيات المشروعية ألغاه وأزال أثاره،…”
ويستطرد الحكم في رده على المبررات القائلة بدستورية النص، أنه: “لا يتصور أن يكون سبيل ذلك هو بإغلاق طريق الطعن القضائي على هذه القرارات، أو أن المشرع قد قصد بذلك حماية أوضاع قد تكون غير مشروعة وتحصينها، إذ لا مصلحة عامة في ذلك، مما يغدو التذرع بهذه الاعتبارات لتقرير حكم هذا النص أمراً غير جائز…”
لينتهي الحكم إلى القول: “وترتيباً على ما تقدم، وإذ كان نص المادة (17) على ما سلف جميعه ينال من مبدأ فصل السلطات، ويخل بحق التقاضي، ويناقض مبدأ المساواة بما يصم هذا النص بمخالفته لأحكام المواد (??) و(5?) و(166) من الدستور، فمن ثم يتعين القضاء بعدم دستوريته.”
الخلاصة:
ومما تقدم جميعه، وما يستخلص من الأحكام والمبادئ القضائية المشار إليها، وما هو متحقق من إجماع فقهاء القانون الدستوري الكويتي، نجد أنها قد استقرت على عدم دستورية النصوص المانعة من حق التقاضي والحاجبة للمحكمة عن ممارسة اختصاصها بإعمال رقابة المشروعية على القرارات المخالفة للقانون، الأمر الذي يكون معه نص الفقرة (خامسا) من المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية قد جاء مخالفا للدستور ومتعارضاً مع نصوصه، وهو ما يستوجب ابطاله والإسراع بمعالجة ما ترتب على إعماله من آثار خطيرة، وذلك كفالة للأمن والطمأنينة في المجتمع ونفوس أفراده، وحفاظا على الحقوق والحريات، وحماية للعدالة التي هي حجر الزاوية في استقرار واستمرار أي مجتمع ودولة.
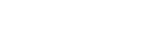




















أضف تعليق