في منتصف عام 2007 – إن لم تخن ذاكرتي “المزدحمة” – وردني خبر وفاة أحد الأصدقاء الذي كان يدرس معي في محافظة الإحساء، وافته منيّتة في السعودية بحادث مروري بالقرب من قرية “خريص” الواقعة في الطريق السريع الذي يربط الإحساء بالرياض، كان عائدًا إلى أهله القاطنين في منطقة الرياض.. لكن الموت كان له اقرب، حزنت كثيرًا لفراقه ودعوت الله له طويلًا ولأهله بالصبر والسلوان لفراقه.
بعد انتهاء دراستي في محافظة الإحساء والتي استمرت لعاميّن ونصف أتاني التعيين بنفس المنطقة، وفي كلا الفترتيّن “الدراسة و العمل” لا أذكر إني مررت يومًا على مكان حادثة صديقي هذا إلا وذكرته بدعوة علّها تسد شيئاً من عوزه.
لم تدم عزلة صديقي طويلاً حتى اصطف إلى جانبه رفقاءٌ جدد يشملهم دعائي كل ما مررت بمكان الحادث، وإن كانت أماكن وفاتهم مختلفة، إلا أن المكان الذي يذكرني بهم يكاد يكون واحداً، توفي نواف الحكمي ثم تبعه بعد فترة سعد السبيعي ثم عبدالعزيز الظاهري، ففجعت بوفاة عمّي ومن ثم والدة صديقي إياد، والقائمة في ازدياد، وفي كل مرة أدعوا لهم.. ولم أحاول تذكير نفسي بأن الرفيق القادم لهم قد يكون هو “عويّد السبيعي”.. على الرغم من استذكاري المتكرر لصديقي، إلا أن هذا الأمر لا يحرّك الكثير بداخلي “إذا استثنينا اللحظات الأولى من وفاته”.
تتوارد أخبار الوفيات في أوقات متعددة لكن دون ان يغيّر ذلك من نظرتي للموت او تلهفي للحياة أي شيء، ربما يأتي الحزن القصير على بعضهم وما إن يلبث فترة قصيرة حتى يزول، هل هو عيب الزمان.. أم أننا نعيب زماننا والعيب فينا؟ لماذا قست قلوبنا وأرخصت لأجل الدنيا كل شيء، حتى إن الموت الذي يهدم كُل لذة لم يعد يحرك فينا ما سكن بدواخلنا.. يا لقسوة قلوبنا وانشغالها.
بل إنني أذكر جيدًا حين كنت استمع للأغاني بشراهة، كيف كنت أتصرّف بـ”غباء مُطبق” وأنا اقترب من مكان حادث صديقي الذي توفي فيه، فأقوم بإغلاق الأغاني حتى إذا مررت به ودعوت له ولرفاقه.. انتظرت نصف ساعة أو يزيد قليلاً كي ابتعد عن المكان، ثم أعاود تشغيل تلك المعزوفات اللعينة.. ياااه، كم كنت ساذجًا حينها وأنا اتحايل على لهو نفسي وانشغالها بالدنيا وافتتانها بملذاتها، كم كنت ساذجًا وأنا اتحايل على نفسي بحزن بسيط “قد أتصنعه” وما يلبث أن يزول حين أتجاوز بقايا حطام مركبة ذلك الصديق.
لماذا تؤرقنا الحقائق؟ كل الحقائق؟ هل نعشق العيش في الوهم؟ لماذا لا نريد الخروج من دائرتنا الضيقة التي نسجها خيالنا وأتقنا العيش بداخلها؟ كثيرون هم أولئك الذين يفضّلون عيّش النعام، فيلجأون لدس رؤوسهم في تراب الدنيا ويتعامون عن كل الحقائق التي بين أيديهم، يتفننون بغمس أنفسهم في ملذات وشهوات وفتن الدنيا، و إن حاول أحدٌ إيقاضهم بُغية اخراجهم من غياهب السُخف، بدأ ركضهم في طريق “الشرعنة”.
شرعنة الشهوات وخلق الذرائع والأعذار الواهية لإقناع النفس ومن ثم إقناع الغير بأن كل تلك الممارسات منطقية وهي أمرٌ لابد منه، ليس بالضرورة أن تكون الشهوة او الملذات هنا حكرًا على الجنس و دوائره، فالحاكم المستبد مفتونٌ بملكه، والمدير المتكبّر مفتونٌ بمنصبه، والمرأة المتبرجة مفتونةٌ بأنوثتها، والشاب العاصي مفتونٌ بشبابه، الكاذب مفتونٌ بكلماته، وآكل الحرام مفتونٌ بماله.. حتى الشيخ الذي هرم ويمارس شيءً من ذلك، هو مفتونٌ في دنيا هو أحد علامت فنائها.
الافتتان بالدنيا يشمل كل جوانب الحياة، و”الشرعنة” هي طريقٌ قصير للحصول على رضا نفسي مؤقت عمّا نمارسه، وما نحاول أن نبرر طرق الوصول إليه، ليتنا نحاول التفكّر يوماً بان هذه الدنيا بكل ما تحويه لو ساوت عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافرًا قطرة ماء.. فلماذا كل ذلك الشقاء لأجل البقاء ونحن على يقين بأننا نعيش في دار الفناء، كل فردٍ منا بحاجة للوقوف مع نفسه قليلاً، وسؤالها هل الدنيا تستحق كل تلك التصرفات السيئة (حقد، كره، ضغينة، غيبةً، نميمة، كذب، تملّق، سرقة، معصية الله بأي شكل).
بقلم.. عويّد السبيعي
3waied@twitter.com
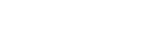


















أضف تعليق