كم مدينة ما زالت مرسومة في الذاكرة، الشوارع المكتظة بالاختلاف البشري، بأمطار ورطوبة ورذاذ تارة، وعواصف وثلوج تارة، ورياح وغبار تارة أخرى.
في كل مدينة هناك مخبز في وسط شارع جانبي يؤمه السكان المحليون، يحاورون عماله بود وحميمية، يسألون بعضهم عن حال العائلة بأسماء أفرادها وخطط اليوم، ويختمون الحديث بتمني النجاح والسعادة لبعضهم بعضاً، مع كيس ورقي تنساب من مسامه رائحة الخبز الذي غادر الفرن منذ ثوان فقط، وينتظر أهل البكور ليشاركهم السعي لأرزاقهم ويمنحهم الطاقة والقوة للعمل. هذا المخبز هو الذي أكون أحد الواقفين في طوابيره، ومنه أستمد عبق إفطار سكانها، وأستنشق رحيق العرق النقي لإنسان أخذ حمامه الصباحي ليبدأ يومه بنشاط.
في كل مدينة هناك مقهى في زاوية ينتبه له قلة من الناس الباحثين عن العزلة والهدوء وحب اللقاء مع الذات ويفضلونه على اللقاءات الأخرى التي يفرضها علينا واقع الدنيا وضروراته وفروضه. في مثل هذا المقهى أحط رحالي وأعتبره زاويتي للتدروش وتكيتي للتحليق بعيداً عن لهاث المكان في عالم الأشياء اللامنتهي.
في كل مدينة هناك سائق حافلة مهاجر. يغني ألحان بلده الأصلي، وهو يقود الركاب لأهدافهم، بينما هو لا أحد يهتم ليساعده في بلوغ هدفه، ولا أحد يعرف هدفه أصلا، بل لا أحد يظن أن له حق بأن يكون له هدف، أجدني في هذه الحافلة ولكن بلا هدف نهائي سوى الالتصاق بنبض الشارع. عندما أكتب عن المدن أتساءل: هل ما أسر مخيلتي وألهمني لاسترجاع ذكرياتها المباني أم البشر، أم أنا عندما كنت فيها، أم ماذا؟ لا أدري. ولكن قد نتعلم معاً ما الذي يحفزنا في مدينة ما.
في مدينة مراكش «المشمشية المباني» كأن المغرب العربي بكل تناقضاته يسكن فيها، غرباء جوالون في كل مكان، وجوه متجانسة في الرغبة بالاكتشاف فقط، ومتنافرة في ثقافاتها وأصولها ونواياها، خصوصاً تلك الساحة التي بلا هوية، باعة يبيعون أي شيء ممكن غير ممكن، سحرة يبيعون أدوات لربط الزوج بزوجته فلا ينظر لغيرها، بهلوان يلف ثعابين على رقبته، مسجد ومصلون، شرفاء ووضعاء، كل شيء تجده في تلك «الساحة» وسط مراكش.
تعلمت في سن مبكرة -لنقل في الثالثة عشرة من عمري- أن الرحلات حول العالم ليست رفاها، بل ضرورة أن نسيح في الأرض وننظر للأمم السابقة آثارها وتركتها، وكيف تفكر الشعوب وماذا جنت الخرائط الاستعمارية على الإسلام أو بما نفعته.
السفر ليس رفاها، السفر ترحال في حضارات وكتب ومخطوطات، تجول في نعومة وجه طفل وتجاعيد شيخ، رفقة حامل من مكان لا يوفر لها ولادة مجانية..
مراكش «بشد الراء، كما ينطق بها أهلها» لها شخصية جميلة، كأنها فتاة تتزين للدخول وتقديم القهوة لسيدة متأنقة جاءت لخطبتها لابنها، وهي كل وقت تلك العروس الشابة التي لا تمل من غنج الشباب، تتهادى ببشرتها التي بلون وطراوة فاكهة المشمش وفي كل المواسم.
خرجت مرتين أو ثلاثا، وكان سوء اختياري وقع على سواق للـ «طاكسي»، كما يسمونه المغاربة، شاربون للخمر، كان أحدهم يردد ترانيم شعبية، ويدخن سيجارة تلو أخرى، وكأن السجائر توزع مجاناً مع رخص القيادة، والآخر ينظر لي من المرآة العاكسة، وكأن الشارع للخلف، والثالث قال لي قصة حياته، والرابع يتمنى يتزوج من خليجية، ذلك بعد أن سألني من أين أنا، لله في خلقه شؤون، وللناس فيما يستغبون في سبيله مذاهب.
ولكن هناك جمال عام يعجز عن تشويهه شذوذ خاص، مراكش جميلة بقبلها ودبرها، لها مشهد كبير شاسع لو كنت متخذة مكاناً أقذف نفسي في أحضانه من «براشوت» لكانت مراكش المشمشية هي هذا المكان.
تعلمت أن الرحلات لها هدف وغاية ونتائج، ومؤسف أن يعاملها البعض بسوء، ويعتبرها مجرد مكان للسكر والعهر والرذيلة، فيسافرون ويعودون ولم يعرفوا من المدينة إلا النساء وهم بربع وعيهم، والكازينوهات يدخلونها وهم ملأى الجيوب، ويخرجون إما للمخفر بسبب عمليات نصب أو مشاجرات وعنف، أو للسفارة ليعودوا بلادهم بالخزي العار، أو يصبرون على مصابهم ويبلعون هزيمتهم.
الصيف آت، وستتجولون بين مدن العالم بما من الله عليكم من نعمة المال، فأحسنوا شكرها بالسياحة الجميلة المحمودة، فالحياة والمتع والجمال ليست في الحرام فقط، نعم للحرام لذة يزينها إبليس والنفس النتنة.
بينما الحلال كثير وواسع في اختياراته، وله رائحة كتلك التي تتسلسل من المخبز الذي في وسط شارع الحي الشعبي.. إنها رائحة الطهر التي لا تنافسها رائحة.
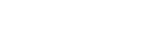



















أضف تعليق