قدم المحامي محمد عبدالقادر الجاسم دراسة حول حكم المحكمة الدستورية الصادر بإبطال انتخاب مجلس الأمة الذي جرى بتاريخ 2/2/2012 ، حيث سلطت الدراسة الضوء على ثلاث نقاط مهمة وجوهرية ذكر بها الجاسم أن حكم المحكمة يعتريه البطلان وكانت النقاط التي تطرق لها الجاسم كالتالي:
*النقطة الأولى: (انعدام حكم المحكمة بسبب بطلان تشكيلها) وذكر به الجاسم إن حكم المحكمة الدستورية الأخير بإبطال انتخاب مجلس الأمة صدر عن محكمة لم تشكل تشكيلا صحيحا، وبالتالي فإنه، من الناحية القانونية، يعتبر منعدما وفق ما قررته محكمة التمييز بشأن نتائج بطلان تشكيل المحكمة.
*النقطة الثانية:(حدود اختصاص المحكمة الدستورية بالنسبة للطعون الانتخابية ونطاق تلك الطعون) وذكر بها الجاسم إن الاختصاص بالفصل في الطعون الانتخابية هو اختصاص أسنده الدستور إلى مجلس الأمة وفق المادة (95) التي أجازت نقل هذا الاختصاص إلى “جهة قضائية”. وفي العام 1973 تم نقل هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية، وبالتالي فإن اختصاص هذه المحكمة في نظر الطعون الانتخابية لا يمكن أن يتجاوز اختصاص الجهة الأصيلة وهي مجلس الأمة، ومن ثم فإن نطاق الطعون الانتخابية لا يتعدى “العملية الانتخابية” التي تتكون من تصويت وفرز وإعلان نتيجة، وليس للمحكمة الدستورية أن تتوسع في مفهوم “العملية الانتخابية” وأن تبسط رقابتها على المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات ضمن نطاق الطعن الانتخابي.
*النقطة الثالثة: (مدى اختصاص المحكمة بنظر الأعمال السياسية ومنها المرسوم الأميري الصادر بحل مجلس الأمة) وذكر الجاسم أن المحكمة الدستورية قررت في حكمها محل هذه الدراسة أن “القيود الإجرائية التي فرضها الدستور على السلطة التنفيذية لا يجوز إسقاطها أو تجاوزها أو التحلل منها تذرعا بأنها أعمال سياسية، إذ أن هذا القول لا يستقيم في مجال إعمال سلطتها المقيدة طبقا للدستور”.
وكانت الدراسة كالتالي:
دراسة حول حكم المحكمة الدستورية الصادر بإبطال انتخاب مجلس الأمة الذي جرى بتاريخ 2/2/2012
“الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل على الصحيح فيبطله..”.
محكمة التمييز
“ولا يسوغ أن تهدر إرادة الناخبين التي كشف عنها إعلان النتيجة لمجرد مخالفة إجرائية اقتضتها ضرورة ملجئة تقدر بقدرها أو فرضها واجب يتعين الالتزام به تغليبا له، ولا يسوغ إهدار تلك الإرادة لمجرد عدم استيفاء شكليات مفروضة غير مؤثرة على نتيجة الانتخاب..”.
المحكمة الدستورية
مقدمة
أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية بتاريخ 20/6/2012 بإبطال انتخابات مجلس الأمة التي جرت في 2/2/2012 جدلا واسعا في البلاد، وتعددت الآراء وتنوعت بين رأي سياسي صرف ورأي قانوني بحت وآراء أخرى تخلط بين هذا وذاك.
ولا يخفى على المتابع للشأن العام في الكويت أنه كان للحكم المشار إليه وقع الصدمة على من لم يكن منتبها لمسار الطعون الانتخابية التي قدمت بعد إعلان نتيجة الانتخابات، ذلك أن التركيز في الأيام القليلة السابقة على ميعاد النطق بالأحكام كان من نصيب الطعن المتصل بصحة عضوية الدكتور فيصل المسلم والطعن المتصل بصحة عضوية محمد الجويهل، في حين لم يحصل الطعن المقدم من السيدة صفاء الهاشم وكذلك الطعن المقدم من السيد روضان الروضان باهتمام الرأي العام على الرغم من خطورتهما، إذ كانا ينصبان على بطلان المرسوم الأميري الذي صدر بتاريخ 6/12/2011 بحل مجلس الأمة باعتباره مخالفا للدستور.
وفيما كان الرأي العام يتابع تفاصيل تطورات الوضع السياسي بعد صدور مرسوم أميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة مدة شهر بتاريخ 18/6/2012 والاجتماعات التي عقدت بين رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء بهدف معالجة العلاقة المتوترة بين المجلسين، وفي غمرة تندر الرأي العام على تصريح صحفي أطلقه رئيس مجلس الوزراء مفاده أن “الأمور زينة”، صدر حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات وباستعادة مجلس الأمة المنتخب في العام 2009 سلطاته الدستورية وكأن حله لم يكن.
ونظرا لأهمية حكم المحكمة الدستورية، فقد رأيت إعداد هذا الرأي الفني، الذي أركز فيه على (1) انعدام حكم المحكمة بسبب بطلان تشكيلها (2) حدود اختصاص المحكمة الدستورية بالنسبة للطعون الانتخابية ونطاق تلك الطعون (3) مدى اختصاص المحكمة بنظر الأعمال السايسية ومنها المرسوم الأميري الصادر بحل مجلس الأمة.
وقبل بيان رأيي الشخصي في حكم المحكمة الدستورية فإنه يلزم الإيضاح ابتداء أنني أشاطر المحكمة الدستورية الرأي في شأن بطلان المرسوم الصادر في 6/12/2011 بحل مجلس الأمة، وقد سبق لي إعلان رأيي هذا في حينه. إلا أن بطلان مرسوم الحل لا يعني أن المحكمة الدستورية تملك الاختصاص بتقرير بطلانه وبطلان ما ترتب عليه من آثار في منازعة انتخابية، وذلك على النحو الذي سيلي بيانه بعد قليل.
كما يلزم التنويه إلى أنه أيا كانت الحجج التي نوردها هنا لإثبات خطأ المحكمة الدستورية، فإن هذا لا يعني إطلاقا الدعوة إلى إنكار الحكم أو عدم التقيد به، فهو حكم قائم ومنتج لآثاره رغم ما يعتوره من بطلان.
أولا: انعدام أحكام المحكمة الدستورية التي صدرت منذ الأول من أكتوبر 2011
لبطلان تشكيلها تنص المادة (2) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية على التالي:
“تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري، كما يختار عضوين احتياطيين، ويشترط أن يكونوا جميعا من الكويتيين، ويصدر بتعيينهم مرسوم. وإذا خلا محل أي عضو من الأعضاء الأصليين أو الاحتياطيين اختار مجلس القضاء- بالاقتراع السري- من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم..”.
ويستفاد من النص السابق أن عضوية المحكمة الدستورية تنقسم إلى عضوية أصلية وعضوية احتياطية. كما يستفاد أن تعيين العضو الأصلي أو الاحتياطي في المحكمة الدستورية يجب أن يمر بمرحلتين: الأولى لدى مجلس القضاء، والثانية لدى مجلس الوزراء. أما المرحلة الأولى فتتكون من (1) قرار باختيار عضو المحكمة (الأصلي والاحتياطي) من قبل مجلس القضاء (2) على أن يتخذ هذا القرار بعد اقتراع سري يجريه مجلس القضاء. أما المرحلة الثانية فهي صدور مرسوم أميري بالتعيين.
ويستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة (2) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، أن التعيين في المحكمة الدستورية يجب أن يتم بواسطة مرسوم أميري، سواء للأعضاء الأصليين أو الاحتياط بعد الاقتراع السري الذي يجريه مجلس القضاء.
كما يستفاد من نص الفقرة الثانية أن تعيين عضو الاحتياط كعضو أصلي في المحكمة، بعد خلو محل أحد الأعضاء الأصليين بصورة دائمة، لا يتم بشكل تلقائي، بل لابد من صدور مرسوم أميري بهذا التعيين أيضا بعد الاقتراع السري الذي يجريه مجلس القضاء.
كما يستفاد أيضا أن تعيين عضو الاحتياط كعضو أصيل في المحكمة في حالة خلو محل أحد الأعضاء الأصليين، ليس واجبا أو إلزامي، بل يمكن لمجلس القضاء أن يختار العضو الجديد من غير عضوي الاحتياط.
ويستفاد أيضا أن إجراءات تعيين العضو الأصلي الجديد، سواء كان من بين عضوي الاحتياط أو من غيرهما، هي الاقتراع السري الذي يجريه مجلس القضاء ثم صدور المرسوم بتعيينه. أي أنه إذا خلا محل أحد الأعضاء الأصليين في المحكمة الدستورية، يقوم مجلس القضاء باختيار من يحل محله عن طريق الاقتراع السري، سواء من بين الأعضاء الاحتياطيين أو من غيرهم، ثم يصدر مرسوم بتعيينه.
أما في حالة وجود مانع يحول دون قيام أحد أعضاء المحكمة الدستورية بعمله في المحكمة لعارض مؤقت، كالمرض مثلا، أو إذا كان غير صالح لنظر الدعوى وفق المادة 102 من قانون المرافعات، فإن حلول عضو الاحتياط محل العضو الأصلي، في هذه الحالة، يتم من دون الحاجة إلى صدور مرسوم، فهذا الحلول مؤقت ومرتبط بوجود مانع يحول دون اشتراك أحد الأعضاء الأصليين في نظر الدعوى، وليس بسبب خلو محل أحد الأعضاء الأصليين، وهو ليس من قبيل العضوية الأصلية في المحكمة التي لا تتم إلا بمرسوم. كما أن الحلول المؤقت لعضو الاحتياط يسنده أساسا المرسوم الصادر بتعيينه كعضو الاحتياط. فمهمة عضو الاحتياط هي الحلول مؤقتا محل العضو الأصلي الذي يحول مانع مؤقت دون قيامه بعمله في المحكمة الدستورية.
ومن هنا يجب التمييز بين حلول عضو الاحتياط، بصفة مؤقتة، محل العضو الأصلي، وهي الحالة التي لا تستدعي صدور مرسوم، وبين دخول عضو الاحتياط ضمن التشكيل الأصلي للمحكمة بصفة دائمة بسبب خلو محل أحد الأعضاء الأصليين، وهي الحالة التي تستدعي حتما صدور مرسوم بالتعيين.
ولو أن المشرع أراد حلول عضو الاحتياط، بشكل تلقائي، محل العضو الأصلي حين يخلو منصبه بشكل دائم، لنص على ذلك صراحة، كأن ينص مثلا على أنه “وإذا خلا محل أي عضو من الأعضاء الأصليين، حل محله عضو الاحتياط..”، فلو كان القانون ينص على الحلول التلقائي لما كانت هناك حاجة لقيام مجلس القضاء باختيار عضو بديل بالاقتراع السري، ولما كانت هناك حاجة لصدور مرسوم بتعيين عضو الاحتياط كعضو أصلي في المحكمة، إذ أن الحلول التلقائي هنا يتم بقوة القانون من غير مرسوم. غير أنه لا مجال للاجتهاد مع صراحة النص.
هذا وقد استقر قضاء محكمة التمييز الكويتية في صدد تفسير النصوص القانونية، “أنه متى كان النص واضحا جلي المعنى، فلا يجوز الخروج عليه والأخذ بما يخالفه لما في ذلك من استحداث حكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، كما أن التفسير مشروط بألا يكون فيه خروج على ما تحتمله عبارات النص أو تشويه لحقيقة معناه..”.
وعلى الرغم من صراحة النص ووضوح مراميه، فقد يجادل البعض ويقول أنه إذا ما خلا محل أحد الأعضاء الأصليين للمحكمة، وقرر مجلس القضاء اختيار أحد عضوي الاحتياط ليحل محله، فإن الأمر هنا لا يستدعي صدور مرسوم بالتعيين باعتبار أن المرسوم الصادر بالتعيين كعضو احتياط يغني عن المرسوم الجديد، وأن عضوية المحكمة قد ثبتت لعضو الاحتياط بمجرد صدور مرسوم تعيينه كعضو احتياط، وأن صلاحية المرسوم لا تنتهي بل تمتد لتشمل العضوية بالأصالة طالما كان العضو الأصيل الجديد عضوا احتياطيا سابقا.
وللرد على هذا القول نوضح أولا إن نص الفقرة الثانية من المادة الثانية صريح وواضح ولا مجال معه للاجتهاد كما أشرنا قبل قليل، فهذا النص يستلزم صدور مرسوم بتعيين العضو الأصلي في المحكمة، سواء سبق صدور مرسوم بتعيينه عضو احتياط أو تم اختياره لعضوية المحكمة بالأصالة مباشرة ومن غير المرور في العضوية الاحتياطية، فعضوية المحكمة الدستورية بالأصالة تستلزم دائما صدور مرسوم بالتعيين. كما نوضح ثانيا أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية نص على أنها تتألف من خمسة مستشارين وليس سبعة مستشارين، وهو لم يترك اختيار الأعضاء الأصليين من بين السبعة لهيئة المحكمة أو لأي جهة أخرى، مما يعني أن عضوية المحكمة الدستورية تتكون من عضوية أصلية وعضوية احتياطية، والعضوية الأصلية والاحتياطية مراكز قانونية أنشأها المشرع، وليس هناك من شك في أن المرسوم الصادر بتعيين عضو أصلي أو عضو احتياط، يرتب أثرا قانونيا محددا هو العضوية بالأصالة أو الاحتياطية في المحكمة لمن ورد اسمه في المرسوم قرين صفته، فإذا كان محل المرسوم هو العضوية الاحتياطية، لا يمكن أن يقال أن هذا المرسوم ذاته يصلح من بعد لإحداث أثر قانوني آخر هو عضوية المحكمة بالأصالة أيضا.
من جهة أخرى، فإنه إذا كان الثابت أن عضو الاحتياط لا يصبح عضوا أصيلا في المحكمة بشكل تلقائي وبمجرد خلو منصب أحد الأعضاء الأصليين، وهذا ما يستفاد من صراحة نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون إنشاء المحكمة الدستورية ومن التطبيقات العملية التي أتت بكل من المستشارين فيصل المرشد ويوسف غنام الرشيد كعضوين أصيلين في المحكمة على الرغم من وجود عضوين احتياطيين، فهل تحويل عضوية الاحتياط إلى عضوية أصلية، حتى على فرض جواز التلقائية فيه، لا يحتاج إلى تدخل من جهة ما؟ هل من المتصور عقلا أن يذهب عضو الاحتياط مباشرة إلى منصة المحكمة الدستورية ويجلس كعضو أصلي؟ بالطبع لا. لذلك نسأل من الذي يقرر أي عضو احتياط يحل محل العضو الأصلي الذي خلا محله؟ هل الأمر متروك للاتفاق بين العضوين؟ أم أن مجلس القضاء هو الذي يقرر ويختار أحدهما؟
إن التطبيقات العملية تكشف عن عدم الاعتداد بمعيار الأقدمية في المحكمة الدستورية حيث تم تعيين المستشار فيصل المرشد عضوا أصليا في المحكمة عام 2000 بالرغم من أقدمية عضوي الاحتياط. كما أن ترتيب ورود أسماء أعضاء المحكمة في الأحكام التي تصدرها لا يراعي معيار الأقدمية، وكذلك الأمر بالنسبة لترتيب الجلوس على منصة المحكمة، وبالتالي فإن معيار الأقدمية غير معمول به في رحاب المحكمة الدستورية. ثم، وبصرف النظر عن كيفية المفاضلة بين العضوين الاحتياط، ما هي الأداة القانونية التي تحول العضوية من الاحتياط إلى الأصالة؟ هل يكفي قرار يصدر من مجلس القضاء؟ ما هو السند القانوني لهذا القرار، مع خلو قانون إنشاء المحكمة الدستورية من أي نص يخول مجلس القضاء اتخاذ هذا القرار على انفراد؟
إن عملية اختيار العضو الأصلي في المحكمة الدستورية تمر بمرحلتين: الأولى هي الاختيار الذي يجريه مجلس القضاء عن طريق الاقتراع السري، والثانية هي صدور مرسوم بتعيين من وقع عليه اختيار مجلس القضاء. ولا يمكن أن يتم التعيين في عضوية المحكمة الدستورية مباشرة من قبل مجلس القضاء منفردا، إذ أن أي قرار يتخذه مجلس القضاء هنا ومن دون صدور مرسوم أميري بالتعيين هو بمثابة اغتصاب للسلطة، فمجلس القضاء لا يملك الانفراد في تعيين عضو المحكمة الدستورية. إن تحويل العضوية الاحتياطية إلى عضوية أصلية هو، في الحقيقة والواقع، قرار بتعيين عضو أصلي في المحكمة الدستورية، وليس هناك من شك في أن قرار تحويل عضوية الاحتياط إلى عضوية أصلية لابد وأن يمر بالمرحلتين المشار إليهما. وباختصار شديد نقول إن صلاحية المرسوم الصادر بتعيين عضو الاحتياط لا يمكن أن تتعدى الأثر القانوني المقصود منه وهو العضوية الاحتياطية.
ومن خلال مطالعة مضابط جلسات مجلس الأمة حول دور عضو الاحتياط في المحكمة الدستورية، يتبين لنا صحة ما نذهب إليه، حيث كانت المناقشات تدور حول حالة عدم اكتمال نصاب المحكمة، فتم توضيح أنه لمواجهة هذا الاحتمال يتم تعيين عضوين احتياط، وقد أوضح ممثل الحكومة آنذاك الشيخ سلمان الدعيج هذا الأمر بقوله: “الحكومة أوردت في مشروعها نصا على أساس أن يكون هناك أعضاء احتياطيون، فاعتقد لو أخذ المجلس برأي الحكومة بأن يكون هناك عضوان احتياطيان في حالة غياب أحد أعضاء المحكمة الدستورية، فمشروع اللجنة عالج رئيس المحكمة، ولم يعالج غياب أحد أعضاء المحكمة، ففي هذه الحالة أعتقد إن الأفضل أن يؤخذ بمشروع الحكومة بإضافة بسيطة، يختار مجلس القضاء الأعلى بالاقتراع السري أعضاء المحكمة الخاصة يختار عضوين احتياطيين ويصدر بتعيينهما مرسوم، في هذه الحالة نكون غطينا حالة غياب أحد أعضاء المحكمة، وهناك أيضا سبب ثاني وجيه، فلو مثلا قام مانع لدى أعضاء المحكمة الدستورية، مثلا الموضوع يتعلق بشخصه أو يتعلق بقريب له من الدرجة الأولى، فيجب أن يكون في المحكمة الدستورية عضوان احتياطيان لسد هذه الثغرة…”.
هذا، وتشير التطبيقات العملية إلى أنه كثيرا ما كان عضو الاحتياط، في تشكيلات سابقة، المستشار راشد الحماد يحل محل العضو الأصلي الذي يعتذر عن المشاركة في نظر دعوى دستورية أو طلب تفسير، كما كان المستشار كاظم المزيدي يقوم بالشيء ذاته.
ومن خلال تتبع المراسيم الأميرية الصادرة بشأن تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، الأصليين والاحتياطيين، منذ إنشائها في العام 1973 ولغاية أغسطس من العام 2008، يتضح لنا أن البطلان كان يشوب تشكيل تلك المحكمة في مراحل متعددة، وهو بطلان متعلق بالنظام العام، ويؤدي إلى انعدام الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية في فترة بطلان تشكيلها، حيث أن أعضاء احتياط حلوا محل أعضاء أصليين بشكل دائم من دون اتباع الإجراءات التي نصت عليها الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية التي تنص على أنه “وإذا خلا محل أي عضو من الأعضاء الأصليين أو الاحتياطيين اختار مجلس القضاء- بالاقتراع السري- من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم”، حيث لم يتم اختيارهم بالاقتراع السري من قبل مجلس القضاء، كما لم يصدر مرسوم بتعيينهم أعضاء أصليين في المحكمة، وإنما تم تحويل عضويتهم من عضوية احتياط إلى عضوية أصلية بشكل تلقائي بغير مرسوم على الرغم من صراحة نص الفقرة الثانية المشار إليها الذي يشترط صدور المرسوم.
وبمطالعة المرسوم الأميري الصادر بالتشكيل الحالي للمحكمة الدستورية، نجد أن هذا المرسوم صدر بتاريخ 22/12/2010 برقم 524 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/1/2011 بعنوان “مرسوم رقم 524 لسنة 2010 في شأن تشكيل المحكمة الدستورية، ومتضمنا تعيين المستشار/ يوسف غنام الرشيد رئيسا للمحكمة، وتعيين كل من: المستشار/ فيصل المرشد والمستشار/ راشد الشراح والمستشار/ خالد سالم والمستشار/ محمد بن ناجي أعضاء أصليين. كما تضمن المرسوم تعيين كل من المستشار/ عادل بورسلي والمستشار/ إبراهيم السيف أعضاء احتياطيين.
وفي نهاية شهر سبتمبر 2011، انتهت خدمة المستشار يوسف غنام الرشيد في القضاء لبلوغه السن القانونية، وخرج من تشكيل المحكمة الدستورية، ومع ذلك استمرت المحكمة الدستورية في القيام بعملها من دون صدور مرسوم جديد بإعادة تشكيلها، سواء بدخول عضو أصلي جديد محل المستشار يوسف غنام الرشيد أو بتعيين رئيس المحكمة.
وبمطالعة الأحكام والقرارات التفسيرية الصادرة من المحكمة خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2011 حتى يومنا هذا، نجد أن تشكيل المحكمة يضم المستشار/ فيصل عبدالعزيز المرشد رئيسا، كما يضم المستشار/ عادل بورسلي كعضو أصلي.
وحيث أنه لم يصدر مرسوم جديد وفق المادة (2) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية يتضمن تعيين المستشار/ فيصل المرشد رئيسا للمحكمة، أو يتضمن تعيين المستشار/ عادل بورسلي كعضو أصلي في المحكمة، فإن هذا يؤدي إلى انعدام أحكام المحكمة لبطلان تشكيلها.
ويبدو أن المجلس الأعلى للقضاء سعى مؤخرا إلى تصحيح وضع المحكمة، فقام باختيار المستشار/ يوسف المطاوعة كعضو أصلي في المحكمة، إلا أنه لم يصدر بعد مرسوم أميري بتعيينه. ويأتي هذا التعيين ليؤكد حقيقة مخالفة تشكيل المحكمة للقانون، وبالطبع فليس من شأن هذا التعيين تصحيح أحكام المحكمة بأثر رجعي.
وحول انعدام الأحكام التي تصدر من محكمة مشكلة تشكيلا باطلا، أصدرت محكمة التمييز العديد من الأحكام في هذا الشأن، فقد قررت أن “الحكم في جوهره هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت إليها وفق قواعد قانون المرافعات في محرر مكتوب طبقا لإجراءات خاصة، وكل عيب يعتري الحكم لا يفقده هذه الطبيعة، لا يعدو أن يكون من الشوائب التي تصيب صحته إلى حد قد يبطله؛ أما انعدام الحكم فهو شيء أعنف من ذلك وأمعن في الخروج على القانون، إذ هو مخالفة للقانون لا تقتصر على تعييب الحكم، بل تمتد إلى انعقاده وكيانه، وتعدم أحد أركانه، فتجعله والعدم سواء، كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا..”.
كما قررت أيضا أن “انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد الحكم من أركانه الأصلية، كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا..”.
الخلاصة
إن حكم المحكمة الدستورية الأخير بإبطال انتخاب مجلس الأمة صدر عن محكمة لم تشكل تشكيلا صحيحا، وبالتالي فإنه، من الناحية القانونية، يعتبر منعدما وفق ما قررته محكمة التمييز بشأن نتائج بطلان تشكيل المحكمة. إن بطلان تشكيل المحكمة الدستورية ناتج عن تعيين عضو الاحتياط المستشار/ عادل بورسلي كعضو أصلي في المحكمة منذ 1/10/2011 محل رئيس المحكمة السابق الذي انتهت خدمته وذلك من دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (2) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية، فقد كان من الواجب صدور مرسوم جديد بتعيينه كعضو أصلي في المحكمة.
ثانيا: تجاوز المحكمة حدود اختصاصها في نظر الطعون الانتخابية.
تنص المادة (95) من الدستور على أنه “يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه ولا يعتبر الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية”.
وقد مارس مجلس الأمة اختصاصه في نظر الطعون الانتخابية، إلا أنه في العام 1973 صدر القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية وبموجبه أسند المشرع إلى المحكمة الدستورية الاختصاص بنظر الطعون الانتخابية، إذ تنص المادة (5) من هذا القانون على أنه “تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم..”.
وبناء على ذلك فإنه يمكن القول أن اختصاص المحكمة الدستورية في الفصل في الطعون الانتخابية اختصاص ضيق ولا يجوز أن يتعدى اختصاص الجهة الأصيلة، وهي مجلس الأمة، الذي منحه الدستور هذا الاختصاص كأصل وأجاز أن يعهد به إلى جهة قضائية. وبالتالي فإن المحكمة الدستورية، وهي تفصل في الطعون الانتخابية، لا تملك أي سلطة تفوق سلطة مجلس الأمة صاحب الاختصاص الأصيل في نظره للطعون الانتخابية والمقرر من قبل الدستور.
وإذا أمعنا النظر في اختصاص المحكمة الدستورية بالنسبة للطعون الانتخابية نجد أن القانون قد حدد هذا الاختصاص وهو “الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم”، أي أن نص القانون حدد نطاق الاختصاص وحصره في العملية الانتخابية وفي صحة العضوية.
وانسجاما مع هذا الاتجاه الذي تبناه المشرع، حرصت المحكمة الدستورية في أحكامها الصادرة في الطعون الانتخابية على تحديد نطاق الطعون الانتخابية وحدود اختصاص المحكمة بشأنها، إذ وضعت قاعدة عامة مفادها أن رقابتها في الطعون الانتخابية تنصرف إلى “العملية الانتخابية” فقط ولا تتجاوزها. وقد كررت المحكمة الدستورية التزامها بهذا القاعدة ولم تعدل عنها إلا في حكمها الأخير.
ومن أجل تحديد نطاق رقابة المحكمة على العملية الانتخابية في الطعون الانتخابية، كان لزاما على المحكمة الدستورية تحديد المقصود باصطلاح العملية الانتخابية، وهو الأمر الذي حرصت عليه في العديد من أحكامها، إذ استقر رأيها على أن العملية الانتخابية تبدأ في التصويت ثم فرز الأصوات ثم إعلان النتائج، وأن رقابتها لا تشمل أي إجراء يتخذ قبل التصويت أو بعد إعلان النتائج. ويأتي تحديد المحكمة الدستورية لنطاق رقابتها للعملية الانتخابيىة على نحو ضيق منسجما مع حقيقة كون اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية لا يجاوز حدود اختصاص الجهة الأصيلة وهي مجلس الأمة على النحو الذي أشرنا إليه قبل قليل.
ومن خلال تتبع موقف المحكمة الدستورية في تحديد نطاق اختصاصها في الطعون الانتخابية وتحديد مفهوم العملية الانتخابية، تبين لنا أن اتجاه المحكمة كان متشددا، إذ رفضت المحكمة في أكثر من طعن الخروج عن النطاق الضيق الذي وضعه المشرع لاختصاصها، بل أنها ومن خلال تتابع أحكامها كانت تجتهد كثيرا على الدوام في تحديد نطاق الطعن الانتخابي، وفي العام 2008 وضعت المحكمة تحديدا دقيقا جدا لنطاق الطعن الانتخابي، وسوف نستعرض فيما يلي موقف المحكمة الدستورية في هذه المسألة:
في الحكم الصادر في الطعن رقم (4) لسنة 1992 بتاريخ 19/12/1992، قررت المحكمة في شأن حدود الطعن الانتخابي ورقابة المحكمة أنه “وكان من المسلم أن للمحكمة في حدود الطعن أن تراقب العملية الانتخابية فتراجع الشروط المتعلقة بالناخبين والمرشحين وتفحص جميع إجراءات الانتخاب وقواعده للتأكد من سلامتها وكذا النتائج التي أعلنت استنادا إليها..”.
وقد كررت المحكمة الدستورية القاعدة السابقة في معظم أحكامها اللاحقة التي صدرت في طعون انتخابية، إلا أنها في حكمها الصادر في الطعنين رقمي (5، 14) لسنة 2003 بتاريخ 6/12/2003، أوضحت على نحو أكثر تفصيلا المقصود بالعملية الانتخابية، إذ قررت “وتباشر المحكمة الدستورية في هذا الصدد رقابتها القضائية التي تنصب أساسا على نحو ما هو مستقر عليه، على عملية الانتخاب بما يشمل مراحلها المتعددة، والمتمثلة في التصويت والفرز وإعلان النتيجة وينعكس أثره على صحة من أسبغت عليه صفة العضوية لمن أعلن فوزه في الانتخابات، وبالتالي على ما تم في عملية الانتخاب برمتها من إجراءات توصلا للتأكد من سلامة تعبير الانتخاب عن إرادة الناخبين…”.
وفي فقرة أخرى من الحكم ذاته حددت المحكمة مراحل العملية الانتخابية بقولها “حيث أفرد لها المشرع تنظيما شاملا لمراحلها المتعددة بدءا من تقديم الناخب إلى لجنة الانتخاب ما يفيد قيده في جدول الانتخاب باعتبار هذا الجدول الوثيقة القانونية التي تحوي هيئة الناخبين الذين تتوافر فيهم شروط القيد وحق التصويت، ثم إدلاء الناخب بصوته معبرا بذلك عن إرادته في المفاضلة بين المرشحين، واختيار المرشح الذي يرغب في أن يكون ممثلا له وذلك بالتأشير على اسمه في ورقة الانتخاب بشكل غير معلن، بعد أن ينتحي الناخب ناحية المكان المخصص لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب… وفي ختام عملية التصويت يجري الفرز العلني للأصوات في جميع لجان الدائرة… ويتم جمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني وفقا للإجراءات التي سنها المشرع في القانون المشار إليه والتي تختتم بإعلان النتيجة..”.
وقد تكرر التزام المحكمة بالقواعد السابقة المنظمة لنطاق الطعون الانتخابية في جميع الأحكام التي صدرت في الطعون الانتخابية المقدمة في العام 2003، إذ قررت “وتباشر المحكمة الدستورية في هذا الصدد رقابتها القضائية التي تنصب أساسا- على نحو ما هو مستقر عليه- على عملية الانتخاب بما يشمل مراحلها المتعددة، والمتمثلة في التصويت والفرز وإعلان النتيجة”.
وقد أكدت المحكمة الدستورية التزامها بالقواعد السابقة في الأحكام الصادرة في الطعون الانتخابية المقدمة في العام 2006، ففي الحكم الصادر في الطعن رقم (7) لسنة 2006 بتاريخ 22/1/2007، قررت المحكمة “وحيث أنه من المسلم به أن للمحكمة في حدود الطعن المرفوع أمامها بسط رقابتها على عملية الانتخاب وفحص جميع إجراءاتها وقواعدها للتأكد من سلامتها وكذا النتائج التي أعلنت استنادا إليها، والطعن الانتخابي – من بعد – قد يؤدي إلى إلغاء العملية الانتخابية برمتها متى ثبت للمحكمة أن العملية الانتخابية قد جاءت معيبة في جملتها في ضوء ما تستظهره من عيب يوجب إعادة الانتخاب في الدائرة بالكامل، كما قد يؤدي الطعن إلى إلغائها جزئيا متى وجدت أن العيب قد اعتور أحد إجراءاتها بما من شأنه تعديل النتائج المعلنة..”.
وفي الحكم الصادر في الطعن رقم (8) لسنة 2006 بتاريخ 22/1/2007، قررت المحكمة “لما كان ما تقدم وكانت مهمة هذه المحكمة بالنسبة إلى الطعون الانتخابية إنما تحكمها التشريعات المنظمة لهذا الشأن، وإلى أحكام هذه التشريعات وعلى الوجه الصحيح لتفسيرها، يكون مرد الأمر بلا إفراط ولا تفريط، ودون توسعة أو انتقاص أو تضييق، ومن المسلم به أن للمحكمة في حدود الطعن المرفوع أمامها بسط رقابتها على عملية الانتخاب وفحص جميع إجراءاتها وقواعدها للتأكد من سلامتها وكذا النتائج التي أعلنت استنادا إليها…”.
وفي الحكم الصادر في الطعن رقم (10) لسنة 2006 بتاريخ 22/1/2007، أسهبت المحكمة الدستورية في بيان اختصاصها في الطعون الانتخابية وحدود اختصاصها، إذ قررت ” كما أنه غني عن البيان أن مفاد نص المادة الأولى من قانون إنشاء هذه المحكمة بإسناد الفصل في هذه الطعون إليها، مفاده أن اختصاصها في هذا الشأن هو اختصاص شامل، وأن عبارة “الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم” الواردة بالنص المشار إليه، تفيد الشمول والاستغراق لجميع مراحل العملية الانتخابية، بحسبانها عملية مركبة لا يجوز فصلها عن بعضها، مما يفرض التزاما تمليه مقتضيات حسن سير العدالة وأداء رسالتها بعدم تقطيع أوصال المنازعة الواحدة في صحة العضوية وفي مدى صحة العملية الانتخابية، والمحكمة وهي تفصل في هذه الطعون بوصفها محكمة موضوع ملتزمة بإنزال حكم القانون على واقع النزاع المطروح عليها مقيدة في ذلك بضوابط العمل القضائي وضماناته، بعيدا عن العمل السياسي بحساباته وتقديراته، فإنها تبسط رقابتها وحسبما جرى به قضاءها على عملية الانتخاب برمتها أيا كان وجه النعي عليها أو وصف القرار الصادر في شأنها وبما يشمل مراحلها المتتابعة والمتعددة من تصويت وفرز وإعلان للنتيجة وينعكس أثره على صحة العضوية لمن فاز في الانتخابات، وذلك للتأكد من سلامتها وصحتها، ومن الجلي أن القرار بإعلان نتيجة الانتخاب الصادر بعد الانتهاء من التصويت والفرز تتويجا لعملية الانتخاب هو في واقع الأمر قرار بالكشف عن إرادة الناخبين وإعلانها على الكافة، وأن العضوية في مجلس الأمة إنما مرجعها أصلا إلى عملية الانتخاب بحسبانها الوسيلة التي يتم من خلالها التعبير عن إرادة الناخبين التي هي أساس صحة العضوية، فإذا لحقت شائبة بعملية الانتخاب من شأنها أن تفضي إلى إبطالها انعكس ذلك بحكم التداعي على صحة العضوية لمن أعلن فوزه في الانتخاب..”.
أما في الطعون الانتخابية التي فصلت فيها في العام 2008، فقد حددت المحكمة الدستورية وعلى نحو أوضح بكثير حدود اختصاصها في نظر الطعون الانتخابية والمقصود بالعملية الانتخابية، إذ قررت في الحكم الصادر في الطعن رقم (8) لسنة 2008 بتاريخ 16/7/2008 “لما كان ذلك، وكان قانون الانتخاب فيما تناوله من أحكام قد راعى الترتيب لمراحل الانتخاب وقسمها تقسيما وافيا، بدءا من عملية القيد بتحديد بتحديد الموطن الانتخابي والقيد بجداول الانتخاب وتحصن تلك الجداول، ثم عملية الترشيح بتقديم طلب الترشيح وإدراج أسماء من تتوفر فيهم شروط الترشيح بالكشوف المعدة لذلك، وانتهاء بعملية الانتخاب بإجراء التصويت والفرز وإعلان أسماء الفائزين في الانتخابات، وأنه وإن كان المشرع قد جعل لكل مرحلة من هذه المراحل استقلالها وإجراءاتها الخاصة، وفرق في وضوح بين عملية القيد وعملية الترشيح وعملية الانتخاب إلا أن تلك المراحل تتكامل جميعها بلوغا إلى غايتها بإعلان إرادة الناخبين، وقد حافظ القانون على حق كل مواطن أو ناخب أو مرشح في إبداء طعنه في كل مرحلة من تلك المراحل، ومتى كان الأمر كذلك، وكان من المقرر أن الطعن الانتخابي منوط في الأساس بتعلق الأمر في شأنه بعملية الانتخاب ذاتها وما شابها من أخطاء سواء في التصويت أو الفرز أو إعلان النتيجة وما عسى أن ينعكس أثره على صحة عضوية من أعلن فوزه في تلك الانتخابات، وبالتالي فإن ما يتخذ في مسائل القيد في الجداول أو في إجراءات الترشيح من أعمال وتصرفات وما ينجم عنها هي أمور سابقة – ولا شك- على العملية الانتخابية ذاتها، وليس من شأن اضطلاع الجهة الإدارية بتلك الأعمال واتخاذها لهذه القرارات، وبغض النظر عن مدى سلامتها وتداعياتها، أن يحيل النزاع في شأنها إلى طعن في صحة الانتخاب، وإنما تظل متعلقة بقرارات يستنهض اختصاص القضاء المختص في أمرها، بحيث لا يستنزف اختصاص هذه المحكمة- بنظر الطعون المتعلقة بعملية الانتخاب بمعناهي الفني الاصطلاحي الدقيق وما يصدر عنها من إعلان عن إرادة الناخبين- اختصاص القضاء المختص من بسط رقابته القضائية على القرارات الصادرة في المراحل السابقة على عملية الانتخاب..”.
وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن بعد أن قررت “ومتى كان الأمر كذلك، وكان صحيح التكييف القانوني لطلبات الطاعن في الطعن الماثل أنها تتمثل- في حقيقة الواقع والقانون- في الطعن على قرار استبعاده من الترشيح وما يترتب عليه من آثار، وكان ما ساقه الطاعن من أسباب لطعنه إنما يتعلق بأمر سابق على عملية الانتخاب، لا يمكن نسبته إلى عملية الانتخاب ذاتها من تصويت أو فرز أو إعلان نتيجة..”.
ومن العرض السابق نخلص إلى أن المحكمة الدستورية، ومنذ تأسيسها كانت تحرص أشد الحرص على عدم التوسع في ممارسة اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية وعدم الخروج عن حدود “العملية الانتخابية” بمراحلها الثلاث وهي: (1) التصويت (2) الفرز (3) إعلان النتيجة، وأنها كانت ترفض فحص ومراقبة أي إجراء يسبق “العملية الانتخابية” بما في ذلك الإجراءات والقرارات المتعلقة بتقديم طلب الترشيح على الرغم من الارتباط الوثيق بين “الترشيح” والعملية الانتخابية (التصويت والفرز وإعلان النتيجة).
وفي تقديري الشخصي، فإن تشدد المحكمة الدستورية في تحديد نطاق اختصاصها وحدود الطعن الانتخابي وقصره على “العملية الانتخابية” بمفهومها الضيق الذي يشمل التصويت والفرز وإعلان النتيجة من دون أن يشمل أي إجراء يتخذ في الفترة السابقة على بدء التصويت، هو تشدد في محله ويصادف صحيح القانون، وينسجم تماما مع كون اختصاص المحكمة الدستورية بنظر المنزاعات المتعلقة بالطعون الانتخابية هو اختصاص منقول إليها من قبل المشرع من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل وهي مجلس الأمة، ذلك أن المحكمة الدستورية لا تستطيع تجاوز حدود الاختصاص المسند إلى مجلس الأمة، بمعنى أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية أن تمنح نفسها اختصاصات إضافية في الطعون الانتخابية غير مسندة إلى مجلس الأمة في الأساس في نص المادة (95) من الدستور التي منحت مجلس الأمة الاختصاص الأصيل بالفصل في الطعون الانتخابية، فاختصاص المحكمة في الطعون الانتخابية منبثق من اختصاص مجلس الأمة، وبالتالي فإن سلطتها محددة بنص دستوري لا تملك إهداره.
وفي تقديري الشخصي أيضا فإن المحكمة الدستورية، في حكمها الأخير، أخطأت حين خرجت عن المبادئ التي استقرت عليها في أحكامها الصادرة في الطعون الانتخابية، وخلطت بين المنازعات الانتخابية والمنازعات بدستورية التشريعات، فجاء حكمها فاقدا لأي اتصال بالقانون أو الدستور مستهدفا بلوغ نتيجة محددة بلا أسباب تقوى على حملها فجاء ضعيفا في الإسناد القانوني مرتكزا بالكامل على ما ورد في صحيفة الطعن ومتبنيا لأسبابها ومرددا لها بلا إضافة مميزة من المحكمة ناكرا ما استقر عليه رأيها في شأن حدود ونطاق اختصاصها في نظر الطعون الانتخابية.
وبمطالعة أسباب الحكم الأخير نجد أن المحكمة منحت نفسها الاختصاص في مراقبة وفحص الإجراءات الممهدة للانتخابات بما في ذلك الأمر الأميري الصادر بتعيين رئيس مجلس الوزراء ثم المرسوم الأميري الصادر بحل مجلس الأمة ثم المرسوم الأميري الصادر بالدعوة للانتخاب، فابتعدت بذلك عن حدود “العملية الانتخابية” ومدت نطاق اختصاصها إلى مناطق لا تمت للعملية الانتخابية بصلة.
وفي سبيل تبرير مسلكها، اعتبرت المحكمة الدستورية في حكمها المعيب المرسوم الأميري الصادر بحل مجلس الأمة بمثابة “إجراء ممهد” للانتخابات وفرضت رقابتها عليه، وهذا استنتاج لا يقبله المنطق العام ولا يتماشى مع الدستور، وقد كان في مقدور المحكمة الدستورية أن تتوسع قليلا في مفهوم “العملية الانتخابية” بأن تراقب وتفحص المرسوم الأميري الصادر بالدعوة إلى الانتخاب باعتباره إجراء ممهدا للانتخابات، لكن أن تمد المحكمة سلطانها إلى مراقبة المرسوم الأميري الصادر بحل مجلس الأمة، فذلك توسع غير محمود إطلاقا، فالمرسوم الصادر بحل مجلس الأمة لا يمكن أن يكون جزء من “العملية الانتخابية” ولا هو إجراء ممهد لها، وليس صحيحا البتة ما قررته المحكمة في هذا الشأن.
إن المادة (107) من الدستور تنص على أنه “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”.
ومن مطالعة هذا النص نجد أنه ينظم أكثر من مسألة: فمن جهة هو ينظم حل مجلس الأمة، ومن جهة ثانية ينظم آثار حل مجلس الأمة، ومن جهة ثالثة ينظم حالة عدم إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في الميعاد الدستوري، بما مفاده أن المرسوم الأميري الذي يصدر بحل مجلس الأمة قد لا تستتبعه حتما الدعوة لانتخاب المجلس الجديد، لذلك قرر المشرع الدستوري عودة المجلس المنحل فور انقضاء الميعاد الدستوري، وهو ما مؤداه أنه لا يجوز اعتبار حل مجلس الأمة من قبيل الإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية.
من جانب آخر، فإن حل مجلس الأمة هو إجراء ينهي حياة المجلس القائم من دون ثمة ارتباط من أي نوع كان بالعملية الانتخابية للمجلس الجديد، وإذا ما أصابه أي عوار أو خلل، فإن الطعن عليه أمام القضاء، إذا كان ذلك جائزا، لا يكون من خلال طعن انتخابي، بل من خلال دعوى أخرى أمام المحكمة المختصة، فليس من المقبول أن ينفتح الباب أمام الطعن على المرسوم الأميري الصادر بحل مجلس الأمة وفق النصوص والإجراءات والمواعيد المنظمة لتقديم الطعون الانتخابية، ذلك أن فتح هذا الباب بهذه الطريقة مؤداه بلوغ حالة الفوضى التي حذرت منها المحكمة الدستورية ذاتها في العديد من أحكامها وهي تقرر ضوابط الطعون الانتخابية.
ولبيان ما نقصد نقول أن الانتخابات التي تجرى في أعقاب حل مجلس الأمة تتم خلال أجل دستوري هو شهرين من تاريخ حل المجلس، والطعون الانتخابية تقدم خلال خمسة عشر يوما عقب إعلان نتائج الانتخابات، فإذا أضفنا إلى ذلك المدة التي يستغرقها الفصل في الطعن الانتخابي، وهي نحو أربعة أشهر أو أكثر، فإن هذا يعني أن المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة لن يستقر إلا بعد صدور أحكام المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية، أي بعد نحو ستة اشهر على الأقل من صدوره، وبالطبع فإن هذا مدعاة للفوضى واستدراج للاضطراب السياسي والقانوني، وهما فوضى واضطراب لا حاجة بي إلى إثباتهما من فرط وضوحهما.
إن المقارنة بين موقف المحكمة الدستورية في تحديد نطاق اختصاصها وهي تنظر في الطعون الانتخابية في العام 2008 وموقفها في الحكم الأخير، تكشف لنا أن المحكمة قفزت قفزة كبيرة ومفاجئة وغير مبررة قانونا، ففي حين أنها رفضت الطعن الذي تأسس على بطلان إجراءات الترشيح معتبرة هذه الإجراءات تسبق العملية الانتخابية وبالتالي لا تخضع لرقابة المحكمة على الرغم من أن الترشيح وإجراءاته هي أقرب ما تكون للعملية الانتخابية، في حين نراها في الطعن الأخير تذهب بعيدا جدا وتقبل الطعن رغم تأسيسه على بطلان المرسوم الأميري الصادر بحل مجلس الأمة على الرغم من عدم وجود صلة بين هذا المرسوم وبين العملية الانتخابية من تصويت وفرز وإعلان نتيجة.
إن قيام المحكمة الدستورية بهذه القفزة القانونية لم يحصل على ما يكفي من تبرير في الحكم الأخير، وقد كان حريا بالمحكمة أن تفطن إلى أنها بخروجها عن مسارها المعتاد كانت في حاجة ماسة إلى تبرير قانوني مقنع يشيع الإطمئنان والسكينة في عقول وقلوب المواطنين، كما كان على المحكمة أن تقر في الحكم وتعلن أنها تعدل عما استقرت عليه من مبادئ منذ تأسيسها لا أن تتعامل مع هذا العدول وذلك الخروج كما لو كان مسألة اعتيادية متاحة لها متى شاءت فتعدل من دون تقديم أسباب مقنعة تشيع من خلالها االطمـأنينة التي يحتاجها الرأي العام في القضايا ذات البعد السياسي والقانوني كقضية الحل القضائي للبرلمان.
لقد كان من الواجب على المحكمة الدستورية أن تنتبه إلى أن اختصاصها بالفصل في الطعون الانتخابية هو اختصاص منقول إليها من مجلس الأمة، وبالتالي فإنها لا تملك، بصدد هذه الطعون، سلطة تتفوق على سلطة صاحب الاختصاص الأصيل وهو مجلس الأمة.
ومن جانب آخر، فإذا افترضنا جدلا صحة ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية في تعاملها مع الطعون الانتخابية، فإن اللافت للنظر أن المحكمة ذاتها غفلت عن فحص “الإجراءات الممهدة” لانتخاب مجلس 2009 الذي قررت إعادته إلى الحياة، فبعد الانتخابات التي أجريت في العام 2009، نظرت المحكمة طعنا انتخابيا انتهت إلى رفضه على الرغم من بطلان الانتخابات، وفيما يلي بيان ذلك تفصيلا:
بتاريخ 16/3/2009 صدر أمر أميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء إثر كتاب الاستقالة الذي رفعه رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح إلى صاحب السمو أمير البلاد في التاريخ ذاته. وقد نص الأمر الأميري على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء مع استمرار كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزراة الجديدة.
إلا أنه وبتاريخ 18/3/2009 صدر، بناء على طلب مجلس الوزراء، مرسوم أميري برقم 85 لسنة 2009 بحل مجلس الأمة، أي أن مرسوم حل المجلس صدر بناء على طلب (الوزارة) المستقيلة في مرحلة تم تكليف كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء “بتصريف العاجل من شؤون منصبه”، وبالطبع فإن تقديم طلب حل مجلس الأمة لا يدخل ضمن نطاق “العاجل من الشؤون”، فضلا عن ذلك فإن الأمر الأميري الصادر بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء يتضمن تكليف كل منهم بتصريف العاجل من شؤون (منصبه)، أي أن صفة (الوزارة) قد انتفت عنهم كهيئة بصدور الأمر الأميري.
وبالعودة إلى حكم المحكمة الدستورية الأخير نجد أن المحكمة قررت إبطال انتخابات 2012 لأن طلب الحل جاء من (وزارة) مستقيلة، إذ قررت المحكمة:
“ويلزم في طلب الحل أن يكون من حكومة (وزارة) لم تبرحها هذه الصفة، سواء إثر خلاف بينها وبين مجلس الأمة، أو إذا اختل التناسب والانسجام بينهما، أو اقتضت له ضرورة، وأنه وإن كان الدستور لم يقيد استعمال الحكومة لحق الحل بأي قيد زمني، فلها أن تتخير توقيته وتقدير مناسباته، إلا أن الدستور أحاط الحل- نظرا لخطورته- ببعض القيود والضمانات.. وإذ كان الأمر كذلك، وكان الحاصل أن هذا الحل قد جاء استنادا إلى المادة (107) من الدستور، وبناء على طلب وزارة قد زايلتها هذه الصفة بقبول الأمير استقالتها بكاملها…”.
وإذا ذهبنا مذهب المحكمة الدستورية الأخير، فإن انتخاب مجلس الأمة عام 2009 قد تم بناء على مرسوم باطل بحل مجلس الأمة المنتخب في العام 2008 لأنه مبني “على طلب وزارة قد زايلتها هذه الصفة بقبول الأمير استقالتها بكاملها”. ومع ذلك فإن المحكمة الدستورية لم تفحص إجراءات حل مجلس الأمة عام 2009 في الطعن الذي نظرته آنذاك.
الخلاصة
إن الاختصاص بالفصل في الطعون الانتخابية هو اختصاص أسنده الدستور إلى مجلس الأمة وفق المادة (95) التي أجازت نقل هذا الاختصاص إلى “جهة قضائية”. وفي العام 1973 تم نقل هذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية، وبالتالي فإن اختصاص هذه المحكمة في نظر الطعون الانتخابية لا يمكن أن يتجاوز اختصاص الجهة الأصيلة وهي مجلس الأمة، ومن ثم فإن نطاق الطعون الانتخابية لا يتعدى “العملية الانتخابية” التي تتكون من تصويت وفرز وإعلان نتيجة، وليس للمحكمة الدستورية أن تتوسع في مفهوم “العملية الانتخابية” وأن تبسط رقابتها على المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة أو مرسوم الدعوة للانتخابات ضمن نطاق الطعن الانتخابي.
ثالثا: مدى اختصاص المحكمة الدستورية في نظر الأعمال السياسية
قررت المحكمة الدستورية في حكمها محل هذه الدراسة أن “القيود الإجرائية التي فرضها الدستور على السلطة التنفيذية لا يجوز إسقاطها أو تجاوزها أو التحلل منها تذرعا بأنها أعمال سياسية، إذ أن هذا القول لا يستقيم في مجال إعمال سلطتها المقيدة طبقا للدستور”.
كما قررت: “ليس من المقبول أن يسمح النظام الدستوري بالرقابة القضائية على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، توصلا إلى الحكم بعدم دستورية التشريعات المخالفة للدستور، سواء صدرت هذه التشريعات من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية، وأن يعهد بهذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية وهي جهة قضائية نص عليها الدستور في صلبه، كافلا بها للشرعية الدستورية أسسها، مقيما منها مرجعا نهائيا لتفسير أحكام الدستور، ورقيبة على الالتزام بقواعده، إعلاء لنصوص الدستور وحفظا لكيانه، في حين تستعصي بعض الإجراءات الممهدة لعملية الانتخاب والصادر بشأنها قرارات من السلطة التنفيذية على الفحص والتدقيق من قبل هذه المحكمة لدى مباشرة اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية، للاستيثاق من اتفاق أو تعارض هذه الإجراءات مع الدستور، وإلا جاز التذرع بوجود مناطق من الدستور لا يجوز لهذه المحكمة أن تمد بصرها إليها، فتغدو هذه القرارات- وهي أدنى مرتبة من القانون- أكثر قوة وامتيازا من القانون نفسه”.
ومن الواضح أن المحكمة الدستورية فرقت بين “العمل السياسي” الذي يحظر عليها نظر ملاءماته وبواعثه، وبين إجراءات “العمل السياسي”، وهي ما قررت إخضاعه لرقابتها.
وفي تقديري الشخصي، فإننا إذا جردنا الرأي السابق للمحكمة الدستورية عن مناسبته، وهي الطعن الانتخابي، فإن ما ذهبت إليه المحكمة جدير بالإشادة، وهو يعد قاعدة قضائية جديدة أرستها المحكمة من شأنها توسيع نطاق الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية بما في ذلك تلك الأعمال التي تكتسي طابع “الأعمال السياسية”. صحيح أن المحكمة تداركت الأمر وأعلنت أنها لا تبحث في الملاءمات ولا تتغلغل في بواعث إصدار المراسيم الأميرية ولا تتدخل في الولاية المنفردة للسلطة التنفيذية، إلا أن هذا القدر من الرقابة القضائية على “إجراءات” “الأعمال السياسية” يعد في حد ذاته فتحا لآفق جديد. فحين تفحص المحكمة الدستورية إجراءات إصدار “العمل سياسي”، فإن هذا مكسب قانوني ولا ريب، لاسيما أن المحكمة قررت أنه لا توجد مناطق من الدستور لا يجوز للمحكمة أن تمد بصرها إليها، والمأمول حقيقة هو أن تستقر المحكمة على هذا الرأي ولا تعدل عنه في مناسبات قادمة، والمأمول أيضا أن يسير القضاء العادي مسير المحكمة الدستورية، في حدود ولايته واختصاصه، بفحص إجراءات إصدار “الأعمال السياسية” مستقبلا.
وعلى الرغم من ذلك، وبالعودة إلى حكم المحكمة الدستورية الأخير، نجد أن المحكمة خلطت على نحو غير مقبول بين اختصاصها بمراقبة دستورية التشريعات واختصاصها بالفصل في الطعون الانتخابية، وتناست أن اختصاصها بالفصل في الطعون الانتخابية هو اختصاص منقول إليها من مجلس الأمة كما أوضحنا من قبل، فذهبت المحكمة إلى القول أنه “ليس من المقبول أن يسمح النظام الدستوري بالرقابة القضائية على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، توصلا للحكم بعدم دستورية التشريعات المخالفة للدستور، سواء صدرت هذه التشريعات من السلطة التشريعية او من السلطة التنفيذية، وأن يعهد بهذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية وهي جهة قضائية نص عليها الدستور في صلبه، كافلا بها للشرعية الدستورية أسسها، مقيما منها مرجعا نهائيا لتفسير أحكام الدستور، ورقيبة على الالتزام بقواعده، إعلاء لنصوص الدستور وحفظا لكيانه، في حين تستعصي بعض الإجراءات الممهدة لعملية الانتخاب والصادر بشأنها قرارات من السلطة التنفيذية على الفحص والتدقيق من قبل هذه المحكمة لدى مباشرة اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية للاستيثاق من اتفاق أو تعارض هذه الإجراءات مع الدستور، وإلا جاز التذرع بوجود مناطق من الدستور لا يجوز لهذه المحكمة أن تمد بصرها إليها، فتغدو هذه القرارات- وهي أدنى مرتبة من القانون- أكثر قوة وامتيازا من القانون نفسه..”.
إن اختصاص المحكمة الدستورية بالفصل في الطعون الانتخابية يختلف تماما وينفصل عن اختصاصها بمراقبة دستورية التشريعات، وهي لا تفصل في الطعون الانتخابية بوصفها “محكمة دستورية” وإنما بوصفها “محكمة موضوع”، وبالتالي ليس من شأن اختصاصها في مسائل أخرى أن يمنحها “هيمنة سياسية” أو “يد عليا” أو “سلطة تشريع” على نحو يجعل النصوص الدستورية ومبادئ النظام العام تنحني أمامها إجلالا أو خضوعا بلا ضابط من قانون أو دستور. إن المحكمة الدستورية ليست إلا محكمة نشأت بقانون.. والقانون وحده منحها اختصاصات محددة مقيدة، ولو تم الأخذ بهذا الفكر الذي تؤمن به المحكمة من قبل مجلس الأمة أو مجلس الوزراء لبلغت البلاد حالة مرعبة من تصادم السلطات، فإذا كانت المحكمة الدستورية تذهب هذا المذهب، فماذا يمكن أن يقول أعضاء مجلس الأمة، وهم الذين بقراراتهم تصدر القوانين وتلغى ومن بينها قانون المحكمة الدستورية ذاتها!
على أية حال، إن الاتجاه الجديد للمحكمة الدستورية من شأنه أن يسقط الاتجاه السائد في القضاء الكويتي والذي يمنح “الأعمال السياسية” حصانة كاملة تجعلها عصية على الرقابة القضائية. ويمثل هذا الاتجاه الأحكام الصادرة من محكمة التمييز، والتي استقر رأيها على عدم خضوع “الأعمال السياسية” لرقابة القضاء ولا يكون للقضاء “أي اختصاص بالنظر فيها”.
فقد قررت محكمة التمييز في العديد من أحكامها أنه ” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم 33 لسنة 1992 المعدل على منعالمحاكم من نظرها، فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة وحينئذ لا يكون للقضاء أي اختصاص بالنظر فيه، وأنه وإن كان يتعذر وضع تحديد جامع مانع لهذه الأعمال أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه المحافظة على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج وذلك دون تعقيب من القضاء أو بسط رقابته عليها”.
كما قررت أنه “ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية، فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة، فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه صلاحا للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها فيه”.
كما قررت “المقصود بأعمال السيادة هي تلك التي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو للذود عن سيادتها في الخارج”.
وفي حكم آخر قررت محكمة التمييز أن أعمال السيادة التي لا يختص القضاء بنظرها “هي تلك الأعمال التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية أو تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الدولة في الداخل أو الذود عن سياستها في الخارج ومن ثم يغلب فيها أن تكون تدابير تتخذ في النطاق الداخلي أو في النطاق الخارجي إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية أو الخارجية في حالتي الهدوء والسلام وإما لدفع الأذى والشر عن الدولة في الداخل أو الخارج في حالتي الاضطراب أو الحرب وهذه وتلك إنما هي أعمال وتدابير تصدر عن سلطة الحكم لا عن سلطة الإدارة، والضابط فيها معيار موضوعي يرجع إلى طبيعة الأعمال في ذاتها لا إلى ما يحيط بها من تدابير”.
وفي حكم آخر، قررت المحكمة أن “صدور العفو عن العقوبة من أمير البلاد، أيا كان مقدار المعفو عنه، قبل أن يفصل في الطعن بالتمييز عن الحكم الصادر بها يخرج الأمر من يد القضاء، ذلك أن العفو عن العقوبة في معنى المادة 75 من الدستور والمادة 239 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية هو عمل من أعمال السيادة لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه فيما صدر العفو عنه، بما لا تملك معه محكمة التمييز المضي في نظر الطعن، ومن ثم يتعين القضاء بعد جواز نظر الطعن”.
ومن المقارنة بين ما انتهت إليه المحكمة الدستورية في حكمها الأخير وما استقرت عليه محكمة التمييز في أحكامها، يتضح لنا بجلاء أن المحكمة الدستورية منحت القضاء الاختصاص بفحص إجراءات “الأعمال السياسية”، وهو ما يتناقض مع ما قررته محكمة التمييز من أنه ليس للقضاء أي اختصاص فيما يتعلق “بالأعمال السياسية”.
أما عن رأي المحكمة الدستورية ذاتها في “الأعمال السياسية” قبل حكمها الأخير، فهو يتطابق مع الرأي الذي تتبناه محكمة التمييز، بل أن المحكمة الدستورية زادت المسألة توضيحا، إذ قررت في أحد أحكامها أن أعمال السيادة “يجمعها إطار عام هي أنها تصدر عن الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة في الداخل والخارج، مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة، ويندرج ضمن أعمال السيادة المنظمة لعلاقة الحكومة بالسلطة التشريعية، ومنها استعمال السلطة التنفيذية لحقوقها المتعلقة بالتشريع، كاقتراح القوانين، كما تدخل فيها المسائل السياسية التي تعد المجال الحيوي والطبيعي لنظرية أعمال السيادة..”. وأضافت المحكمة “وإذا كانت الرقابة على دستورية القوانين واللوائح تجد أساسا لها- كأصل عام في مبدأ الشرعية وسيادة القانون وخضوع الدولة لأحكامه إلا أنه يستثنى من هذا الأصل- وفقا لما جرى عليه القضاء الدستوري- أعمال السيادة، ومنها الأعمال السياسية، فتخرج من مجال هذه الرقابة، ولو بغير نص يقضي بذلك، إذ أن هذه قاعدة مستقرة في النظم القضائية في الدول المتحضرة، وغدت أصلا من الأصول القضائية الثابتة، تأسيسا على أن طبيعة هذه الأعمال تأبى أن تكون محلا لدعوى قضائية تحقيقا للاعتبارات السياسية واستجابة لدواعي الحفاظ على كيان الدولة”.
وبصدور الحكم الأخير من المحكمة الدستورية أصبح متاحا أمام القضاء العادي التعقيب على “الأعمال السياسية” من جهة مدى سلامة الإجراءات التي اتبعت في إصدارها، وهو ما يخالف نص المادة (2) من قانون تنظيم القضاء الذي يقرر أنه “ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة”، وتعليقا على هذا النص قررت المذكرة الإيضاحية للقانون أنه “وتؤكد المادة-2- خروج أعمال السيادة عن ولاية القضاء عموما لاتصالها بسيادة الدولة، وهو مبدأ استقر في الفقه والقضاء منذ أمد بعيد، ومن ثم فليس للقضاء أن ينظر طلبا يمس أعمال السيادة سواء قصد به إلغاء العمل أو تفسيره أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه”.
الخاتمة
“ولا يسوغ أن تهدر إرادة الناخبين التي كشف عنها إعلان النتيجة لمجرد مخالفة إجرائية اقتضتها ضرورة ملجئة تقدر بقدرها أو فرضها واجب يتعين الالتزام به تغليبا له، ولا يسوغ إهدار تلك الإرادة لمجرد عدم استيفاء شكليات مفروضة غير مؤثرة على نتيجة الانتخاب..”.
هذا ما قررته المحكمة الدستورية في العام 2003، وهو ما عدلت عنه في العام 2012. ولم يكن عدول المحكمة الدستورية في شأن أثر المخالفات الإجرائية هو العدول الوحيد عن المبادئ التي استقرت عليها قبل إصدار حكمها الأخير بإبطال انتخاب مجلس 2012، بل عدلت المحكمة كذلك عن التحديد الذي تبنته لنطاق المنازعة الانتخابية في جميع الأحكام الصادرة في الطعون الانتخابية منذ تأسيس المحكمة، إذ أنها كانت تقرر أن اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية مقيد في حدود العملية الانتخابية، وأن العملية الانتخابية تتكون من مراحل ثلاث هي التصويت والفرز وإعلان النتيجة، وأنها بالتالي لا تبسط رقابتها على الإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بما في ذلك القرارات المتصلة بالترشيح، وهو المدخل الرئيسي لعملية الانتخاب، إذ أنها لا تعتبره جزء من تلك العملية وبالتالي فليس لها أن تبسط رقابتها على ما يتصل بإجراءات الترشيح حتى لو كانت باطلة.
كما أن المحكمة عدلت عن رأيها المستقر في شأن مفهوم “أعمال السيادة” ومنها “الأعمال السياسية” التي كانت ترى أنها لا تخضع لرقابة القضاء إطلاقا.
إن عدول المحكمة الدستورية المفاجئ في حكمها الأخير عن معظم المبادئ المستقرة التي كانت تتبناها والتي كانت تحكم رقابتها على العملية الانتخابية ليس له ثمة تبرير، بل أن المحكمة ذاتها لم تكلف نفسها عناء بيان هذا العدول، ولم تهتم بإيراد أسبابه، وهو الأمر الذي من شأنه أن يهدر ضمانة استقرار القضاء الدستوري على رأيه ويزعزع الثقة بالمبادئ القضائية التي أصبحت وفق الحكم الأخير بلا قيمة أدبية، فحين تعدل المحكمة الدستورية عن معظم المبادئ المستقرة المنظمة للطعون الانتخابية دفعة واحدة في حكم واحد، فإن هذا ما يستدرج القلق، إذ من غير المقبول إطلاقا أن تتخلى المحكمة الدستورية عن تراثها القضائي الذي كونته على مدى زمني يقارب أربعة عقود من دون تبرير قانوني أو حتى تسبيب مقنع لهذا العدول الشامل الذي جعل حكم المحكمة الأخير منبت الصلة عن جميع أحكام المحكمة التي صدرت في الطعون الانتخابية، وفيه مخالفات دستورية وقانونية لا تقوى أسبابه على نفيها أو تبريرها. ويخلو تماما من رأي فقهي يسند ما انتهت إليه المحكمة فضلا عن انعدامه لصدوره من محكمة مشكلة تشكيلا باطلا.
تم بحمد الله وفضله،
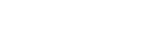




















أضف تعليق