عندما تُنزع من مسلم رحمته
بقلم: خلود عبدالله الخميس
نشأ في قرية فردا من عائلة كبيرة، لأبيه زوجتان، وهو ابن الأولى، والثالث ترتيبا بين الأبناء، سبقه الى الدنيا أخ وأخت شقيقان، ودونه أربعة أشقاء وغير أشقاء.
عبدالهادي، وينادونه «هادي» شاب في العقد الثاني لم يخرج من قريته أبدا، ولا يعلم أن هناك جغرافيا غير تلك المحيطة في مكان بلدته، مخارجها ومداخلها، وبعض القرى المحيطة التي يزورها لضرورة ملحّة، وقلّ ما تكون هناك ضرورات، لأنه قليلا ما يُعتمد عليه في الضرورات، لم يكن «هادي» من الأبناء المعوَّل عليهم بين أبناء الحاج «منعم» الذي يكلف الابن البكر بالحاجات المهمة للأسرة الكبيرة وفيها يعيش جده المسنّ لأبيه ويدخل من مسؤوليات الأب بِرا ومن باب التقاليد المعروفة في القرية.
فنشأ «هادي» على أنه غير مرئي وغير مهم وغير منتظر منه إلا الطاعة المطلقة بِرا، وكان أبوه قاسيا بكل معاني القسوة المستغربة في سكان المناطق الخضراء الرائقة، والمتوقعة من «أجلاف الصحراء» ولكن المعادلة مع «الحاج منعم» معكوسة لحدّ الألم والخطر.
لم تكن العائلة الكبيرة فقيرة أو غنية جدا، بل كانت «مستورة» كما يطلقون على من هم على حالهم، تقتات وتسترزق من الأرض والسماء والهواء، من هبات الرحمن عليها، ولم يعرف «الحاج منعم» كيف يكون رحيما أبدا، لم يعتبر أن من شكر الرحمن على ما أنعم به على عائلته أن يرحم عياله، ويتصف بالشفقة والرأفة على أدنى ما يمكنه، ليحفظ لابنه دينه، فماذا حل بـ «هادي» بسبب «فقر الرحمة» عند أبيه؟
تنصّر «هادي»، نعم، ترك الإسلام، غادر القرية، عبر خط النار الأخضر الفاصل بين قريته والعالم الجديد، ترك كل الظلم والضرب المبرح لأقل غلطة غير مقصودة، الحبس الانفرادي في «زريبة» البهائم، شح الطعام عقابا، كان الحرمان هو الأصل والاستثناء هو النوم فوق مرتبة داخل البيت.
ليس «هادي» فقط هو الذي عومل بتلك الطريقة، بل كل إخوته يعاملون بالسوء ذاته، من أب حجّ ويصلي في جامع القرية الفروض الخمسة ويصوم ويُخرج زكاة الزروع والثمار ويعرف من الإسلام كل الأحكام، ولكنه فقد بوصلة الرحمة، فقدَ أصل الشريعة وروحها، ظن أن الدين ليس إلا واجبات وحقوق، وغفل أنه منهج متكامل للحياة، هناك فصام ما عند «الحاج منعم» أخرج أحد أبنائه من الإسلام، وسيُسأل، والله أعلم: بأي ذنب خرج «هادي» عن دينه؟
هذه قصة شاب كان مسلما يعيش في إحدى قرى تونس، قصها علي بنفسه في مقهى مغمور بمنطقة «سانت روبيه» الفرنسية، يقص وهو سعيد أنه تنصّر حيث الرحمة والعدل والمساواة، ونسي أنه يعامل كذلك لأن فرنسا دولة علمانية وهو نصراني من دينهم وبذلك استحق تلك المعاملة، بينما تضطهد المسلمين ولا تؤمن بحقهم في اللباس الشرعي الإسلامي، وكثير من الكلام المنطقي لم يرغب في سماعه بسبب ماضيه مع أبيه.
التفاصيل ذات دموع، ولكنني اختصرتها جدا جدا، بمقال ليقف كل رب عائلة يستخدم الدين ليأخذ حقوقه ولا يؤدي واجبات العائلة عليه، كان يطالبهم بالبر ولم يبرهم، نعم، لم يكونوا جوعى أو عراة ولديهم المسكن، ولكنهم بلا سكن ولا رحمة ولا مودة فأني يعيش إنسان في عائلة وهو فاقد لأهم القيم الأسرية؟
تونس الخضراء عجزت الحياة الكاملة التي تدب فيها عبر اخضرارها على رتق قلب هذا الشاب، لا عجب فقد عجزت قبل ذلك عن زرع الرحمة في قلب أبيه.
توقفت كثيرا عند تلك الحكاية، عندما كنت في أحد قرى تونس قبل أعوام، وأذكر سعادتي ما أن وطأتها قدماي، تنفست بعمق، وكررت التنفس إلى ما لا نهاية، وكأن هنا منبع الهواء والنقاء والهناء، استنشقت كل ما اقترب مني، رائحة التراب الطيني، عبق لا ينسى، عرق أجساد الفلاحين، وأسميته ماء الكرامة، فكم من لا ماء لوجهه وجسده يحفظان كرامته، روائح عوادم السيارات الصغيرة التي يركب فيها عدد فوق طاقتها من البشر بكل الأحجام، القرى «الخضراء» نظنها «نحن أبناء الصحراء» جنة الله في الأرض، ونجهل مجاهلها وجاهليتها، وهنا نفقد الصورة الحقيقية لوجهها كاملا، كما لنا وجوه لا يرونها هم أيضا.
عندما ركبت السيارة مغادرة القرية، التفتُّ خلفي لعل بصيص أمل ينطبع في ذاكرتي الأخيرة عن المكان، إنه اللون الأخضر، فقط لا غير، هو كل عتاد هذه القرية ومن حولها، لتتحول قلوبهم إلى أسطح ندية تنشأ فوقها قطرات الرحمة، الرحمة هي فقط يمكنها نزع العادات والأعراف المخالفة للدين، المرتدية ما تردى من التقاليد وأكل وشرب عليه أغوال الطرق الوعرة وقطاع الأمل، الرحمة، تلك الصفة العظيمة المخلوقة في فطرة البشر والحيوان، وحتى الشجر الذي لا يملك عقلا يسلك مسلكا عاطفيا بالتقارب من بعضه بعضا ليشعر بالاطمئنان.
أقول لأولئك البشر منزوعي الرحمة، الأمر لا يتطلب سوى وقفة وتفكّر بآية واحدة في القرآن الكريم «بسم الله الرحمن الرحيم»، هذه لا أكثر.
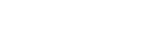



















أضف تعليق