جلس مستمتعا في صالون بيته في رام الله، كان يداعب أحد أحفاده وقد غمرته سعادة لا توصف، كانت الفرحة في عينيه أكبر من هذه الشقة في إحدى العمارات الجديدة على إحدى تلال هذه المدينة بالضفة الغربية. لم يكن مضى وقتها على عودته من الولايات المتحدة سوى سنوات قليلة، التقيته بعد أن سبق أن تعرفت عليه في عدد من اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنفى) التي عقدت في الجزائر نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات.
البروفيسور إبراهيم أبو اللغد كان قد غادر يافا مسقط رأسه إلى الولايات المتحدة بعد النكبة عام 1948 وهو لم يبلغ بعد العشرين من عمره. عاش هناك معظم حياته وحمل الجنسية الأمريكية. عمل أستاذا للعلوم السياسية بالجامعات الأمريكية فحاز مكانة مميزة وسط النخبة الأمريكية الأكاديمية والسياسية وربطته صداقة خاصة بابن بلده المهاجر مثله المفكر الكبير إدوارد سعيد.
حين التقى عام 1990 صحبة ادوارد سعيد بوزير الخارجية الأمريكي جورج شولتز، شكل ذلك حدثا كبيرا فكلاهما عضو آنذاك في المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنفى) في وقت لم تكن فيه واشنطن تعترف بمنظمة التحرير أو تشرع معها في تلك المحادثات الأولية في تونس مع السفير الأمريكي هناك روبرت بيلترو. وبعد 44 عاما من الإقامة في الولايات المتحدة قرر أبو اللغد العودة إلى رام الله والاستقرار فيها حتى وفاته عام 2001 وقد عرف بمعارضته لاتفاقية أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير وإسرائيل مما دفعه وقتها للاستقالة من المجلس الوطني مع ادوارد سعيد أيضا.
سألته وقتها في مقابلة تلفزيونية عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية فقال مبتسما: تابعت هذا الحدث الهام لعدة عقود. كنا في كل مرة نقول كعرب بأن هذا المرشح أفضل من ذاك وبأن مؤشرات ما تفيد بأن المرشح الفلاني سيبدي من التفهم أو من التصلب في قضايانا هذا الشيء أو ذاك. وفي النهاية نكتشف مدى سوء تقديرنا لترسي الأمور في النهاية على نوع من الثبات في السياسة الأمريكية تجاه قضايانا مهما كان ساكن البيت الأبيض!!.
في عز أيام التفاؤل العارم بوصول باراك أوباما إلى سدة الرئاسة قبل ثماني سنوات، كان هناك شخص آخر لعب، في مقابلة تلفزيونية امتدت لساعة كاملة، دور منغص اللذات. إنه الكاتب الكبير الراحل محمد حسنين هيكل. كانت كل الآراء وقتها منتشية بوصول هذا الشاب من أصول إفريقية إلى رئاسة أكبر قوة في العالم. التقيت به في القاهرة وعرضت عليه وقتها كل ما قيل عما ينتظره العرب من رجل اعتبر قريبا إلى درجة لا بأس بها من قضاياهم ومتفهما لها بشكل مغر أحيانا، كما بدا لاحقا من خطابه في جامعة القاهرة في حزيران/يونيو 2009. ظل الرجل متشبثا بحذره الشديد وبقناعة مفادها شيء واحد: لا تنتظروا شيئا من هذا الرجل فالسياسة الأمريكية أعقد بكثير من أن يتحكم في إدارة دفتها أي شخص بمفرده، وعلى مزاجه، فهذا أمر لا يحصل إلا في الدول المتخلفة وأمريكا ليست من بينها بالتأكيد.
مرة أخرى يجد العرب أنفسهم مع موعد انتخابي أمريكي على نفس الإيقاع الذي ساد لعقود طويلة، مرشح كريه ومرشحة وإن لم تكن محبوبة لكنها بالتأكيد أفضل منه. دونالد ترامب يبدو شخصا عنصريا وطاردا ونتوقع منه كل ما هو غير ودي تجاه الأجانب والمسلمين بشكل خاص أما هيلاري كلينتون فهي وإن لم تبد ودا خاصا تجاه أي من قضايا العرب الكبرى إلا أنها في المقابل لم يصدر منها ما ينفر أو يثير امتعاضا أو توجسا كبيرا.
في النهاية، لن يسمح النظام السياسي الأمريكي لترامب أن يفعل ما يريد وكذلك هيلاري كلينتون. طبعا هذا لا يعني أن الرؤساء في أمريكا لا قيمة لهم ولا صلاحيات، ولكنهم شاؤوا أم أبوا هم محكومون بضوابط محددة تسطر خطوطها العريضة الاستراتيجيات الكبرى والعليا التي تضعها للبلاد قواه السياسية والعسكرية والاقتصادية النافذة. هذا ليس معناه كذلك أن هناك «عصابة خفية» تحكم البلاد ولكنه يعني أن المصالح العليا للقوة الأعظم في العالم تسطرها آليات محددة وعلى مدى عقود ولا يمكن أن تترك لهوى أي شخص أو ميولاته يقودها كما يشاء، هو يصبغها بنكهة ما ليس أكثر.
الرئيس الأمريكي ليس واجهة أو كومبارسا بالتأكيد ولكنه ليس الحاكم بأمره. أنظروا فقط للشيب الذي غزا شعر أوباما القصير حتى ندرك أن الرجل ربما وجد وضعا لم يكن يتوقعه أو كانت لديه طموحات ونوايا حسنة أكبر من أن يتيحها له عمليا هذا المنصب… «لكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ».
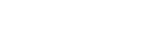




















أضف تعليق