مع بدء عام دراسي جديد، وتجدد الآمال في أطفال يتعلمون ليعيدوا بناء سوريا التي هدمتها الحرب، يعيش نحو نصف مليون لاجىء سوري في لبنان في ظل تناقص للدعم الدولي، وعجز في خزائن وزارة التعليم اللبنانية.
وقدّرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين السوريين في لبنان عام 2016 بمليون و100 ألف لاجىء نصفهم أطفال.
و سبق أن أشارت منظمة هيومن رايتس واتش في تقرير لها إلى أن ربع مليون طفل لبناني ممن هم في سن التعليم (3-18 سنة) خارج المدارس، في حين يتلقى 155 ألف طفل سوري فقط دراستهم في المدارس الرسمية، و87 ألفًا آخرين يتعلمون في مدارس خاصة.
وفي داخل مخيم الرحمة في محافظة البقاع شرق لبنان، تمنت الطفلة آلاء كتكوت “أن تستطيع استكمال دراستها لحين تكبر وتصبح مهندسة لتعيد إعمار بلدها سوريا الذي تهدم بفعل الحرب”.
وقال محمد المصري مدير القطاع التعليمي لمراكز “مابس” التعليمية في لبنان في حديث للأناضول : “المؤسسات والهيئات الخاصة تحاول تجاوز العقبات التي تحول دون تعليم اللاجئين السوريين، كبعد المسافات الجغرافية، وارتفاع تكاليف التعليم، وانشار ثقافة عمالة الأطفال في ظل الحاجة والفاقة المجتمعية، وذلك من خلال تقديم التعليم المجاني وإقامة مدارس في المخيمات، وتأمين المواصلات لقاطني المناطق البعيدة، لكنه أكد في المقابل أن جهود المؤسسات التعليمية الخاصة ليست كافية أبدًا لاستيعاب جميع الطلاب”.
وأضاف المصري: “نحن نركز حاليًا على توسيع نشاطاتنا التعليمية في محافظة البقاع الأكبر كثافة بالأطفال السوريين في عمر التعليم بما نسبته 54% وذلك لكونها محافظة حدودية لسوريا، لكننا ليومنا هذا لم نستوعب في مراكزنا التعليمية سوى 3 آلاف طالب على امتداد المحافظة بأقسامها الثلاثة الشمالية والوسطى والغربية”. و تابع: “المراكز التعليمية غير الرسمية لا تستطيع سد الحاجات كلها إلا في حال تم اعتماد آلية عمل مشتركة بين المؤسسات الحكومية اللبنانية والهيئات الخاصة التي تعنى بملف التعليم والتدريب للطلاب السوريين”.
وأشار المسؤول التعليمي إلى محاولة دمج الطلاب السوريين بالبلد الذي يعيشون فيه “من خلال الاعتماد على المناهج اللبنانية في العملية التعليمية وتحضيرهم بعد ذلك للامتحانات الرسمية اللبنانية، التي لم يترشح لها في العام السابق سوى 200 طالب سوري على صعيد لبنان”، قائلًا: “لكننا شرعنا أيضًا بمحاولة دمج الأساتذة السوريين باللبنانين من خلال إشراكهم في ورش عمل مشتركة تمتد لعام ونصف للتباحث في قضايا مهمة لكلا الطرفين”.
وأرجعت المعلمة السورية سماح منعم أسباب التسرب المدرسي في العمر بين 12 و18 سنة إلى “عمالة الأطفال المبكرة بسبب صعوبة العيش، وانتشار ثقافة الزواج المبكر، إضافة الى عدم وجود القدرة الاستيعابية الكافية لتغطية تعليمهم”، واعتبرت أن ضعف الأساس اللغوي( الفرنسي ، الانجليزي) “يشكل عائقاً فعليًا ولهذا كانت الخطوة بتعريب المناهج اللبنانية لبعض الصفوف”.و أشارت إلى أن “الحاجة الحقيقية تكمن في التأهيل المهني لهذه الفئة العمرية للمساهمة في حل معضلة الجهل التعليمي الأكاديمي وتزويدهم بالخبرات المهنية الضرورية التي تساعدهم على تأمين المستوى الحياتي الكريم”.
من جانبها، أضافت المشرفة التربوية مريم العبد “أن تعليم الطوارىء الذي يُعتمد عليه في تعليم اللاجئين داخل المخيمات والأماكن السكنية الصعبة هو أفضل بديل ممكن عن “اللا تعليم” الذي يهدد مستقبل الطفل السوري اللاجىء ليس في لبنان فقط بل في أي بلد يلجأ إليه”.كما عبّر والد الطفلة يمنى دعاء الخطيب، عن أمله في استمرار الدعم الذي تتلقاه طفلته من مواليد 2009 واعتبر أنه “لولا مجانية التعليم الذي تلقته في المدرسة التي وُجدت داخل المخيم لما استطاعت ابنته أن تتعلم كتابة اسمها كونها دخلت سن التعليم وهي في بلد اللجوء”. وأضاف: “نحن نؤمن بالتعليم وبأهميته لكن المشكلة في عدم القدرة على إلحاق أبناءنا فوق سن 15عامًا في المدارس اللبنانية الخاصة لكلفتها العالية، ولا في المدارس الرسمية نظرًا لعدم وجود مقاعد لكل الراغبين في التعلم”.
وفي بادرة لدعم التعليم الخاص للأطفال في لبنان، أطلق مجموعة من النشطاء السوريين حملة “بيكار” والتي تسعى لتأمين المزيد من الدعم الدولي لضمان استمرار تقديم الخدمات التعليمية للعام الدراسي 2016-2017.
منسق الحملة في لبنان هاشم زيادة أكد للأناضول أن “الحملة عالمية وليست محلية وقد لاقت صدى لدى بعض النشطاء الدوليين”، متمنياً رواجها وتحقيق أهدافها لضمان تأمين حق التعليم لربع مليون طفل سوري يتواجدون خارج المؤسسات التعليمية في لبنان على المدى البعيد، وتأمين نفقات تعليم الطلاب المسجلين لهذا العام الدراسي للحيلولة دون العجز الممكن”. و أبدى زيادة، تخوفه من عدم القدرة على تحقيق استمرارية المؤسسات التعليمية الخاصة المعنية بشؤون تعليم الأطفال السوريين في لبنان بسبب تراجع دعم بعض الجهات المانحة الدولية عن تقديم المساعدات المالية الكافية، بجانب غياب التنسيق المدروس مع الجهات الرسمية.
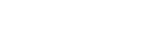




















أضف تعليق