ومنزلي حيثما ألقي مفاتيحي
محمد الثبيتي
أظن أن الحديث عن الأيديولوجيا في حضرة الشعر حديث مرتبط بتلك القوة القادرة على خلق حالة شعرية متكاملة لا تنطفئ إلا على بياض يغري بالكتابة، هذا البياض الذي هو المنفى الأول والأخير للكلمات .
ثمة تجاذب شعري خلاق بين قطبين أساسيَّين يمتدان بامتداد تاريخ الشِعر العربي ، بين القلق ( بصفته إله الشِعر ) وما ينتج عن هذا القلق من أسئلة مفتوحة على مصراعيها ومن آفاق متعددة ومن رياح تنطلق في كل الاتجاهات ، وبين الأيديولوجيا بصفتها ( الإيمان المتعالي على كل شيء ) وما يتبعها من نظرة أحادية مركزة ويقين ضارب في أعماق النفس البشرية واطمئنان لا يتزعزع .
( الشعر إدراك دون إثبات، وكأنه إدراك متزلزل)
هكذا يوصف الشعر، بمعنى أن القلق الوجودي هو المنبع الأول للقصيدة وبلا مُنازع، وهو أمر يتفق عليه الكثيرون، فالقصيدة هي فضاء مفتوح وأفق مشرَع للأسئلة المتعددة ، ومتى ما أغلقنا هذه الآفاق بالإجابات نكون قد قتلنا القصيدة .
حينما أتحدث عن القلق فأنا أتحدث عن تلبّس الشاعر بالطبيعة، ذلك التلبّس الذي يجعل منهما – الشاعر والطبيعة – ( كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى )، ذلك التلبس الذي يجعل الشاعر محموماً بالإنسانية جمعاء، قَلِقًا على عناصر الطبيعة وردةً وردةً ، شجرةً شجرةً ، فراشةً فراشةً ، ليصبح الشاعر نبيًا ساهرًا على راحة هذا العالم خائفاً على مستقبله .
هذا التلبس النبوي يذكّرني بالآية الكريمة حيث يقول الله تعالى مخاطباً نبيه (ص): ( ليغفِرَ لكَ اللهُ ما تقدّمَ مِن ذنبِكَ وما تأخّر..) حيث يقول بعض المفسرين إن المقصود بكلمة ( ذنبكَ ) هنا ليس ذنب النبي (ص) ولكن ذنب أمّته ، فمقام النبوة يحتّم على النبي أن يكون ( متلبّساً ) بأمته بحيث تصبح حسناتُهم حسناته وذنبهم ذنـبه.
ولكننا إذا آمنا بأن هذا القلق الكوني هو البؤرة التي تتسرب من خلالها جميع الكائنات الشعرية إلى الحياة، فإننا نقف هنا أمام ظاهرة أخرى لا يمكن التغافل عنها ، وهو التيار الآخر القائم على مركزية الرؤية ، التيار الذي لا يرى في ( اليقين ) مفردة دخيلة على عالم الشعر بحيث يجب أن تُهشَّم على أعتاب القصائد، وهنا تبرز ( الأيديولوجيا ) كمفردة قيادية في هذا التيار ، الأيديولوجيا التي تشاغب القلق وتخرج على ألوهته الشعرية منذ القدم، وهي أشبه ما تكون بجبل منتصب في مهب الريح .
هذا التيار الثاني يظهر بأبرز تجلياته فيما نسمّيه اليوم بـِ ( أدب المقاومة )، حيث إن تراكم الحروب والصراعات العربية الإسرائيلية حوّل كلمة المقاومة إلى أيديولوجيا يعتنقها الكثيرون ويدافعون عنها، ولعل المتتبع لشعر المقاومة يجد فيه هذا الكمّ الهائل من الإيمان واليقينيات والأحادية في الرؤية التي أصبحت ملمحاً هامّاً من ملامحه بحيث لا يمكن لشاعر المقاومة إلا أن يرى في الآخر ذلك العدو الذي يجب عليه أن يواجهه بقوة وإيمان راسخين .
أيضاً لابد لنا من الإشارة إلى أمر آخر في معرض حديثنا عن الأيديولوجيا والشعر، وهو تلك النقلة الواضحة في شعر حسان بن ثابت بعد اعتناقه الإسلام ، وهي نقلة طالما أثارت حفيظة النقاد وفجّرت أسئلتهم..
حسان بن ثابت من الشعراء المخضرمين، كان قد عاشَ في الجاهلية بقدر ما عاش في الإسلام، ستّين سنة في كل فترة، ليكتمل عمره فيما يقارب 120 سنة، امتدح لبرهة ملوك الغساسنة والملك النعمان، وكان لا يتحرّج من شعر اللهو والغزل، وبعد اعتناقهِ للإسلام أصبح شعره منصباً في الدفاع عن الدعوة الإسلامية والذود عن حياضها وتمجيد ومدح النبي (ص) حتى أصبح ( شاعر النبي ) .
وقد نشأ الجدل الواسع بين النقاد المعاصرين حول شعر حسان بن ثابت بلحاظ ذلك التحول الواضح في شعره بين المرحلتين ( الجاهلية والإسلام )، فقد بدى واضحاً للمتتبّع أن ثمّة خُفوتاً ما طرأ على شعره في العصر الإسلامي، بمعنى أن تلك الجزالة اللفظية والسبك الرصين للأبيات وذلك الإشراق في الديباجة الذي كان جليّاً في شعره ( الجاهلي ) قد تضاءل بشكل ملحوظ بعد الإسلام ، وعوضاً عن ذلك لوحِظَ تصاعد النبرة العاطفية في شعره ، فصِدقُ الإحساس هو أمر ملموس بشكل واضح في قصائده التي قالها في مدح النبي (ص) .
البعض من الباحثين المعاصرين يقول بأن حسان بن ثابت قد نُسبَ إليه الكثير من الشعر الذي لم يقله، هذا في محاولةٍ منهم لتبرير ذلك الضعف الطارئ على شعره بعد الإسلام، وسواء صحّت هذه الدعوى أم لم تصح فإننا نبقى أمام ظاهرة لا يمكن التغاضي عنها بسهولة، لا سيما ونحن نجد في التاريخ ما يدل على أن خفوت شعرية حسان بن ثابت كان أمراً ملحوظًاً مِن قِبل الناس في تلك الفترة..
يُروى أن أحدهم قال لحسان بن ثابت: ” لانَ شِعرُك في الإسلام يا أبا الحسام ”
فردّ عليه حسان قائلاً : ” إن الإسلام يحجز عن الكذب، وإن الشعر يزينه الكذب “
((الكذب))
هكذا سماه حسّان..
وهكذا سمّتهُ العرب حين قالت: ( أعذبُ الشِعر أكذبه )
ولكنني ( أنا محمد المبهر ) ما زلت أصر على أن الأمة بأجمعها وقعت في ( خطأ مطبعي ) آنذاك، أزعم أنهم أرادوا أن يقولوا : أعذب الشعر أقلقُه ، أو ربما أكفره ، أو حتى أفجره .. ( هذا ما أزعم أنهم أرادوا أن يقولوه وليس ما أقولهُ أنا ).
أظن أن خفوت شعرية حسان بعد الإسلام يستدعينا إلى قراءة ما يُسمّى اليوم ( بالأدب الإسلامي )، فإذا كانت الحقبة الزمنية الفاصلة بيننا وبين حسان بن ثابت قد مدّت بيننا ضباباً يحول دون وضوح الرؤية، فإن الأدب الإسلامي اليوم هو الوليد الشرعي لتلك الحقبة الإسلامية الأولى.
الأدب الإسلامي ( بصفة عامة ) هو أدب قائم على ( رسالة واضحة )، هذه الرسالة قد تشمل جميع جوانب الحياة، فهي أحيانًا تكون اجتماعية وأحيانًا عقائدية وأحيانًا تربوية تهذيبية، بمعنى أنه أدب مكرّس للدفاع عن العقيدة / الأيديولوجيا بكامل أبعادها الحياتية، ولعل ذاك التوجّه ( الإرشادي ) أو ( النصحي ) الذي يبدو جليّا في الأدب الإسلامي هو ما جعل النقاد يرددون بأن الأدب الإسلامي لا يلامس جوهر الشعر، باعتبار أن الأدب الإسلامي الموجود بين أيدينا اليوم هو أدب قائمٌ في غالبيتهِ ( إلا ما رحم ربي ) على الخطابيـــة والمباشــرة التي لا تتلاءم مع الــشعــر.
يظهر لنا من بعد هذا أن الأيديولوجيا هي مفردة مشاغبة في معجم الشعر، وأن إقصائها عن الفضاء الشعري بدعوى أنها تنسف روح الشعر الملتبسة والغامضة هو إقصاء غير منطقي، فبالرغم من أن الشعر أقرب إلى روح القلق والأسئلة المفتوحة على الآفاق المتعددة، وبالرغم من أن الكثير من الشعراء الذين كتبوا شعراً مستمداً من أيديولوجيا ما قد فشلوا في ملامسة جوهر الشعر، إلا أن هذا لا ينفي أن هذا التيار القائم على الأيديولوجيا وكل ما يتبعها من يقينيات قد أضاف الكثير من الجمال إلى مشهد الشعر العربي بمشاغبته لحالة القلق الشعري، ولعل الكثير من الشعراء كانوا نقطة التقاء بين هذين التيّارَين لتتولّد فيهم فوضى شعرية من اليقين والشك والقلق والاطمئنان والألم والأمل ووو..
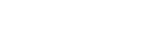














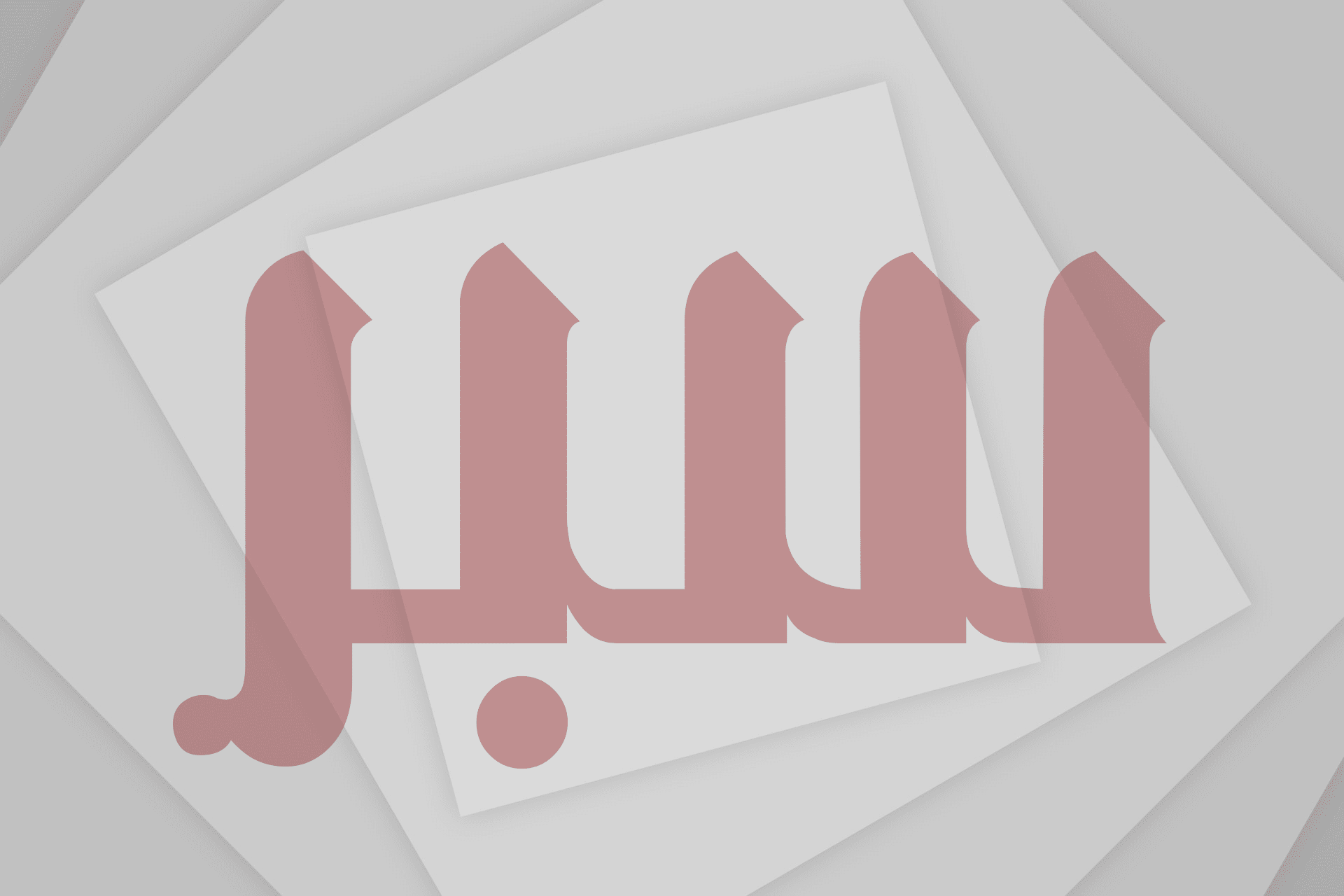



أضف تعليق